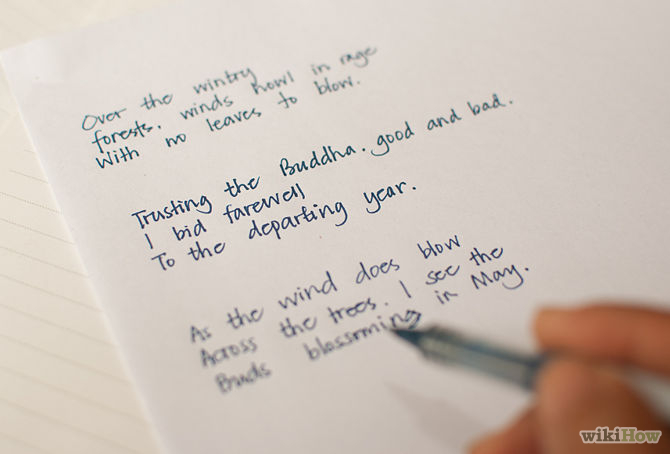وصلنا قفصة فجرا. كنّا نعبر وادي بيّاش لمّا أعلنت زينب أنّها قد حسمت أمرها وتخلّت نهائيا عن فكرة زيارة أهلها لتواصل الرحلة معنا حتى تحظر مؤتمر تمغزة ومن ثمّة تتحوّل إلى أمّ العرائس لحضور حفل التوقيع. غمزني مصطفى في المرآة العاكسة بعينه الحولاء وهو يشاكسها بمكر: "أعتقد أنّ هذا من مفعول الرواية. ولكنّك ستكتشفين تمغزة أخرى لا علاقة لها بالقرية التي يتحدّث عنها هذا الحالم في روايته."
اكتفينا من قفصة بأكواب قهوة ساخنة اقتنيناها من مقهى على الطريق. في مدينة المتلوّي، كانت محطّة الحافلات مزدحمة بالمسافرين. تمهّل مصطفــى في قيادة السيارة ريثما نتجاوز المحطة وزحمتها. عرفته حالما رأيته وهو يسدّ علينا طريقنا مستطلعا قدوم الحافلة من قفصة. كان يمسك صبيا من يده، سار به بعد ذلك نحو بائع السندويتشات. صحيح أنّني لم أره منذ اكثر من ثلاثين سنة، ولكنّ نبرة صوته وهو يكلّم ابنه أيقظت صورته في ذاكرتي كما لو كان بجانبي في قاعة المراجعة بمعهد قفصة. ودون إرادة منّي وجدت نفسي أناديه "الرّومي، الرّومي" لكنّ الرّجل واصل سيره دون التفات. قرّرت أن أنتظر عودته وأنا أتساءل إن كان من اللائق أن أناديه بتلك الكنية التي عرف بها في صغره... ترى ما الذي فعلته بك السنين يا منير يا عشيري؟ ها أنت منحني الظهر، مترهّلا تضع نظّارة طبّية سميكة. أين شعرك الناعم الذي كان وراء تلقيبك بالرومي؟ ربّما يزعجه أن أناديه بتلك الكنية أمام ابنه. وربّما كانت زوجته موجودة في المحطّة. ترى هل تزوّج ريم قريبته التي طلب مني الابتعاد عنها لمّا توجّس أن تكون مهتمة بي؟ لازلت أذكر نظراتها كلّما زارت بيتنا مع أختي التي كانت زميلة لها في مركز الصناعات التقليدية. لم تكن نظرات حب بل كان فيها توسّل صامت وإلحاح في طلب المساعدة. كانت نظراتها تربكني وتبعث لديّ إحساسا بالشفقة عليها.
أعلنت حافلة قفصة عن وصولها بذلك المنبّه الصادي الطويل. هاج جمع المسافرين المنتظرين بمحطّة المتلوي، ونطّ البكّوش من داخل مكتب رئيس المحطّة مدوّيا بصفّارته المزعجة يصول ويجول بحركات يفهم منها دعوته المسافرين إلى عدم التزاحم. في تلك اللّحظة. هرولت نحو منير أستعجله مخافة أن يتخلّف عن الحافلة. ودون سلام ولا تسليم أمسكته من كتفه قائلا له بلهجة جريدية في مزيج من المشاكسة واللّوم "يا راجل، أكثر من ثلاثين سنى ما نحّتلكش الرّخفة والحلّة؟ مازلت لتوّة تضيّع في الكار؟" لكنّ الرّجل الذي لم يكلّف نفسه مجرّد الالتفات نحوي صاح "هبّط إيدك خير ما نكسرهالك" أجبته ضاحكا "اللّه اللّه على الرّومي، ولّيت تكسر اليدين ...؟" ودون أن يمهلني لأعرّفه بنفسي، رأيته يستدير ناحيتي وينزل على جبيني بضربة دماغ كست وجهي دما وأفقدتني وعيي. لمّا فتحت عينيّ، وجدت عثمان البويحيي الذي اعتدى عليّ يعتذر منّي على سوء التّفاهم ويشرح لي أنّه ليس منير الرّومي الذي اعتقدته.
أكملت بقية الرّحلة معصوب الجبين. ومصطفى لا يكف عن السّخرية ممّا حلّ بي، بينما كان فتحي عامر وزينب يهتزّان في مكانيهما كاتمين الضحك في صدريهما حتى تفضحهما الدموع والكحّة. لمّا تجاوزت السيارة سلسلة من المنعرجات والمنخفضات، صارت الطريق خطا مستقيما يكشف عن بعد فوهات مصفاة الفسفاط التي يتصاعد منها الغبار الأبدي. شغّل مصطفى جهاز الموسيقى على صوت الراحل أحمد الخليفي فصدحت القصبة ولعلع صوته الصافي في الهضاب المحيطة. طلبت منه أن يوقف مكيّف السيّارة ويفتح النوافذ لأعبّ من لفحات الشهيلي التي اشتقتها حتى غامت الرؤية في عيني.
على تخوم القرية، أخذت أجيل البصر عساي ألمح تلك المقبرة التي كم سمعت عنها دون أن أراها. "جبانة وادي الجمل" لَكَمْ استفـــزّ اسمها فضولي وخيالي، ولو أنّني كنت أفضل أن أنطقه على صيغة الجمع "جبّانة وادي الجمال"؟... كنت موزّعا بين تفسير نسجه خيال الطفل المجنّح فيّ وبين تفسير رواه بائع متجوّل كان يعرض بضاعته على أبواب المنازل ويطيل الوقوف مع النسوة. صوّر لي خيالي أنّ تسمية "وادي الجمال" تعود إلى كونه أودى ذات فيضان بقافلة كاملة من الإبل، تماما كما أودى الوادي الغربي بسبع عرائس ليلة زفافهنّ فسمّيت القرية أمّ العرائس؟ ارتحت لفكرة أنّ الدّفن بوادي الجمال يعني أنّ الميّت كان كالجمل في قدرته على التحمّل والصبر، وأنّ نومته الأبدية في حضن الوادي تعويض له على الحرمان والعطش اللذين عانى منهما في حياته... أمّا ذلك البائع المتجوّل الذي كان يطيل الحديث مع النساء أمام بيوتهن، فقد سمعته يقول لإحداهنّ أنّ الوادي سمّي كذلك لأنّ القوافل القادمة من فريانة محمّلة بالتين الشوكي والقمح والشعير كانت تنيخ جمالها هناك عند وصولها حيث يبيت الرجال في ذلك المكان ذي الرمال الناعمة والهواء العليل تحت قبّة السماء المرصّعة بالنجوم، يتسامرون حول النار. لمّا كبرت، صرت أبحث عن هذا الوادي كلمّا سافرت دون أن أجد له أثرا...
للقرية مقبرة ثانية تقع على الحدود الغربية للقرية، عند سفح ربوة نما فيها أقدم أحياء القرية، حي شعبي ساحر. بعض أنهجه يكاد لا يتّسع لمرور شخصين، وبعض بيوته أشبه بمغاور مطماطة القديمة، حياة أصحابها مستباحة ومكشوفة للعابرين. تتخلّل أزقّته جداول الصرف الصحي كعروق خضراء بارزة من تحت جلد عجوز طاعنة... ومع ذلك، توجد في هذا الحي مظاهر من حب الحياة لا توجد في أي مكان آخر من القرية. الفنانون الشعبيون وراقصات اللجنة الثقافية ونجوم الكرة في الفريق المحلي من هناك والأئمة والمؤذنون وفرق الإنشاد الصوفي والدراويش من هناك والمومسات والفتوّات وباعة الخمر خلسة من هناك والنقابيون والمعارضون السياسيون والشيوعيون من هناك والشعراء وأوّل المهاجرين إلى أوروبا من هناك. ولكن في المقابل لا وجود في ذلك الحي لمظاهر الدولة باستثناء مدرسة موروثة من زمن الاستعمار الفرنسي. لا مركز بريد ولا محطة نقل ولا بلدية ولا مستشفى ولا مركز أمن ولا أي علامة تدل على اهتمام الدولة بالناس... شيء آخر يميّز ذلك الحي هو اختلاط أهله. مزيج عجيب من الطرابلسية والدزيرية والمراركة والتوانسة. حي مليء بالحياة، لم يمنع الفقر والأوساخ أهله من الإقبال على الحياة ومباهجها. يتخذ الناس من كل حدث مهما كان بسيطا ذريعة لإقامة الأفراح والولائم والزيارات. هذا عائد من الحجّ، وتلك حديثة الوضع، وهذه نجح ابنها في الابتدائية، والأخرى أنهى ابنها الخدمة العسكرية. ضحك وسمر وشبق ولعب وبخور وحلقات إنشاد على الدوام...
على التخوم الخلفية للحي يرمي الناس في منحدر الربوة فضلاتهم من القمامة والمخلفات القصديرية والبلاستيكية وجيف الحيوانات التي تتكدّس بين تلك الجداول الخضراء المائلة إلى السواد حيث يجري البول والخراء، والذباب الأزرق العملاق الثقيل يحوم في المكان.... هناك في الأسفل تقع مقبرة القرية الرئيسية، عند السفح بجانبها بطاح اتخذ منها الأولاد ملاعب لكرة القدم. ومن الناحية الثانية للمقبرة يقع جبل تتناثر فوقه بكثافة حجارة صوانية سوداء، كلّما رأيتها استحضرت صورة الطير الأبابيل التي ترمي أصحاب الفيل بحجارة من سجيل. كلّما حضرت دفن شخص في ذلك المكان القميء، يتملّكني الخوف من مصيري الذي ينتظرني هناك، خصوصا لمّا يصادف أن أمرّ بجانب قبر متهدّم يكشف عن بقايا عظام أو جمجمة. يصيبني حزن عميق لكوني سأصير يوما ما جيفة مهملة كجيف الكلاب المرمية على تخوم تلك المقبرة. وأدعو الله أن أدفن مع موتى البدو في مقبرة وادي الجمل...
توجد في القرية مقبرة ثالثة، نسمّيها "جبّانة النصارى" وتقع هي الأخرى على سفح ربوة لا تفصلها عن الكنيسة سوى بضع مئات من الأمتار. لهذه المقبرة سور عال لا يسمح برؤية ما بداخلها. تعوّدت المرور بجانبها كلّما ذهبت إلى بيت عمّي، حتى حدّثني كمال ذات يوم عن أشياء ثمينة يمكن الحصول عليها من قبور النصارى. قال لي كمال، أكثر أطفال حينا شقاوة ونزقا، أنّه تسوّر الجدار الخلفي للجبّانة وقفز داخلها فعثر على أشياء عجيبة وساحرة. أخبرني أنّ النصارى يدفنون موتاهم واقفين ويحيطون قبورهم بالأعشاب والورود ويحلّونها بسلاسل من الخرز والحلي الفاخر ويغلفونها بالرّخام الأملس. أيقنت أنّ ذلك الشقي قد زرع في دماغي لوثة فضول ستنتهي بغوايتي مهما أجّلت الأمر. واتّخذت من خوفي أن أعجز على تسلق الجدار من الداخل للخروج من الجبانة حجة مقنعة لعدم خوض المغامرة. لكنّه ظلّ يزنّ على دماغي كلّما التقينا وزاد أن أهداني بعض خرزات ملوّنة قال أنّه جمعها من تلك العقود التي تزيّن القبور الرخامية. لمّا عبّـــر يوسف عن رغبته هو الآخر في خوض التجربة لم يبق أمامي مجال للمراوغة. كنت سأصير أضحوكة أترابي في الحي. قفزت من فوق الجدار معهم وشاهدت بأمّ عيني كيف أنّ كلّ ما قاله كمال كان صحيحا. نهبنا من الجبانة كلّ ما طالته أيادينا. وتعدّدت بعد ذلك زياراتنا إلى مقبرة النصارى التي وجدنا فيها ملاذا آمنا نمارس فيه شقاوات المراهقة... في تلك السنوات لم يبق في القرية إلا نفر قليل من مهندسي شركة الفسفاط وكان عددهم يتناقص بسرعة لافتة حتى لم يبق منهم أحد في ظرف سنوات معدودة.
شغلتني الدراسة الثانوية خارج القرية عن مقابرها. حتى صحوت على اختفاء مقبرة النصارى. نبت حواليها حي جديد. هل سوّتها الجرافات بالأرض؟ هل نقل النصارى رفات أمواتهم إلى فرنسا؟ شيء ما بطعم الفجيعة المتبقية من ذكرى مقبرة النصارى يؤكّد لي أنّ المقابر هي نوع من المتاحف. لماذا أهمل النصارى مقبرتهم وصاروا مثل المسلمين لا يهتمّون بموتاهم؟ هل انتبه مسلمو قريتي إلى ضرورة العناية بمقبرتهم والكف عن اعتبارها امتدادا للمزبلة وعن معاملة موتاهم كجيف الكلاب؟ أين تقع مقبرة وادي الجمل؟ أسئلة ظلّت مركونة في الذاكرة. وهاهي تستيقظ الآن لتطرق الخاطر بإلحاح وأنا أدخل القرية بعد غيبة أربعين سنة.
لاحظت أنّ اللافتة التي تعلن اسم القرية وترحّب بزائريها موجّهة إلى السماء. ولم يفتني أنّ نزق أطفال هذا الجيل صار أقلّ بذاءة وأقرب إلى التفلسف المرّ والعبثية.
كنت في حاجة إلى أن أرتق شظايا الذاكرة وأرتّب للقلب مخدات وثيرة قبل أن يدخل في انفلات الخفقان. استجاب مصطفى فوريا لمّا طلبت منه رفع زجاج النوافذ والقيام بجولة قبل إنزالي في بيت مجدة. وضعت نظارات سوداء وألصقت وجهي بزجاج النافذة. احترم جميع من في السيارة لحظتي وساد صمت خلت فيه نفسي أشاهد شريطا صامتا بالأبيض والأسود.
مع الزّمـــن، تتغيّر كلّ الأشياء دون أن ينتبه من يعيشون اللحظة إلى ذلك. فهم راكبون على حبل الزمن يتغيّرون في غمرة ما يتغيّر. يشيخون ويهرمون ويفقدون أسنانهم ويسمنون ويتزوّجون ويخلّفون ويطلّقون ويدفنون موتاهم ويتعوّدون على فراقهم. كلّ ذلك دون أن ينتبهوا إلى ما تخلّفه تلك الأحداث من عميق التغيّرات. وحده من غاب سنوات عديدة يستطيع أن يلمس تلك التغيرات منذ الوهلة الأولـــى التي يصل فيها إلى القرية.
أين صفصافة المدرسة؟ كيف تقلّصت بطحاء السوق ولفّها السكون إلى هذا الحد؟ كيف تهاوى صفّ الدكاكين القديمة ذات المزاريب الطويلة والأبواب الخشبية المتشابهة ذات المراتيج الحديدية الضخمة؟ هجر الناس دكاكين السوق القديمة فغابت عنها تلك الحركة الدّؤوبة وأصوات الباعة وعمليات البيع والشراء. ظهرت دكاكين جديدة وكثيرة متناثرة في الأحياء. في كلّ منزل فتح باب جانبي مخصّص لدكّان تجاري يبيع كلّ شيء ولا شيء. شيئان لم يتغيّـــرا رغم السنين. مساجد القرية وربوتها. مساجد بيضاء توحي قبابها المستديرة بالطمأنينة وصومعاتها الخفيضة بالقناعة. أمّا الرّبوة، حيث يرقــد سيدي الطائر، فتلّة عارية إلاّ من بعض شجيرات شوكية موزّعة هنا وهناك. ربوة حجرية كالحة تدبّ فيها العقارب الشاهرة ذيولها المقوّسة كالسيوف. ربـــوة تلتحف السماء في صمت منذ الأزل وتبدو للحمقى زائدة عن الحاجة، كانت دائما ملاذا للصعاليك والمجانين والمنبوذين والشواذ. يقال أنّ الثوّار كانوا ينزلون منها لجمع المؤونة وتأديب مخبري فرنسا. ربوة تسند ظهر القرية كمخـــدّة وتصدّ عنها لفحات الشهيلي. ربوة يرصّعها مقام سيدي الطائر، تلك الزاوية التي تدير ظهرها للقرية حيث تشرف من الجهة الخلفية على منخفض حاد تكسوه الواحات الجبلية استوطنه أولاد سيدي العريان ممّن رفضوا الاستقرار بالقرية والعمل بالمنجم بعد اكتشاف الفسفاط في بداية القرن الماضي.
الفسفاط هو الذي جاء بالروامة إلى هذا البرّ القاسي وجعلهم يرضون بالإقامة في هذه الناحية الجرداء من الجبل. لا شكّ أنّ هذا الذي أقنعهم بالعيش في هذا الخلاء المأهول بالعقارب والأفاعي له من القيمة ما لا يخطر على بال أصحاب هذه الأرض. ولكن أيّ قيمة هذه؟ أسئلة ظلّت تنمو في الأجيال اللاحقة من أولاد سيدي الطائر. لم يكن الروامة في البداية سوى بضعة أنفار جلبوا معهم آلات حفر وبيوتا خشبية مجرورة على عجلات. كانوا يلبسون سراويل قصيرة ويضعون قبعات عريضة على رؤوسهم. لم تمرّ سنة حتّى نبتت كأعشاب برّية على بعد أميال من سفح الجبل حيث يحفر الوادي مجراه، عشر بيوت أوروبية الطراز من ذات الأسطح القرمودية المائلة إلى جهتين...
لم يضع الروامة وقتهم في إقناع بدو المنطقة بالعمل في الداموس وراحوا يجلبون العمالة من سائر أنحاء البلاد ومن خارجها، حتى تكوّنت هذه المدن المنجمية التي فتحنا فيها عيوننا. فسيفساء من الجهات والقبائل والأوطان والأعراق. لم نتساءل يوما عن صلة القرابة الدموية بيننا. فقد امتزج دم آبائنا تحت الداموس وروى عرقهم تراب الفسفاط وعجنه
ما من كائن إلاّ ويخلد إلى الرّاحة في وقت ما من اليوم. تنام الكائنات أو تسترخي وتكفّ عن الحركة حتى تسترجع أنفاسها وتجدّد طاقتها. تلك سنّة الحياة وناموسها. ولكنّ نهش لحم الجبل واستخراج الفسفاط منه لا يتوقّف في قريتنا. يسير العمل بنظام التناوب بين ثلاث دوريات تدوم الواحدة منها ثماني ساعات، طوال أيام الأسبوع دون توقف. وتقدّم الشركة للعمّال حوافز مغرية تجعلهم يقبلون العمل حتى أيام الأعياد الدينية والرّسمية، بل ويتنازلون عن إجازاتهم السنوية فيعملون للحصول على راتب مضاعف.
تفرغ القاطرات تلك الصخور التي تخرجها من جوف الجبل على بساط مطاطي متحرّك يتولّى نقلها إلى المغسلة على بعد بضع كيلومترات. وهناك تطحنها آلات عملاقة وترمي بها في أحواض مائية عملاقة مجهّزة بغرابيل تفصل الفسفاط عن الغبار الدقيق الذي يعلق بالماء ويخرج عبر الغرابيل. وفي مرحلة أخيرة يقع تجفيف الفسفاط النقي حتى يصير مسحوقا ناعما أخضر يميل إلى السواد وله رائحة مميّزة لا تخطئها أنوف من تعوّدوها.
على أيامنا لم تكن معالجة الفسفاط تتم على هذا النحو، فقد كانت عربات القطار السلحفاتي هي التي تنقل الفسفاط إلى مطحنة جافة تكسر الصخور وتشغّل مراوح عملاقة تدور بقوة لتطرد الغبار عبر أنابيب عمودية فينتشر كالسحب الكثيفة في السماء قبل أن تنقله الريح ويتساقط على المنازل والأشجار. أمّا الفسفاط فيفرش في مساحات شاسعة ويرش بالماء ثمّ تمرّ عليه آلات ميكانيكية تقوم بنبشه وتحريكه حتى ينفصل التراب عن الفسفاط ويترك أياما معرّضا لأشعة الشمس حتى يجف.
كنّا نحن الأطفال مهووسين بأسئلة عديدة عن الفسفاط لا نجد لها إجابات مقنعة من طرف الكبار. كنّا نعرف عن النفط واستخداماته وقيمته الاقتصادية ولا نعرف شيئا عن الفسفاط. أذكر كيف اضطرّت أزمة البترول سنة 1973 الأوروبيين إلى استخدام الخيول والدراجات الهوائية كوسائل نقل من جديد وكيف عادوا إلى التدفئة باستخدام مدافئ الحطب، وكيف شلّت طائراتهم ومصانعهم. كنّا على يقين أنّ الفسفاط ثروة اقتصادية هامّة، وإلاّ ما كانت الدّولة لتخصّص له كلّ تلك القاطرات والشاحنات والمعدّات الميكانيكية الضخمة ولتخاطر بإرسال آلاف العمال إلى أعماق الأرض فتبتلع البعض منهم بين الفينة والأخرى. ولكن هل له نفس قيمة البترول؟ ما هي استخداماته؟ لماذا لم يجعل منّا دولة غنية مثل جارتنا ليبيا؟ لماذا انقطع عمّي عن العمل بالمنجم وهاجر إلى ليبيا للعمل في شركات التنقيب عن النفط في صحراء ليبيا؟ لا أحد من الكبار كان بإمكانه تقديم إجابات شافية لأسئلتنا. كانت أمّي في البداية تجتهد في إقناعي بأنّ الفسفاط يصلح لاستخراج مكوّنات تستخدم في سكّ العملات المعدنية وأنّ جميع العملات في العالم أصلها من الفسفاط. ولكنّها بعد سنين طوّرت نظريتها وصارت تقول لنا أنّ الفسفاط يستخدم لصناعة أنواع كثيرة من الأدوية. أمّا أبي فكان يقول أنّ الفسفاط يستخدم في صناعة ذخيرة الأسلحة المتطوّرة. أنقذت هذه الأجوبة لفترة والديّ من محاصرتي لهما بالأسئلة المزعجة. ولكنّ اقتناعي بها كان يتراجع كلّما كبرت في السنّ. وهكذا عادت أسئلتي لتنشط في دماغي من جديد وتلحّ عليّ في الإجابة عليها بنفسي، حتّى صرت مهووسا بها أحملها معي أينما ذهبت.
صيف الجنوب الصحراوي شديد الحرارة والجفاف. يعاني الناس طوال اليوم من لفح الشهيلي الذي يصهد جباههم وييبّس شفاههم حتى تتشقق ويسيل منها الدم. يلزمون بيوتهم إلى غاية الغروب حيث يخرجون لرش الأرضيات والجدران بالماء فتتبخّر كأواني شائطة. بعد العاشرة ليلا يهب نسيم يلطّف الجو ويلين به المناخ. عندها فقط تنبسط أسارير الناس ويخرجون بكبيرهم وصغيرهم للسّمر. تجتمع النسوة فوق السطوح فيما يتمدّد الرجال عند أكداس الرمل على حافة الشارع الرئيسي للحي. يجلب كلّ واحد ما تيسّر من أكل أو شرب. بطيخ مثلّج وشاي وفول سوداني محمّص. وتنطلق الألسن بأصوات خفيضة فيجري الحديث عفويا من موضوع إلى آخر في سمر هادئ ومنساب على خيط الوقت تحت تلك القبة السوداء المتلألأة بالنجوم
تعودت الجلوس على سياج الجامع تحت فانوس التنوير العمومي في الجانب الآخر من الشارع العام. أجلب معي مجلّة أو كتابا وكأس شاي منعنع وبعض سجائر. أنهمك في القراءة تؤنسني أصوات الرجال التي تصلني كالهمس تقطعها أحيانا ضحكة نسائية قادمة من السطوح... يرهقني الضوء الهزيل لعمود التنوير العمومي ويمنعني من الاستمرار في القراءة فتستيقظ أسئلتي حول الفسفاط واستخداماته.
في تلك الليلة كنت في مكاني المعتاد منهمكا في القراءة، أمرر بين الحين والآخر كفّي على وجهي لأمسح ذرّات الفسفاط المتساقطة من الهواء وأشخر كبغل لتسريح منخريّ من الغبار المتسلل إليهما، لمّا لفتت انتباهي كتلة هلامية بيضاء تتحرّك في عمق الشارع ناحية السوق تحت عمود التنوير العمومي. هل كانت قطعة قماش يحرّكها النسيم؟ ما سرّ اقترابها باتجاهي منتقلة من عمود إلى آخر؟ تكبر كلّما اقتربت أكثر، دون أن تتوقّـــف عن الاهتـــــزاز. هل هي دوّامة هوائية صغيرة تتحرّك مقتربة؟ ربّما... حاولت العودة إلى القراءة ولكنّني لم أستطـــع التركيز، فقد ظلّ طرف عيني يرنو ناحية تلك الكتلة البيضاء المتقدّمة باتّجاهي. لمّا صارت على بعد عمودين أو ثلاثة تبيّنت أنّها طيف آدمي كان يرقص على صوت أغان شعبية قادمة من بعيد تختفي وتظهر من جديد متماوجة مع حركة النسيم، ومسنودة بسمفونية من أصوات الصراصير الجذلــــى. وقف علي الشريف مترنّحا على بعد أمتار مني وهو يحك أسنانه ببعضها، وقال بلسان أثقله السكر: "علي الشريف يرقص لا خوفا لا طمعا". سحب من جيبه علبة معدنية مستديرة وفتحها ليتناول ممّا تحتويه قليلا ما بين سبّابته وإبهامه ثمّ استنشقه بقوّة في منخريه. في تلك اللحظة بالضبط، لمع في ذهني تفسير بدا لي منطقيا وبديهيا. وسرعان ما تحوّل إلى قناعة راسخة. هكذا اكتشفت أنّ الفسفاط يصلح لصناعة النفّة تلك المادّة المعدّلة للمزاج والمزوّدة بالطاقة والحرارة. ورحت أتخيّل كيف أنّ جميع الدّول تستورد النفة من عندنا وأنّنا إلى جانب المغرب من أكبر الدول المصدّرة للنفة في العالم. كنت متحمّسا لاكتشافي ولم تكد تشرق شمس الغد حتى انطلقت أشرح نظريتي لأترابي في الحي ولم أجد صعوبة في إقناعهم بوجاهتها. هكذا، صرنا نستنشق الفسفاط في مناخيرنا ونخزنه تحت ألسنتنا.
متى وعينا بحقيقة الفسفاط وبتاريخ المناجم؟ في 26 جانفي 1978 بمعهد قفصة؟ أم في عملية عز الدين الشريف 1980 بقفصة؟ أم في انتفاضة الخبز 1984 أيام الجامعة؟ أم بعد إزاحة بورقيبة في 7 نوفمبر 1987؟ كانت كلّ محطّة من هذه الانعطفات التاريخية تزيد من وعي جيلي بمن نحن ومن أين جئنا وما حقيقة الفسفاط؟ هل كان يجب أن نكبر ونفتح أعيننا على كلّ هذا؟ ماذا استفدنا لمّا استعضنا عن تفسيرنا الطفولي بتفسيرات التاريخ والاقتصاد والسياسة؟
تمثّل القرية المنجمية بيئة فريدة من جميع النواحي، أكانت اجتماعية أو عرقية أو ثقافية أو اقتصادية أو صحية، إلخ. حيث تتفاعل كل هذه الجوانب لتمنح الحياة المنجمية طابعا خاصا لا نجد له مثيلا في أي بيئة أخرى، حتى ليمكن الحديث عن هوية منجمية دون مبالغة. لكنّ هذه الهوية تقوم على مفارقة، تتمثل في أنّ المنجمي قد لا يشعر بصلة كبيرة تربطه بمواطن له يقطن بمدينة ساحلية أو بسهول الشمال، في حين يتماهى مع عامل منجم أيرلندي أو جنوب أفريقي. يتّخذ المنجميون من بزّة العمّال الزرقاء هويّة لهم أكثر ممّا هي الجبّة والشاشية لسائر بني وطنهم. ويؤثّر فيهم شريط البؤساء المقتبس عن رواية "جرمينال" للكاتب إيميل زولا أكثر من شريط الرسالة لمصطفى العقاد. ليس لكونهم أقلّ وطنية وتجذّرا في هويتهم، ولكنّ ذلك دليل انفتاحهم على الإنسانية وهمومها.
تنشأ المناجم في كل مكان من العالم بنفس الطريقة تقريبًا. هناك دائمًا رأس مال قادم من مكان آخر يأتي للاستقرار في منطقة لا يقدّر أهلها ما تحويه من ثروات، هذا إذا كانت مأهولة أصلا. ولاستخراج الثروة الباطنية يجلب رأس المال الاستثماري معدّات وينصب آلات ميكانيكية. وسرعان ما يتقاطر الفقراء الذين لا يملكون غير سواعدهم لبيع قوّة عملهم للمستثمر الوافد. تنبت قرية حول موقع المنجم وتجري فيها حياة على إيقاع دورة التأجير. وهذا يعطي نموذجا مميّزا من العيش والعلاقات والسلوكات والاقتصاد، يختلف عن نموذج الحصاد ذي الدورة السنوية أو الرّعي المرتكز على الترحّل أو التجارة المتمحور على المبادلة والاحتكار والمضاربة لتوسيع هامش الربح أو الريع الذي يعني دخلا ثابتا من استغلال عقار أو ثروة طبيعية وفيرة. وكلّما اشتدّت مشقة الحصول على الأجر ازدادت سهولة صرفه وتبخّر بسرعة أكبر. كأنّ عامل المنجم يريد مجازاة نفسه عن عناء العمل وتعويض ما عاشه من حرمان وضنك. يشجّعه على ذلك أمران. أوّلهما عدم كفاية الأجر إلى غاية صرف الأجر الموالي مهما قتّر العامل في الصّرف. وثانيهما أنّه يرى في الأفق راتبا جديدا قادما سيستعيد به النفس لأيّام قبل الغرق مجدّدا. كثيرا ما يردّ العامل المنجمي على انتقادات سكّان واحات الجريد المجاورة لسلوكه هذا الذي يرون فيه تهوّرا، بأنّه يفضّل أن يعيش ديكا لليلة على أن يعيش العمر دجاجة.
ليس للعمّال المؤسّسين للمنجم سابق معرفة ببعضهم البعض. كانوا يجيئون أنفارا من عدّة جهات وفيهم القادم من المغرب والجزائر وليبيا. يتعرّفون على بعض وهم منهمكون في استخراج التربة والصخور السوداء تحت الأنفاق الرّطبة الخانقة والدواميس المظلمة . لا يربطهم بعضهم ببعض لا الدم ولا القبيلة. وضعهم المشترك هو الذي يقرّبهم من بعض ويوحّدهم. ينشأ كلّ شيء في جوف الجبل وبين أحشائه: الصداقات، التحالفات، التكتلات، التحدّيات، البطولات، الشهرة، إلخ. هناك تُفْتَــكُّ الزعامة وتُكْتسب المصداقية وتظهر الكاريزما. ومن هناك تخرج إلى سطح الأرض وتنتشر بين أهل القرية.
تشكّلت جغرافيا الأحياء داخل هذه القرية في البداية وفقًا لأصول العمال، فسمّيت بأسماء جهاتهم وأوطانهم (بطيمات الجريدية، نزلة السوافى، نزلة الطرابلسية، المرّوك، إلخ.) وتشكّل هذه الأحياء حزاما حول مركز القرية أو الفيلاج الذي يأوي حي المهندسين والإطارات الإدارية حيث تقع كلّ المرافق الإدارية والصحية والترفيهية. وحول هذا الحزام الأوّل يقع حزام ثان تتوزّعه العروش والقبائل أصيلة الجهة التي كانت تعيش على نمط الرّعي القائم على التحرّر من قيود الزمان والمكان وهو نمط لا يتلاءم مع نمط العمل المؤجّر القائم على دورة زمنية مغلقة وعلى الاستقرار في المكان. وبالتالي استنكف أصحاب الأرض في البداية من العمل في المنجم.
لكن طبيعة العلاقات التي كانت تنسج بين العمال في جوف المنجم لم تلبث أن انعكست على العلاقات الاجتماعية بشكل عام. في المينة، يزول الحذر من الآخر بمجرّد أن تزول الكلفة. وتزول الكلفة أوّلا بين الرّجال تحت الدّاموس في سياق العمل. يحتاج العمّال إلى المزاح والتشاكس والتآزر ليتغلّبوا على الخوف وعلى قساوة العمل عشرات الأمتار تحت الأرض. يذهبون إلى الدّاموس مع بعض فيالقَ مترجّلة ويؤوبون منه كذلك. كنت أسمع وقع خطاهم وصدى أحاديثهم وهم يمرّون وراء بيتنا فأتطلّع من وراء النافذة المطلّة على سكّة القطار لأراهم يمشون في أزيائهم الزرقاء الموحّدة وخوذاتهم على رؤوسهم وهم يتحادثون رافعين أدوات عملهم فوق أكتافهم فيبدون لي كجنود عائدين من الجبهة مسندين بنادقهم إلى أكتافهم. يتحلّقون داخل الدّاموس حول الطعام ليتقاسموا ما جلبوه من ديارهم. زوجة فلان أمهر النساء في الطبيخ، وزوجة علاّن تخبط خبط عشواء. لا ينتظر الأطفال وأمّهاتهم أن تنتقل إليهم عدوى الألفة التي تنشأ بين الرجال في المنجم. فغالبا ما يكون الأطفال قد تعارفوا أثناء اللعب في بطحاء الحي، والنساء قد تبادلن الزيارات.
وسيكون بناء شركة الفسفاط لأحياء سكنية خاصّة بالعمّال العنصر الحاسم في إعادة تشكيل جغرافية القرية وخارطة العلاقات فيها. صار العمّال يختارون منازل إقامتهم في ضوء ما يربطهم من علاقات وود في فرق العمل دون اعتبار لروابط الدم والجهة والقبيلة. ولعبت تلك الأحياء التي تعرف باسم الملاجئ دورا أساسيا في تشكّل طابع الحياة المنجمية التي تتميّز بإيقاع وقيم اجتماعية وثقافية متفرّدة. فالتجمعات المنجمية ليست مدنا بما يميّزها من كثافة سكانية عالية وتنوع اقتصادي ومحو للهوية الفردية ولا هي كمدن الجريد المجاورة تلك التجمعات الحضرية القديمة القائمة حذو الواحات والمكتفية بذاتها بما يصاحب ذلك من روح محافظة وعدم اختلاط بالآخر ودورة اقتصادية يوقّعها موسم جني التمور. وهو ما يدفع الناس إلى الادخار وتوزيع المداخيل على كامل السنة وانتشار عادات التخزين والعولة.
للحياة المنجمية قدرة على الجمع بين قيم متضاربة في العادة. فالهوية الفردية غير ممحوّة في القرية المنجمية. ولكنّ ذلك لا يحدّ من حرية الفرد ولا يعزّز الرقابة الاجتماعية إلى حدّ تصير فيه خانقة للفرد. الناس في المناجم متحرّرون نتيجة الاختلاط الإثني. الدعارة مثلا ليست معيارًا للإقصاء الاجتماعي وغالبية الزوفرية (العمال) يشربون الخمر، والناس على إيمانهم القوي ضعيفو الإقبال على الممارسة الدينية. كما أنّ وجود نخبة مكوّنة من المديرين التنفيذيين والمهندسين كان وراء توفير بنية تحتية إدارية وخدمات متطوّرة منذ فجر القرن العشرين، لم تكن متاحة حتى في المدن الكبرى (شبكات الكهرباء والمياه الصالحة للشرب والمستشفيات والمدارس ومكاتب البريد وخطوط الهاتف والسكك الحديدية ودور السينما وحتى ملاعب التنس).
لم يبق الأمر على هذه الحال بعد استقلال تونس، وخصوصا بعد رحيل آخر المهندسين الفرنسيين في نهاية السبعينات من القرن الماضي. ثمّ شهدت شركة الفسفاط في ثمانينات القرن الماضي إعادة هيكلة إثر مكننة العمل والتخلّي عن الاستخراج الباطني للفسفاط مقابل الاستغلال السطحي. وقد خفّض ذلك عدد الحوادث القاتلة وقلّص من عدد العمّال. كما خفّف من كلفة الاستخراج ورفّع الإنتاجية. وانعكس كلّ ذلك على رواتب العمّال التي شهدت ارتفاعا ملحوظا، مقابل انتشار كبير للبطالة بسبب تراجع فرص التشغيل بالمناجم. سرعان ما انعكست هذه التغيّرات الهيكلية على نمط حياة الناس ونظام القيم لديهم. كانت التحوّلات تحصل في اتجاهات متشابكة ومتنافرة. صار التنافس على فرص التشغيل القليلة سببا في إحياء النعرات العروشية. وانتشرت ظاهرة المخدّرات وشرب الكحول التجاري وارتفعت الجريمة وتراجع الإيمان بدور المدرسة وصار شباب القرى المنجمية يركبون قوارب الموت نحو إيطاليا. في نفس الوقت، انتشر بين عمال شركة الفسفاط وموظّفيها سلوك استهلاكي واستعراضي غريب عن قيم العمّال وعاداتهم التضامنية. تلاشت ثقافة الجهد والتضحية بالنفس التي صنعت سمعة عمال المناجم وشحذت كبرياء أبنائهم وأحفادهم على مدى أجيال لتحلّ محلّها ثقافة غريبة من التباهي بالكسب السهل هي أقرب إلى ثقافة الريع البترولي التي كم كان التونسيون يستنكرونها من السواح الليبيين الذين يزورون تونس بحثا عن النبيذ والجنس.
صارت مدن الحوض المنجمي تعيش مفارقات غريبة من سماتها التفكك الاجتماعي والتشرذم القيمي. فأنت تشهد في الوقت جموعا من الشباب تتظاهر مطالبة بالتشغيل وبالعيش الكريم ليقابلها النظام بالرصاص والصعق بالكهرباء والسجن والتعذيب، ومن ناحية ثانية يصدمك انتشار منطق العروشية الذي وصل أوجه في مواجهات دامية بعد الثورة ذهب ضحيتها عشرات القتلى بوحشية لا توصف. كما تزداد انتشارا كل يوم ثقافة المباهاة بالشطارة والتواكل والفساد دون أن تلقى استنكارا من أحد، على الرّغم من أنّها تحصل في واضحة النهار وعلى مرأى ومسمع من الجميع. مسؤولون نقابيون مرتشون وفاسدون لا أحد يجرؤ على إحراجهم بسؤال "من أين لك هذا؟" فقط لأنّهم متمترسون وراء حصن العروشية المنيع، شركة الفسفاط هوت بفعل أبنائها أوّلا ومن أوصدت في وجوههم أبوابها ثانيا. الكلّ يطالب بنصيبه من هذه البقرة التي ركّعوها وأعملوا فيها السكاكين وحوّلوها إلى جثة لا تقوى على الحراك.
عند المغرب، أنزلني مصطفى أمام بيت مجدة بالفيلاج وواصل طريقه مع وليد وزينب باتّجاه الواحة الجبلية، حيث ينتظم المؤتمر. كان مجدة قد اتّصل بي ليعلمني بوصوله إلى القرية منذ الظهر وأنّه بانتظاري بعدما أعدّ لي مفاجآت كثيرة. مجدة لم يبع بيته كما فعل أغلب من تقاعدوا وانتقلوا إلى العيش في المدن الساحلية. حافظ عليه مغلقا كما هو بأثاثه وقرميده وسياجه الخارجي وحديقته الخلفية.
مجدة هو اسم شهرة أطلقه أهل القرية على مجيد الطّاهري أيّام كان نجم الفريق المحلّي لكرة القدم. لم أكن أتصوّر أن تربطني به صداقة ذات يوم. فالرّجل يكبرني بعشرين سنة. وهو إلى ذلك نجم معروف وموظف بشركة الفسفاط، يخالط المهندسين الفرنسيين ويشبههم سلوكا ومظهرا. كنت أشاهده من وراء السياج المشبّك الذي يحيط بأرضية الملعب وأنا منبهر بفنياته في مراوغة اللاعبين على خط التماس. من كان يتصوّر أن ينتهي مجدة متقاعدا يرتاد "بار بلحاج" ككلّ السكّيرين؟
فسّـــر كثيرون ذلك بحالة الفراغ التي وجد نفسه فيها خصوصا بعد رحيل آخر المهندسين الفرنسيين وإغلاق ناديهم حيث كان يشرب نبيذا فاخرا بعيدا عن العامة ويلعب التنس والكرة الحديدية. عند الحادية عشر صباحا بالضبط، يدخل مجدة البار ويتّجه رأسا إلى المصرف فيناوله بو العز تابوريه عال يسمح له بإسناد مرفقه على الرخامة حيث يتكفّل العامل وراء المصرف بتجهيز طلبات الحرفاء ليتولّى نادل القاعة توزيعها على أصحابها.
يسلّم مجدة للعامل قرطاسيْ المكسّرات والجبن فيرتّبها في صحن أنيق ويفتح له زجاجة نبيذ أحمر. يشرب نصفها ويغادر للغداء وأخذ غفوة القيلولة كما يقول، ثم يعود مع الثالثة وقد غيّر ثيابه وتعطّـــر. كان مجدة نشازا في ذلك البار الشعبي. لا يشبه بقيّة الحرفاء، في شيء. لا في نوعية الشرب ولا في طقوسه ولا في سلوكه. ومع ذلك كان يحظــى منهم بالتقدير والمودّة، لأنّه لم يكن حقّارا كالآخرين ممّن يجلسون وراء المصرف داخل فضاء العمل. كان أولئك السفلة يعتبرون أنفسهم أعيان القرية لا يليق بهم أن يختلطوا بالسكارجية في نفس الفضاء، حيث يكثر الهرج والتنمّر والطمع بل وحتى التسوّل.
كانوا عصابة من ثمانية أشخاص تضمّ المسؤول النقابي المحلّي ومدير مكتب الضرائب ورئيس الفرع البنكي ورئيس الشعبة الحزبية ومفتّش شرطة و ومنتحلا لصفة مهندس وصاحب مخبزة ومتسوّغ المسلخ البلدي.
كنت المبادر بالحديث يوم التقيته صدفة في مطعم البوسفور بالعاصمة. أخبرته بأنّني طالب من نفس قريته وأنّني أعرف عنه أشياء كثيرة. ابتسم في هدوء ودعاني إلى طاولته. حدست أنّه يسعى وراء فدوى بنت العايش التي غادرت القرية واحترفت البغاء في العاصمة متّخذة من ذلك المطعم محطّة لصيد الزبائن. ولا شكّ أنّه ظنّ بي نفس الشيء. تحاشينا الموضوع وتظاهرنا بالتفاجئ لمّا وصلت فدوى بعد قليل. وعلى غير عادتها في الترحيب بي، مرّت بجانب طاولتنا وكانت قد عرفت مجدة وتمتمت: "هجّجتوني من دين أمّ البلاد، وتوّا ولّيتوا تجرووا ورايا! زايد". اعتبرنا أنفسنا غير معنيين بما سمعنا، ولكنّني ظللت أخشى أن تلعب الخمرة برأس فدوى فتؤتي خارقا يسيء إلى مجدة. تظاهرت بأنّني أختنق من كثرة التدخين والضجيج واقترحت على مجدة أن ننتقل إلى مطعم أكثر هدوءا، فالتقط اقتراحي كيدٍ مُدَّتْ لغريق. لمّا هممنا بدفع الحساب، فاجأنا النادل: "الحساب مدفوع" قبل أن يضيف موجّها كلامه إليّ: "أنت تعرف فدوى مع أبناء قريتها". خرجت والعرق يكسوني فيما تظاهر مجدة بأنّه لم يفهم شيئا. في مطعم المزار، نفخت له دماغه بأحاديث عن النضالات الطلابية وطبيعة المرحلة ومتطلّباتها، حتى نبّهني صبره عليّ وإنصاته الهادئ إلى ما كنت فيه من هذيان وخمّنت أنّه قد يكون ندم على دعوتي إلى طاولته، فالتزمت الصمت. رآني ألقي بمحتوى الكأس في جوف حلقي مباشرة وأبلعه دون أن يمسّ لساني أو يمرّ بفمي، فقال لي: "أراك تتجنّب مذاق النبيذ، وتشربه كما لو أنّك تتجرّع دواء علقما... ما هكذا يشرب النبيذ يا ولد بلادي... أوّلا، أنت لست مجبرا على شربه. دعك منه إذا كنت لا تستسيغه. ثانيا النبيذ في أصله لذيذ ورائحته محبّبة. دعه يستريح في فمك، يداعب الجيوب اللعابية المسؤولة على التذوق. فإذا لم يقبله لسانك، فهذا معناه أنّه رديء. لا تشرب لتسكر... اشرب لتتمتّع بمذاق النبيذ... الفرنجة لديهم قاموس كامل خاص بالنبيذ. يسمّون رائحة النبيذ "الباقة"، ويطلقون على لونه "الفستان" (أي القماشة)... ابدأ باكتشاف باقة الكأس ثمّ تأمّل قماشته عبر البلّور... أدره بعد ذلك في الكأس ولاحظ تماسكه... اشربه بهدوء وبلا عجلة... دعه يستريح في فمك... ادفع به من أسفل اللسان وجنبات الفم إلى الحلق، تابع وخزات حرارته المحبّبة وهو ينزل متدرّجا عبر البلعوم مليمترا مليمترا، واصل متابعته حتى يصل إلى جوف المعدة. تلمّظ وتمطّق وأدر لسانك، تنفّس بمنخريك محافظا على فمك مغلقا... في كلمة، تصالح مع النبيذ ولا تسارع إلى الكأس الموالية فتخنق بذلك امتداد الكأس السابقة وتمنع عن نفسك بلوغ النشوة... لا تشرب لتسكر، فستسكر.
في نهاية السهرة، دفع الحساب ودسّ في جيبي عشرين دينارا وطلب لي سيارة تاكسي. ولكنّني قبل انطلاق التاكسي، ضربت له موعدا عند "بلحاج"
لمّا يتواعد شخصان عند "بلحاج" فمعناه نّهما سيلتقيان في حانة بلحاج وليس عند الشخص ذاته... ف"بار بلحاج" في واقع الأمر علامة تجارية تجاوزت شهرتها حدود القرية. أمّا الشخص ذاته، فقد غادر القرية منذ أكثر من عشرين سنة ليستقر بمدينة المنستير الساحلية، بعدما عيّن عزّالدين وكيلا يشرف على إدارة المحل.
حصل بلحاج على رخصة الحانة كتعويض على استشهاد ابنه قمر الدين في عملية مسلّحة نفّذتها مجموعة مناوئة للسلطة تسلّلت من بلد مجاور. والحقيقة أنّ أوّل ما فكّر فيه بلحاج بعدما فتحها اللّه في وجهه هو الحج. استشار في جواز الحج بمال الخمر شيوخا أجلاّء، فأفتوا له بأنّ فساد مصدر المال لا يفسد الممارسة التعبّدية نفسها. ولكنّ نفس الشيوخ أشاروا عليه بإزالة تلك اللافتة المعدنية التي كتب عليها "حانة قمر الدين" لما تسبّبه من اقتران الدين بالخمر في أذهان العامّة. ولعلّ ذلك المنع هو الذي دفع أهل القرية المجبولين على الزندقة إلى تسمية البار ب"بار بلحاج" إصرارا منهم على وصل الخمر بالدين.
قاعة فسيحة خفيضة الجدران، عديمة التهوئة وضعيفة الإنارة، تتدلّى من سقفها مروحة كهربائية غطّاها الغبار وخراء الذباب، تترنّح في دورانها البطيء مهدّدة بالسقوط على واحدة من تلك الطاولات العرجاء التي يغلّفها الغبار وبقايا الزيوت المحروقة. يكاد الحرفاء لا يتبيّنون وجوه بعضهم البعض من قلّة الضوء وكثافة ضباب السجائر. فإذا أضفنا إلى ذلك نوعية الحرفاء وأنماط علاقاتهم وسلوكهم فهمنا سرّ تلك المناخات المميّزة التي تعرف بها بارات المناجم.
يشكّل زوفرية المينة القسم الأكبر من حرفاء البار. حرفاء أوفياء يشربون على الحساب ولا يدفعون إلاّ عند قبض جراياتهم يوم الخلاص. شربهم المفضّل هو الديفان الوردي الرّخيص ويضطرّون إلى البيرة بوكرش عند انقطاع المرناق والكوديا. بعد الزوفرية مباشرة يأتي العملة في حضائر البناء ثمّ العتّالون فالعاطلون. وهم أسوأ الحرفاء. قليلو المال، كثيرو الشغب والتسوّل والإزعاج.
منذ تولى عزالدين إدارة البار، صار يخرج في فصل الصيف الطاولات إلى المساحة الخارجية المسيجة بسور عال. يرشّ أرضيتها بالماء ويوزّع الطاولات ما بين الجدران وشجرات الخروع المنتعشة، ومن جهاز كاسيت معلّق عند الباب يبث أغاني الستّ. يلين الهواء قليلا وتخفّ رائحة التبغ والبول والزيوت المحروقة ويغدو الجو رائقا. أثنى الحرفاء على جهود عزالدين في تحسين الخدمات وشجّع ذلك فئات جديدة من الحرفاء على ارتياد "بار بلحاج". وتأسّست مجالس جديدة تضمّ التجّار والخضّارين والجزّارين. وصار بإمكان الشباب أن يدخلوا القاعة الداخلية من الباب الخلفي حيث يجلسون دون علم آبائهم الذين يكونون في الساحة الخارجية. لم يكن ذلك بالطبع غائبا عن آبائهم، ولكنّه وضع أفضل من ظروف الشرب في الشتاء حيث يضطرّ كلّ عامل أو شاب يصل إلى البار أن يسأل إن كان ابنه أو أبوه موجودا أم لا قبل الدخول. فإذا كان الجواب بنعم، اضطرّ الواصل متأخّرا إلى العودة من حيث أتى. وقد يصل البعض إلى طلب وساطة عزالدين لإقناع الموجود بضرورة فسح المجال للثاني كي يأخذ نصيبه من السكر.
كان الشباب قليلي الموارد يكملون الشرب على حساب آبائهم الذين يغلبهم السكر فلا يقدرون على تدقيق الحساب مع عزالدين. وكان بين الشباب اتفاق ضمني على عدم الاكتراث بما يصلهم من أصداء المشاكسات بين آبائهم في الساحة الخارجية. فلن يجنوا من ذلك سوى وجع الدماغ، بل ربّما تمّ منعهم من الدخول لو تطوّرت الأمور إلى خصومات بينهم. هكذا، كان الواحد منهم يسمع كيف يحوّل والده إلى مسخرة ولا يردّ الفعل لأنّه على يقين بأنّ الأدوار لن تلبث أن تنقلب فيما بعد. لكنّ الشباب فرضوا على بوالعز أن لا يستجيب لابتزازات المتحرّشين بتقديم الشرب على حساب آبائهم. فالشرب الذي سيذهب للصعاليك الأبناء أولى به. كان ذلك اتفاقا مناسبا للجميع. فعزالدين صار يخيف المتحرّشين بالشباب الجالس في الداخل، والآباء صاروا يقبلون بخلاص شرب الغير عن طيب خاطر دون أن يكلّفهم ذلك مصروفا إضافيا.
كنت أنتظر أن يفتح لي الباب صاحب البيت. وهيّأت نفسي لتحية مجدة بما يليق به من المحبة والشوق والتقدير. ولكنّني فوجئت بسي علي مدير دار الثقافة السابق يفتح لي الباب وهو يعرج برجله. آخر عهدي بالرّجل كان بعد إحالته على التقاعد منذ أكثر من ثلاثين سنة. توغّل في الشيخوخة وأطلق شعره القليل خصلتين منسابتين على الكتفين كحكيم صيني. ارتمى الشيخ الثمانيني في حضني وأجهش بالبكاء كصبيّ تائه أعادوه إلى والديه. كانت الدقيقة التي تعانقنا فيها عند الباب كافية لأستحضر مواقف الرّجل في تجميع مثقّفي القرية وبرمجة المهرجانات ولعب دور المنطقة العازلة بين البوليس والشباب الثوري.
لم ينته العناق بيننا إلاّ وقد صرت أرى الوجوه والأشياء كما لو أنّني وضعت مرشحات ضوئية على عينيّ. الأصوات بدورها صارت أقلّ وضوحا كأنّها قادمة من بئر مهجورة غلّفتها الرطوبة. وكذلك، بقيّة حواسّي لم تعد تدرك ما يحيط بي بشكل طبيعي. فقد صرت كالمنوّم أتحرّك داخل غلافة ليّنة ودافئة تشبه كيس الرّضيع في رحم أمّه أو رجل الفضاء المحلّق خارج مدار الجاذبية.
دخلت البيت وأنا أشدّ على كفّ سي علي كعريس يزفّه والده إلى منصّة الزواج. كنت أتطلّع إلى وجوه الحاضرين وأحيّيهم بكلمات لم أكن أتبيّن إن كانت مسموعة ومفهومة أم مجرّد همهمات. تعرّفت على حارس مرمى الفريق المحلّي أيام مجدة. صار هو الآخر رجلا مسنّا بنظّارتين سميكتين. أعرف أنّه كان عامل بناء بشركة الفسفاط، ولا أذكر أنّ علاقة ما جمعتنا ببعض. في فناء غرفة الاستقبال، كان حمّة الحوّات يستلقي على حشية بجسده الضخم العاري وهو يجهّز غليون العرعار ويبتسم لي مرحّبا. تهيّأ لي أنّني سمعت أصوات نساء في الغرفة الأخرى، بل وسمعت حتّى صوت فدوى وهي تربرب.
بدأت أفهم كلام مجـــدة عندما تواصلنا بالهاتف لترتيب هذا اللقاء في بيته. أذكر كيف قال لي بمكر "لقد أعددت لك مفاجآت كثيرة"... دخلت المطبخ فوجدت مجدة رفقة محسن المهاجر إلى أوروبا وهو يعالج قارورة الكوديا بإبهامه حتى يغرسه في جوفها فتبصق شيئا من محتواها على وجهه. هلّل قائلا: "أردت فتحها على طريقة الصعاليك في روايتك. جمعتهم لك كلّهم في البيت حتى لا تبقى روايتك مجرّد خيال. ولا تسألني كيف نجحت في ذلك."
ثمّ داس على زرّ جهاز التسجيل، فصدحت زكرة زرفة وسالم الطبال وحمّة النفطـــي.
زممت شفتيّ إلى أسفل على طريقة سيدي لمّا ينتشي، وصحت فيهم "ارقصوا بالواحد، الدّار ضيقة" وعجعج البخور ولم أعد أسمع شيئا غير زغردات النسوة.
لا أذكر متى غادر الحاضرون من أبناء القرية بيت مجدة؟ ولا كيف نمنا إلى غاية الصبح. بعدما استيقظنا، انقسمنا ما بين راغب في الإفطار بهريسة حارّة ومثوّمة عند مصطفى وبين مفضّل لفطيرة مقلية عند فرح. ولكنّنا اتّفقنا أن نلتقي مجدّدا في مقهى السوق تلبية لدعوة كريمة من رشيد صديق الشباب الذي يعمل بالمقهى.
كنت أتابع مبارزة حامية الوطيس في البازقة لمّا عبر إلى الدّاخل شخص يحمل خدّه الأيسر أثر جرح قديم. كان كهلا أشيب ارتسمت على جبينه بقعة سوداء عريضة. ينتعل حذاء رياضيا أمريكي العلامة ويرتدي جلبابا أفغانيا قصيرا تحت جاكيتة سوداء. حيّاه أحد الجالسين "صباح الخير عم بشير؟" قبل أن يلتفت نحوي سائلا "ألم تعرفه؟".
وبدل أن أجيبه، رأيت نفسي طفلا في العاشرة متطلّعا إلى المجلاّت البديعة المعروضة على باب كشك الشيخ إبراهيم بالليل، ماسكا بمِقْبَضَيْ البرويطة المحمّلة باحتياجات الأسرة من قضية الشهر (السبيسة). كان والدي يحرص على ترصيف المشتريات بشكل فيه جمالية ونظام يستعرض من خلاله للآخرين تنوّع ووفرة ما اشتراه لأسرته. كنت منغمسا في قراءة العناوين، لمّا استرعى انتباهي صراخ وجلبة قادمين من بطحاء السّوق أين تجمهر الناس يتدافعون حول حلقة يلفّها غبار كثيف. وبدافع الفضول، وجدت نفسي ألتحق بالجمع محاولا أن أشق لي منفذا أطلّ من خلاله على وسط الحلقة. لمّا نجحت في ذلك، فوجئت بحلبة مصارعة رومانية بطلاها شابّان أعرفهما جيّدا. أحدهما فرشيشي حديث العهد بالقرية، اسمه بشير وهو جار لنا، يقيم في البرّاكات المعدنية التي أقامتها الكبّانية لإسكان العزّاب المنتدبين حديثا. أمّا الثّاني، فكان الطّاهر لوصيف. شاب أسمر ووسيم، هادئ الطبع ورومنسي. صار نجما معروفا ومحبوبا لدى أهل القرية منذ مشاركته المتميّزة في البرنامج التلفزي "نجوم الغد" حيث أدّى أغنية لعبد الحليم حافظ. يقال واللّه أعلم أنّ له ميولا مثلية. قدّرت في خاطري، ربّما كي لا ينغّص عليّ ضميري لذّة الفرجة، أنّه لا يمكن أن يلتزم كلّ ذلك الجمع بالحياد والاكتفاء بالفرجة دون سبب وجيه يجعلهم يطلقون هذين الرجلين أحدهما على الآخر كوحشين متعطّشين للدّم. فلابدّ أنّ أمرا جللا حصل بين الرّجلين. كان بشير يتفوّق بوضوح على خصمه في البنية الجسدية والعضلية. وكان متعرّقا يبتسم ويدور حول الطّاهر الملقى أرضا، ممهلا إيّاه كي ينهض دون أن يفارقه بعينيه المتّقدتين كالجمر. يبدو منتشيا بسيطرته على خصمه ويتصرّف كما لو كان يؤدّبه. نهض الطّاهر الرّومانسي المسالم مدمى. ومترنّحا استعان بصرخة استلّها من أعماق أعماقه وأطلقها كالجمل الهدّار وعلى فمه مزيج من رغوة بيضاء ودم ساخن، ليفاجأ بشيرا بلكمة جعلت فكّاه يصطكّان ووقفته الثابتة ترتجّ. أحدث ارتطام قبضة الطّاهر الرومانسي المسالم بشدق بشير صوتا مكتوما وحادّا. ومواصلا صرختة الهادرة التي كان صداها يجلجل في أرجاء سوق القرية، انقضّ الطّاهر الرومانسي المسالم بأسنانه على وجه بشير لينتش منه قطعة لحم حي جعلتني رؤياها أغمض عيني من فرط الفضاعة وأنسحب من الحلقة هاربا نحو منزلنا.
في العشية، كانت والدتي لا تزال تكمّد لحمي المزرقّ بفعل سياط حزام والدي الجلدي عقابا لي على فقدان برويطة القضية، لمّا دخلت الخالة تركية العوراء لتخبرنا بمقتل الطّاهر الرّومانسي المسالم على يد بشير الفرشيشي... كان سبب المعركة إصرار بشير على الفوز بقلب عائشة راقصة الفنون الشعبية ومنظفة دار الشعب التي كانت ممزّقة بين رومانسية الطّاهر وفحولة بشير. نال بشير الفرشيشي حكما بالسجن لعشرين سنة، ولم يعد أحد يذكره إلاّ في معرض الحديث عن واقعة موت الطاهر الرمانسي المسالم. ولكنّني خرجت من تلك الواقعة بأسئلة ظلّت تلازمني حتى لمّا غادرت القرية للدراسة بالجامعة: "لماذا لم يتدخّل المتفرّجون من سكّان القرية لفض المعركة؟؟ لماذا اختاروا الفرجة وتلذّذوا بها؟؟ كان يمكنهم إنقاذ بشير الفرشيشي من أن يصير قاتلا. كان يمكنهم إنقاذ الطّاهر الرومانسي المسالم من أن يموت مقتولا. وهاهي نفس الأسئلة تستيقظ في دماغي الآن وأنا جالس في بهو المقهى قبالة السوق القديم...
لمّا عبر أمامي ذلك الأفغاني ذو الجرح القديم الغائر في خدّه الأيسر مغادرا المقهى، تساءلت بصوت مسموع: "ما الذي عاد بالبشير الفرشيشي إلى القرية بعد سجنه؟ لماذا لم يعد إلى أهله؟" أجابني توفيق وهو يوزّع الأوراق على اللاعبين: "الحب يا صديقي، الحب... انتظرته عائشة طيلة عشرين سنة وتزوّجا بعد خروجه من السجن. وها أنت تراه وقد تاب عليه اللّه وأنعم عليه من حلاله."
كان عثمان أوّل من وصل إلى القرية لإعلام الناس بالخبر. اهتزّت القرية لما حدث حتى بدت بيوتها ترتجف وأشجارها تترنّح وتهيّأ للنّاس أن القمر أصابه الخسوف. مرّ عثمان يجري أمام المقهى وهو يصيح بأعلى صوته "يا ناس سيدي الطائر تحرق، يا ناس سيدي الطائر تحرق" وكانت هناك نسوة يهرولن خلفة مولولات ونافشات شعورهن. ولم يلبث الخبر أن بلغ العمّال في الداموس فتوقّفوا عن العمل.
هل كان احتراق مقام سيدي الطائر مجرّد حادث ناتج عن خطأ بشري أو عطب كهربائي؟ هل من الصدفة أن يحصل ذلك قبل موعد زيارته السنوية بثلاثة أيام؟ زيارة يتنادى إليها كلّ أولاد سيدي الطائر حتّى المقيمون منهم بالخارج. من له مصلحة في إضرام تلك النار التي أتت على ما في المقام وهدّت سقفه وسوّت تابوته بالأرض فلم يبق منه سوى أجزاء جدران محروقة؟ وما الدّافع إلى حرق المقام أصلا؟ رأى البعض في نسخ القرآن التي لم تطلها ألسنة النار ووجدوها مجمّعة على بعد أمتار من رماد المقام، دليلا على أنّ الحريق فعل مدبّر، قام مرتكبه باستبعاد نسخ القرآن. بينما اعتبر آخرون أنّ ذلك دليل على كرامات سيدي الطائر الذي حمى كتاب الله وأبعده عن ألسنة اللهب.
لم يصلوا إلى جواب قاطع، وظلّت أسئلتهم الحائرة تتفاعل مخلّفة استياء وغضبا يكبران ككرة الثلج كلّما تقدّم الوقت. وما كاد النهار ينتصف حتى تجمهر الناس عفويا في بطحاء المجمّع الإداري للقرية حيث تقع دار الحزب والمعتمدية ومركز الأمن كما لو أنّهم تنادوا إلى هناك. لم يكن المتجمهرون من أولاد سيدي الطائر فقط. كانوا خليطا من جميع سكّان القرية ذوي الأصول القبلية والجهوية المختلفة. فقيمة سيدي الطائر ومكانته تتجاوز أحفاده لتشمل كل من يسكن القرية. الكلّ يرى في نفسه ضيفا على سيدي الطائر في أرضه، ويرى في سيدي الطائر راعيا للسّلم الاجتماعي وحاميا للعمّال من انهيار الداموس على رؤوسهم. الجميع يهبّ إلى زيارته السنوية يذبحون الذبائح ويلهجون بالأذكار ويتبرّكون بسيرته العطرة. الزيارة السنوية لسيدي الطائر ليست مجرّد طقس ديني يتلى فيه القرآن وتقرع الدفوف وتنحر الخرفان. إنّها إلى جانب ذلك مهرجان احتفالي كبير وتقليد اجتماعي فريد. هناك تقام مسابقات الفروسية ويطلق البارود ويتبارز الشعراء الفطاحل وتعلو الزغاريد ويتخمّر الراقصون والراقصات على إيقاعات الدفوف والإنشاد الصوفي . هناك تلبس الصبايا أزياء جدّاتهن ويتحلّين بالفضة ويتمشّين في الروابي بغنج فيخطفن عقول الشباب. وسيدي الطائر من مرقده في أعلى الربوة يشرف على الكل ويرعاهم بسماحته وسعة باله.
انتصب محسن يخطب في الناس: " ما جدّ في زاوية سيدي الطائر اليوم دليل على تقصير الدّولة في حماية المقام بصرف النظر عن طبيعة الحريق ومصدره. فلو كان هناك حارس قارّ لأمكن له طلب النجدة في الإبّان. هذا ليس أوّل حريق يتعرّض له مقام ولي صالح في بلادنا بعد الثورة. صرنا نسمع منذ مدّة عن حرائق تشب في أضرحة الأولياء ومقاماتهم. وفي بعض الأحيان، تأتي الاعتداءات على شكل أعمال تخريب وهدم ونهب لمحتويات هذه المقامات التي هي من مكوّنات تاريخنا وهويتنا وثقافتنا. لا ترهقوا عقولكم بأسئلة أجوبتها ماثلة أمام أعينكم منذ أن انتصبت الخيام الدعوية في كلّ أرجاء البلاد. إنّهم الوهابيون ولا أحد غيرهم. أولئك الذين نصّبوا أنفسهم أوصياء على موروثنا دون تفويض أو استئذان منّا. إنّهم هم الذين أعلنوا الحرب على عاداتنا وقرّروا فسخ المقامات من حياتنا. لكن هيهات... فلا القرون المتوالية بويلاتها ولا الغزوات الاستعمارية ولا التحديث الفجّ استطاعت أن تقضي عليها. لأنّها ببساطة الترجمة البليغة لروح الإسلام السمح في أرض المغرب العربي. ظلّت بمبانيها البسيطة ذات القباب الجصّية البيضاء الجاثمة في هدوء وأمان ينطقان بحكمة التصوّف التي كان عليها أصحاب هذه المقامات الطّاهرة الزّكية، ظلّت على مدى القرون صامدة على قمم الجبال وفي أعماق الصحراء وفي قلب المدن شاهدة على الدّور الذي لعبته عبر القرون كعلامات دالّة تؤسّس الطّرق التجارية وترشد القوافل تارة وتجمّع المريدين لتؤسّس المدن وتزرع الصادق عمران تارة أخرى."
كان الناس ينصتون إلى ذلك الكهل الأشيب متفاجئين بجرأته على تسمية الأشياء بأسمائها دون مراوغة. أغلبهم وخصوصا الشباب منهم لا يعرفون محسن، لأنّه استقرّ في فرنسا التي سافر إليها بغرض الدراسة، وصارت زياراته إلى القرية قليلة ومتباعدة بعدما تزوّج بفرنسية.
هذه المرّة، جاء محسن خصّيصا لحضور حفل توقيع رواية الصادق عمران. لمّا قرأها وجد فيها صدى لأيام الدراسة الثانوية بمعهد قفصة. أعجبته قدرة صديقه على الاحتفاء بالتفاصيل وتفجير الأحاسيس والأفكار من تلك الأشياء والمواقف الصغيرة التي كانت تبدو بلا دلالة أو تأثير. أخذته أحاسيس متداخلة بين الحنين والشجن والفرح والمتعة. ودوّن بعض التعليقات على صفحات الرواية. لمّا علم بحفل التوقيع، قرّر أن يحضره ويناقش الصادق في أشياء كثيرة.
التعليقات
لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... ! تابعنا على الفيسبوك
مقالات شيقة ننصح بقراءتها !
مقالات مرتبطة بنفس القسم
المسجِّلة
عرف هذا الجهاز أوج انتشاره في سبعينات القرن الماضي. وكان من علامات الرفاه الاجتماعي في قريتنا. لا يهاجر الواحد إلى ليبيا إلاّ ويعود بجهاز كاسيت من ماركة آيوا الشهيرة. أجهزة بأحجام مختلفة وقوة صوت متفاوتة. بعضها يقتصر على وظيفتي

الطوفان
يأتي الطوفان فجأة ...أو دعني أصحح أتاني الطوفان فجأةلم أسمع يومها إلا عصافير شجرة التوت تزقزق بطريقة غريبة تصرخ بصوت واحدكنت قد أنهيت الغذاء وجلست علي الطاولة تنهدت مُطولاً ..طوفان !!!حتي بدأت المياه بتحطيم النوافذ وامتلئت كلي بالماء مبللة أنا




بین الواقع و المنطق تساؤلات عن ما نعشیھ في حیاتنا
رُبما يقول الواقع إنه لا اختلاف بين عام وعام، وأن الحياة قبل الثانية عشر ليلًا هي ذاتها الحياة بعدها، في الحقيقة الواقع لا يكذب، ولكننا في نفس الوقت لا نعيش بداخله كليًا، لا نحتاج إلى العيش معه أصلًا، لا




"بالسيارة إلى السودان" كتاب من تأليف الأمير المجري لاسلو ألماشي يصدر قريبا بالعربية
الكتاب من تأليف الأمير المجري والرحالة ورائد الطيران الشراعي والمستكشف والجغرافي الشهير لاسلو ألماشي الذي كان يعشق مصر وكان له علاقات وطيدة بالملك في ذلك الوقت حتى قيل إن مطار "ألماظة" في مصر قد سُمي باسمه ولكن تم تحريف
كيف صارت ليلتك ؟
أما أنا فصارت ليلتي ككل ليلة ، باهتة الشعور أحلق في فضاء خاطري فلا أجد فكرة مؤنسة ،أو مؤرقة هكذا صارت أيامي ، رمادية اللون حيادية الكون، الليل العاصف بالأمس صار ركاما باليوم ،وتحت الركام تنمو العواصف والآكام وهكذا