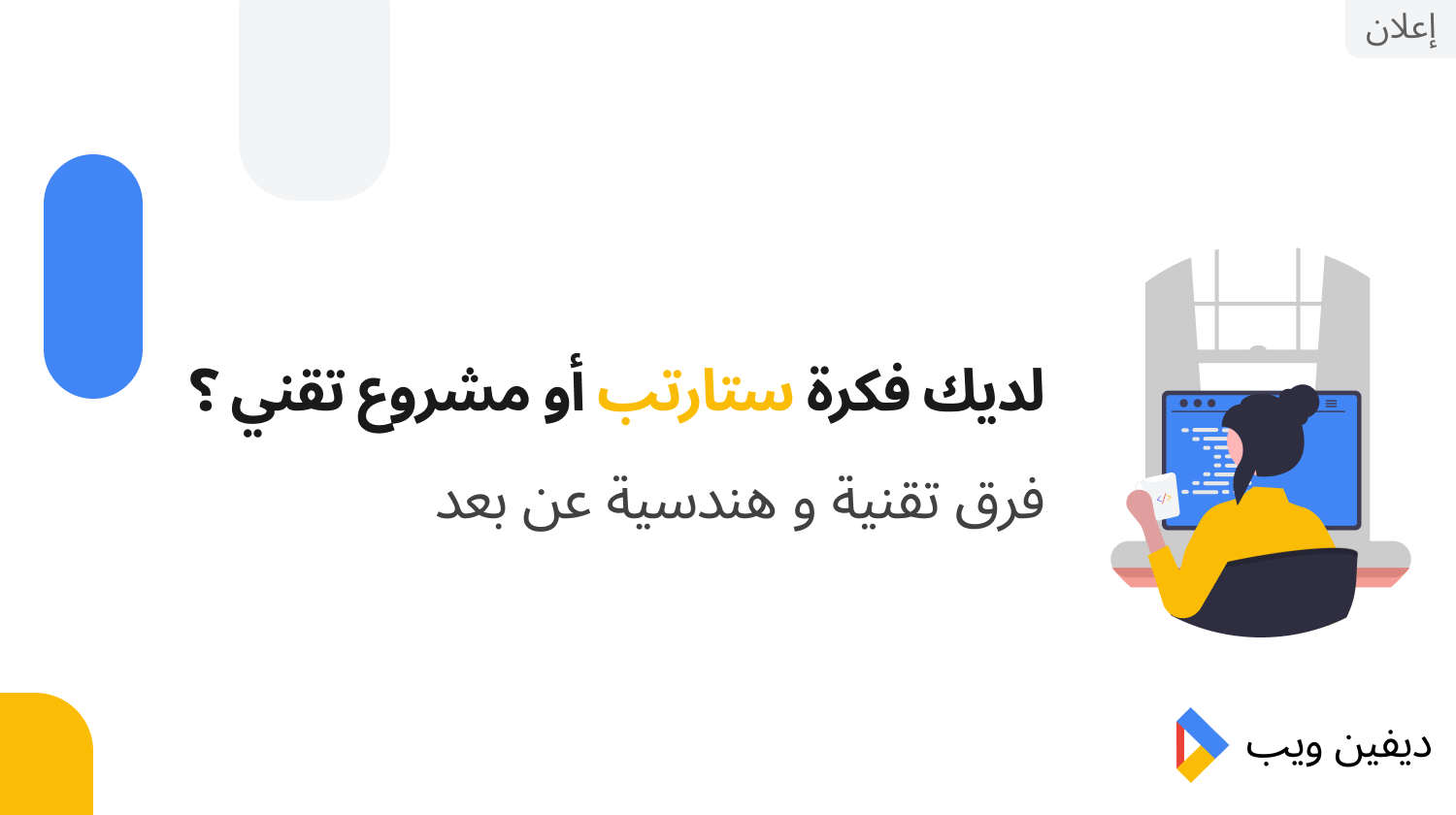يعد تعريف المصلحة الخاصة بما يتعلق بأفراد مخصوصين أو بمصالح فئة إجتماعية معينة دون غيرها، أما تعريف المصلحة العامة فهو بما يتعلق بمصالح المجتمع ككل . يعد فهم المصلحة الخاصة أمرا بديهيا وبسيطا فنحن نلبي مصالحنا الخاصة من خلال ممارسة حياتنا اليومية و تعاملاتنا مع الآخرين ، ولكن ما ليس بديهيا هو المصلحة العامة، أى من الذى يملك تحديد تلك المصالح العامة و اعتبارها أولوية عن المصالح الخاصة للأفراد العاديين .
وفقا لمثلث ماسلو للاحتياجات ، فإن الاحتياجات الفسيولوجية ( الغذاء، الصحة ، السكن ) والأمان ( الاستقرار الوظيفى والأسري ) يعتبران قاعدة الهرم الاجتماعى للافراد ، وهى مصالح ذات أولوية لجميع الأفراد، يمكن القول أن تلك الاحتياجات الاساسية هى مصالح خاصة مشتركة بين جميع الأفراد تم تعميمها لتصبح مصلحة عامة ذات ضرورة بالنسبة للجميع .
وفقا لهذه التعريف يتم تحديد المصالح العامة وفقا للمصالح الخاصة، والاختلاف فى تعريف المصلحة العامة ليس سوى نتيجة لتضارب المصالح الخاصة بين فئات اجتماعية عديدة ، أو إختلاف وضعهم الاجتماعي وترتيب سلم الاحتياجات، فبالنسبة للشق الثانى يعتبر الأفراد الذى توافرت لديهم الاحتياجات الأساسية من غذاء ومسكن و استقرار أسري و وظيفى، يمتعضون بشدة لأى احتجاج تمارسه فئات إجتماعية أخرى لتغيير أوضاعهم الاجتماعية ، فالفئة التى لا تملك قوت يومها أو نظام صحى و بيئى مناسب لا تكترث كثيرا لما يسمى بالأمن العام، الذى يعتبر مبرر لرفض أى محاولة للتغيير قد تحدث اضطراب قد يؤثر على النمط الهادئ و المستقر لفئات إجتماعية أخرى، فهم يجعلون أولوية مصالحهم الخاصة مصلحة عامة يجب فرضها على جميع الفئات .
لا تعد آليات التغيير فقط هو ما يثير القلق والخوف لدى بعض الفئات، بل إن التغيير فى حد ذاته حتى ولو بطرق سلمية هو الأكثر خوفا و قلقا لدى بعض تلك الفئات التى قد يؤدي التغيير إلى التأثر سلبا على أوضاعهم الإجتماعية وما يحصلون عليه من امتيازات مرتبطة بالسلطة وممارستها، فهم يتماهون مع السلطة وخطابها المتعلق دائما بتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فمصطلحات مثل السيادة والأمن القومى و الإستقرار وبناء البلاد تصبح بالنسبة لجموع الناس تعبيرات خالية من معنى إن لم تتحسن أوضاعهم الاجتماعية و المعيشية . فهؤلاء الفئات من أصحاب الإمتيازات لا يرتبطون بالسلطة فى خطابها فقط بل يرتبطون بها بحكم مجالهم الوظيفى، فبحكم طبيعة الوظيفة التى تعطيهم امتيازات مادية و تشريفية تجعلهم أحيانا فوق القانون، وهم يعلمون بطبيعة الحال أن الحفاظ على تلك الامتيازات مرتبطة بوجود السلطة الحالية .
ولدى تلك الفئة شعور ذاتى بالتفوق الطبيعى على الأخرين ، حيث أن هذا الشعور الإستعلائى يعطيهم المبرر بأحقيتهم المطلقة فى تلك الامتيازات ، بل أحقيتهم المطلقة فى التسلط على الأخرين و تقرير مصيرهم ، وهم يشعرون بدونية أى فئة أخرى لا يتماهى مع خطابهم السلطوى والتمييزى . فتصبح مصطلحات مثل السيادة، سيادتهم هم، المطلقة بدون رقيب أو حسيب، والأمن ، أمنهم هم فقط دون سائر الناس، أما بناء البلاد ، فليس سوى تضخيم لثرواتهم ونفوذهم وإحكامهم السيطرة على المجتمع عن طريق المؤسسات البيروقراطية و الأجهزة الأمنية .
ورغم أن شعورهم الوهمي بالتفوق مرتبط دائما بموقعهم الوظيفى وإرتباطاتهم العائلية داخل تلك المؤسسات والأجهزة ، فهم لهذا يعملون على تضخيم دور تلك المؤسسات، وهى فى الأصل تعتبر مؤسسات عامة، وجودها القانوني مرتبط بتحقيق المصالح المشتركة لجميع أفراد المجتمع، إلا أنها من الناحية العملية تحقق فقط المصالح الخاصة للقلة الحاكمة وأصحاب الإمتيازات، و يتم تأهيل نفسى و أيدولوجى للعاملين الغير المهمين فى هذه المؤسسات أو من ليسوا أصحاب النفوذ والإمتياز للعب هذا دور، وهو تأمين وحماية أصحاب السلطة و الإمتياز مقابل الحصول على حد أدنى من الأمان أو نفحة بسيطة من أرباب عملهم ، يمكن القول إنها طبقة طفيلية لا تستطيع العيش إلا إقتيات، وهم يتماهون بالكامل مع أصحاب السلطة والإمتياز، وكلاهما يستطيع أن يمارس دور تسلطى على الأخرين من خلال القانون أو حتى خارجه، فالقانون هنا لا يشرعن إلا لحماية أحقيتهم الكاملة فى التسلط أو تحجيم وقمع هؤلاء الذين يخرجون عن سلطتهم، سلطتهم التى تعتبر فى النهاية تمثيل للمصلحة العامة .
لا تعتبر المصالح والمدافع المادية فقط هى المحدد و المفسر لمفهوم المصلحة العامة، بل أيضا تدخل الإعتبارات الثقافية و الأيدولوجية للأفراد و الجماعات فى تحديد المصلحة العامة، ورغم أن الإعتبارات المادية والمصالح الطبقية لها دور هام فى التكوين الثقافى والأيدولوجى للأفراد و الجماعات، فإن المصالح المادية غير مرتبطة بشكل مباشر مع المواقف الأيدولوجية تجاه قضايا معينة، فقد يتخذ فرد موقف رافض أو مؤيد تجاه بعض الممارسات ليس بناء على إعتبارات أخلاقية محضة أو بناء على على مصلحة مباشرة أو ضرر مباشر بل بناء على الجهة الفاعلة والهدف من تلك ممارسات، حتى لو كانت ممارسات إستبدادية أو غير أخلاقية قد تضر بفئة معينة. وعندما يصبح التكوين الثقافى و القناعات الأيدولوجية مرتبطة ارتباطا وثيقا مع الوضع الإجتماعى بالنسبة إلى الفرد، يصبح ميل الشخص إلى العنف والتمرد أكثر إحتمالا، وخاصا إذا شعر أن جهة معينة كان يتخذ منها موقف أيدولوجى مسبق، قد تضر بمصالحه الخاصة أو تؤثر على نمط حياته بشكل سلبى .
لا تقتصر المواقف الأيدولوجية والمفاهيم الثقافية على الأفراد و الجماعات، بل إن الدول و الحكومات تمارس عنفا ممنهجا تجاه فئات إجتماعية محددة، فوفقا لتصورها لما يجب أن يكون عليها الإنسان والمواطن الصالح، ترى أن بعض السلوكيات والأنماط الثقافية يشكل خطرا على الصالح العام، وهى تحاول أن تقصى و تزيل أى إنتماء أو ولاء يوازى فى وجوده الإنتماء للدولة والنظام، وهنا يكون مصطلح مثل الحفاظ على هوية الدولة، هو المبرر الرئيسى لإستخدام العنف، بل عادة يكون عنف الأفراد و الجماعات ليس سوى نتيجة لعنف الدولة، وتلعب أحيانا المصالح السياسية و الاقتصادية لجهة ما دورا فى هذا العنف الممنهج، وهى تدخل جموع الناس من خلال أدوات الدعاية فى صراعها الشخصى وتصنيف الأخر باعتباره خطرا عاما ، وفى النهاية يصبح القهر والتمييز له وسائله القانونية و تصبح جرائم السلطة عقابا عادلا. فى النهاية لا أحد بإمكانه تحديد المصلحة العامة ككيان موضوعى مستقل عن المصلحة الخاصة، كما لا أحد بإمكانه تمثيل المصالح المشتركة الخاصة للجميع، فبإختلاف التكوين الثقافى للفئات المختلفة والمصالح الاقتصادية المتضاربة، تكون فيها أليات الديمقراطية مثل الإقتراع و الإنتخابات وحرية العمل العام و تحقيق المساواة أمام القانون دون تمييز هو الضامن الوحيد لتحقيق التوازن الإجتماعى والإستقرار الحقيقي.
التعليقات
لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... ! تابعنا على الفيسبوك
مقالات شيقة ننصح بقراءتها !
مقالات مرتبطة بنفس القسم
متى نمتلك اليقين؟
كثيرٌ ممَّا كان من المسلَّمات سابقًا دُحض وصُنِّف على أنه خاطئٌ اليوم. فمركزية الأرض وتابعية الشمس والقمر كانت من المسلَّمات التي تؤمن بها كامل البشرية قديمًا، والتي كانت تُدرّس في المدارس، وتنشر في الكتب والمقالات، حتى أتى اكتشافٌ غيّر منها،
ضريبة التنازل والإحترام ... تؤدى إلى التجاهل وعدم الإهتمام
الصداقة من الصدق ،وتُعرف الصداقة بأنها رابطة المودة والإخلاص بين شخصين أو أكثر، كل منهم يشعر بحب كبير تجاه الآخر. وتتميز علاقة الصداقة بصفات شخصية إيجابية مثل اللطف والكرم والولاء والصدق. ويعد كل إنسان لديه صديق مخلص من أسعد البشر



الإرشاد الأسري: زبدة دراسة وجيزة.
أهداف الارشاد الأسري: • المحافظة على الصحة النفسية للأسرة وأفرادها. • احداث تغيرات ايجابية في المعتقدات والأفكار والسلوكات.• مساعدة الأسرة في حل المشكلات واتخاذ القرارات. • تحقيق الذات وتكوين مفهوم ايجابي عنها.• تمكين أفراد الاسرة من التواصل فعال وتحقيق التكيف الاجتماعي.متطلبات المرشد الأسري الناجح: • متطلبات








فهم هياكل السلطة المجتمعية
فهم هياكل السلطة المجتمعية*المقدمة•الهيكل التنظيمي:هو عبارة عن رسم يبين و يوضح المهام,و المسؤوليات لأجزاء السلطة,و كيفية اتصالها. و يتميز الهيكل التنظيمي بالرسمية و الفعالية و الاهتمام و التنسيق و التأثير و التخصص و الرقابة و المرونة و كذا الوضوح.و