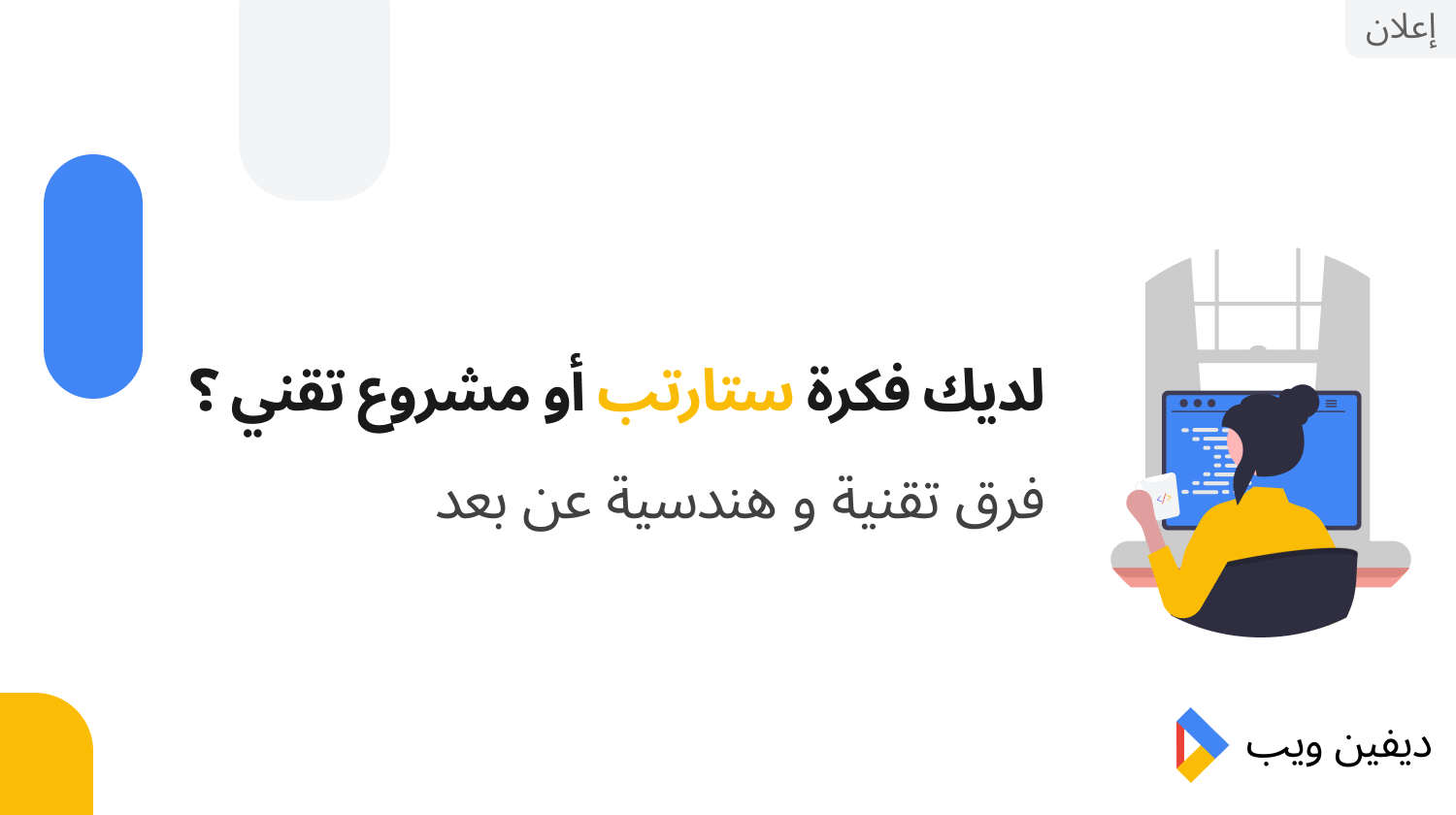كنت ذات مرة في مجلس دعوي نتناقش فيه مع بعض الفضلاء الإشكالات التي جدَّت على الساحة الدعوية، وما تواجهه من صعوبات تحتاج مع بعضها حلولاً جذرية حتى تخرج من تلك الأزمة، وتطرقنا على سبيل المثال إلى الأماكن الحاضنة للدعوة أياًّ كان صورتها، وأجمعنا على الإشكالات الحاصلة في المكان، وأنّها إحدى المعوقات في سير تلك الميادين الدعوية بطريقة صحيحة، ومع ذلك الإجماع وجدنا صعوبة في اتخاذ قرار الانتقال إلى مكان أبرح وأفضل من سابقه مع يقيننا بصحة ما ذهبنا إليه، بل أوردنا من المبررات النفسية والتربوية ما يدفعنا إلى التخلي عن تلك الفكرة والعودة إلى السائد في تلك الميادين، وهذه ظاهرة في الدعوة ينبغي التنبه لها والنظر فيها بكل تجرُّد وموضوعية، فتكرارها بين الفينة والأخرى في الأوساط الدعوية وبأشكال مختلفة وبتبريرات واهية يجعلنا نخاف من ضمان سيرها في المستقبل، فالجمود في بعض الوسائل الدعوية يؤخِّر الدعوة عقوداً من الزمان، فصفة المعاصرة للدعوة إنّما تنبع من تجدُّد الوسائل الدعوية المناسبة لكل مجتمع، فالذي صلح به الماضي -من الوسائل- قد يَحتاج إلى تعديل وتهذيب وأحياناً تغير ليصلح لمجتمع الحاضر، وهنا لن أناقش موضوع المعاصَرة وآلياتها، وإنَّما نضع أيدينا على الدوافع والأسباب الموصلة إلى عدم قبول الجديد من الوسائل، مع أنّها لا تعدو أن تكون وسيلة من الوسائل لا هدفاً ومبدأ، وسألخِّص الدوافع والأسباب في النقاط التالية:
1- السمات الشخصية: فالبعض تغلب على شخصيَّته الحذر والخوف من الجديد، وعلى ذلك ما إن يُطرح عليه موضوع التجديد الدعوي أو خوض تجربة جديدة سرعان ما يبدأ بذكر سيل من التحرُّزات والأسئلة التي ظاهرها التأكد من عدم اتخاذ القرار الخاطئ، ماذا لو؟ هل استوفينا كلّ الوسائل؟ قد تكون نتيجة فكرتنا خاطئة؟ وغيرها من الأسئلة التي لا إجابة لها إلا أنَّ التغيير غير مجدي، وهنا أقول أنَّ الخلل ليس في الأسئلة المطروحة، فهي أسئلة جوهريَّة ولابد أن تكون مستحضرة عند الإقدام على خطوة مصيرية كهذه، وإنَّما الإشكال حقيقة في السمات الشخصية التي يمتلكها بعض القادة لتلك الميادين الدعوية المنطوية على الخوف من التغيير بكل صُورِه، والحالة النفسية المنبعثة من شخصيته كالقلق من النتائج والخوف من العواقب، فمهما أَجَبْت على أسئلته، وأقنعته بصحَّة ما ذهبت إليه من خيار الانتقال، سيبقى الإشكال في عدم قدرته على اتخاذ هذا القرار المصيري؛ وذلك بسبب سماته الشخصية المنطوية على الحذر والتوجس والخوف من الجديد، والحقيقة أنّه لا يتحمَّل الخطأ بمفرده، بل يشاركه فيه من أعطاه أدوات الإدارة وهو يعلم أن من سماته الشخصية إدارة الأنظمة المستقرة، لا إدارة الأنظمة المتجددة.
ومن الحلول الممكنة لهؤلاء القادة أن يَعْزُوا هذا القرار إلى مجلس متنوع التفكير، مختلف الشخصيات ليتخذوا القرار بدلاً عنه، لا أن يبقى مصير الميدان الدعوي مرهون بقرار لن يُتَّخذ إلا بعد فوات الأوان، وإغلاق الأبواب الممكنة.
2- عدم الجاهزيَّة النفسية: ونعني بذلك إما أنَّ النفوس لم تتعود على التغيير أو لم تُحفَّز لممارسة التغيير، فحاصل الصورة الأولى أنّ النفوس تعودت على نمط من الرتابة في الدعوة نشأت عليه، وبدأت مسيرتها به، فهي تنظر لكل تغيير أنّه محفوف بالإشكالات والمخاطر، وأنَّ الاستقرار منجاة والسلامة لا يعدلها شيء، وهذا المنطق وإن صح ابتداء إلا أن التغيير الذي نطلبه ليس نافلة من القول، وطلب تجديد من أجل التجديد فقط، بل هو واقع لا مناص عنه، فإن لم نكن جاهزين للتغيير بما نريده نحن، وبما يصلح لنا، كان التغيير بما لا نريد ولا يصلح لنا، فجاهزيَّة النفوس للتغيير، وتتبع أدواته واستجلاب مآلاته الحسنة مطلب في زمن تتسارع فيه المعطيات بشكل مقلق.
وحاصل الصورة الثانية غياب التحفيز لخوض تجربة دعوية جديدة في ميدانٍ دعوي جديد، فلم يكن التحفيز ظاهراً في الميادين الدعوية للسماح بالمتميزين في خوض تجربة دعوية جديدة وفتح ميادين دعوية جديدة، والحرص على إنجاحها، وبقي الأمر على الالتفاف للنموذج الدعوي الناجح مسبقاً لفترة زمنية سابقة، وترك من يفكّر في إنجاح فكرة دعوية جديدة يصارع المشاقَّ لوحده، حتى أصبح من يفكّر في إيجاد نموذج دعوي جديد يظنُّ أنَّ من دون ذلك خرط القتاد، فقد رأى من هو أكثر منه خبرة وتميُّزاً يخوض بحراً عرمرماً لوحده، فمن الطبيعي أن يتولَّد في خلده أنَّ المحافظة على النماذج القديمة أسهل في العمل، وأكثر صفاء في البذل، ويمضي على هذه القناعة سنين طويلة تُصبِح بعد طول المكث مبدأ لا يمكن زعزعته، وهذا قد يعطينا مؤشِّراً واضحاً لفهم سؤالنا لماذا أصبح الواحد منّا يصل إلى حقيقة التغيير ثم يهاب اتخاذ قراره؟ فهو أمام تجارب ضخمة، وواقع لا يسمح للتغيير، ونفوس جُبلت على قناعات يصعب تغييرها.
3- غياب النماذج الدعوية الناجحة ولعل هذا الدافع من الشواهد على النقطة السابقة فقد عاش أهل الدعوة عشرات السنين وهم في قوة وتمكين وإقبال من الناس على الخير، ومع ذلك فحينما تنظر إلى النماذج الدعوية الموجودة في الساحة حينها تكاد تحصر أعدادها في أصابع اليدين إن لم تكن اليد الواحدة، ونجد أنفسنا عاجزين عن توظيف المخرجات من تلك الميادين الدعوية، فالمفعَّلة منها محدودة، ولكل واحد منها صفات محدَّدة ومقنَّنة للعاملين فيها، فيتسرب عدد من الطاقات المميزة من هذه الميادين لعدم وجود البيئة الدعوية المناسبة، فليس الكل يصلح لأن يكون معلم حلقات أو طالب علم أو داعية للناس، بينما كان باستطاعتنا أن نوجد أشكالاً مختلفة في الميادين الدعوية، والتجمُّعات الدينية، ما يَكفُل التنوع في الوسائل الدعوية، ويفسح الطريق للمبدعين في رسم أشكالٍ وقوالب دعوية مميزة نضمن معها الوصول المكثف لفئات المجتمع.
4- قلة الخبراء والاستشاريين الدعويين: فمع وفرة الطاقات القيادية التي تمتلئ بتراكم الخبرات ووفرة في الممارسات إلا أنَّها عندما تسلِّم دورها الدعوي لإدارة أخرى تغيب عن المشهد الدعوي، ويغيب معها هذا المخزون من الخبرات والممارسات، و لو تمَّ تفريغها للجانب الاستشاري وتوظيفها في قراءة المشهد الدعوي قراءة دقيقة، واستشراف مستقبلها المليء بالمعوقات والإشكالات، لأدْلَتْ بأفكار وممارسات من شأنها أن تصنع التغيير الإيجابي في الميادين الدعوية، وتقدِّم لها عصارة الخبرات والأفكار، ويكفيها أن تقدِّم لنا قياساً للأداء الدعوي وتقويماً للأعمال الدعوية بما يكشف لنا أوجه القوة والضعف في الإدارة والأداء.
5- استيطان الأفئدة: وهي حالة شعورية يتعلق القلب فيها بأماكن معينة، إما لطول مكثٍ فيها أو ارتباط المواقف والعواطف بها، فالبعض يحتجُّ بعدم الانتقال إلى مكان جديد بغياب الحالة الشعورية الإيمانية في المكان الجديد وعدم استيطان الأفئدة فيها، فحلقات القرآن إن لم تكن في المساجد فلن نجد تلك الحالة الشعورية الإيمانية البتة، وإن لم يكن الدعوة للشباب في جوٍّ مفعم بالحيوية والمخاطبة العاطفية لن تؤتي أُكُلَها، وحلقات العلم إن لم تكن حلقات متكتِّلة على مجالس العلماء فلا طعم لها، وهذا عند السعة مقبول، ولكن عند الأمور المصيرية فلا مجال للعواطف، فنحن أمام تحديات للبقاء، وترجيح بين المصالح والمفاسد لضمان استمرارية الخير، وليس الأمر على السعة، فالنبي ﷺ كان يحب مكة حباًّ شديداً وقد تعلّق قلبه بها، قال ﷺ (وَاَللَّهِ إنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إلَى اللَّهِ، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ) ومع ذلك لما كان الأمر متعلِّقاً بنصرة الدين فلا مجال للعواطف فقد انتقل للمدينة في أرض جديدة، ومكان جديد، وقوم جدد، لأنَّ المكان المقبل عليه تعهَّد أهله بالنصرة والتمكين له وللدين الذي جاء به، وهو المكان الأنفع للبيئة الدعوية، فاتخذ القرار وهاجر إلى المدينة، فكان هذا القرار المصيري عصراً جديداً في حياة الأمة الإسلامية.
ولعل هذه النقاط الخمس من أبرز ما يدفعنا إلى التوجس من التغيير أو رفضه، وهنا نحتاج فعلاً إلى ترتيب أولوياتنا وتوظيف طاقاتنا بالشكل الصحيح، ونوطِّن أنفسنا على التأقلم مع التغيير لا مقاومته، فنحن نتكلم عن وسائل وأساليب لا أهدافاً ومبادئ حتى نقاومها ونردَّها، ويبقى السؤال بعد ذلك للمتخصصين ماهو التغيير الإيجابي؟ وما هو التغيير المقبول من غيره؟ وما الذي يناسبنا من التغيير؟ وهل كل تغيير فعلناه هو فعلاً للوسائل أم أنه وصل إلى المبادئ والمقاصد؟ فهناك أسئلة مهمة لضبط بوصلة التغيير حتى لا تخرج عن السنن والطريقة الصحيحة، وإنَّما يكون ذلك بعد قبول المبدأ، ثم يأتي بعد ذلك تحديد كُنْهِه وصورته على المقصود الشرعي، والمطلب الرباني.
-
 علي عسيريمهتم بالبلاغة القرآنية
علي عسيريمهتم بالبلاغة القرآنية
التعليقات
لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... ! تابعنا على الفيسبوك
مقالات شيقة ننصح بقراءتها !
إحترم عزلة الإنسان ولا تسأل ..
إحترم عزلة الإنسان ولا تسأل ..لا تكن منه قريبا ولا بعيدا ولا تأمل .. كل مافي الامر يريد ان يرى نفسه بنفسه ويسأل ..ليبحث عن هويته الضائعة في كل زاويه من زوايا الحياة .. الانتظار مؤلم والانسحاب مؤلم ايضا....
الفرق بيننا و بينهم .. أطفال الطبيب
هذا الصباح قررتُ أن أصاحب طفلي إلى حصة التطعيم ، و حيث أن الدولة المغربية قد تكرمت على رعاياها بمجانية التطعيم ، قررتُ أن أصطحب ابني إلى المكان الذي طُعمتُ فيه أنا حينما كنتُ في مثل سنه ! الطريق....
مقالات مرتبطة بنفس القسم


ذكريات الطفولة، واضطرابات القلق
لطالما عانيت منذ الصغر من اضطراب القلق ونوبات الهلع ولكن لم يكن أحدًا من أهلى على دراية ووعي كافٍ لطلب المساعدة أو على الأقل التحدث معي بشأن الأمر. كبرت وظننت أن الإرتجاف هو الإحساس الطبيعي الذي يشعر به كل البشر، وأن


طريق العشرين
العشرين:العشرين رقم ينتهي فيه الكثير من الأشياء و أيضاً بداية جديدة لكثير من الأشياء ، هيّ مرحلة مقسومة بين الراحة والتعب ، لأنك فيها يبدأ عقلك ينشد تدريجياً من الطفولة و المراهقة إلى عالم النضج .في طريق العشرين..بدأتُ اجعل