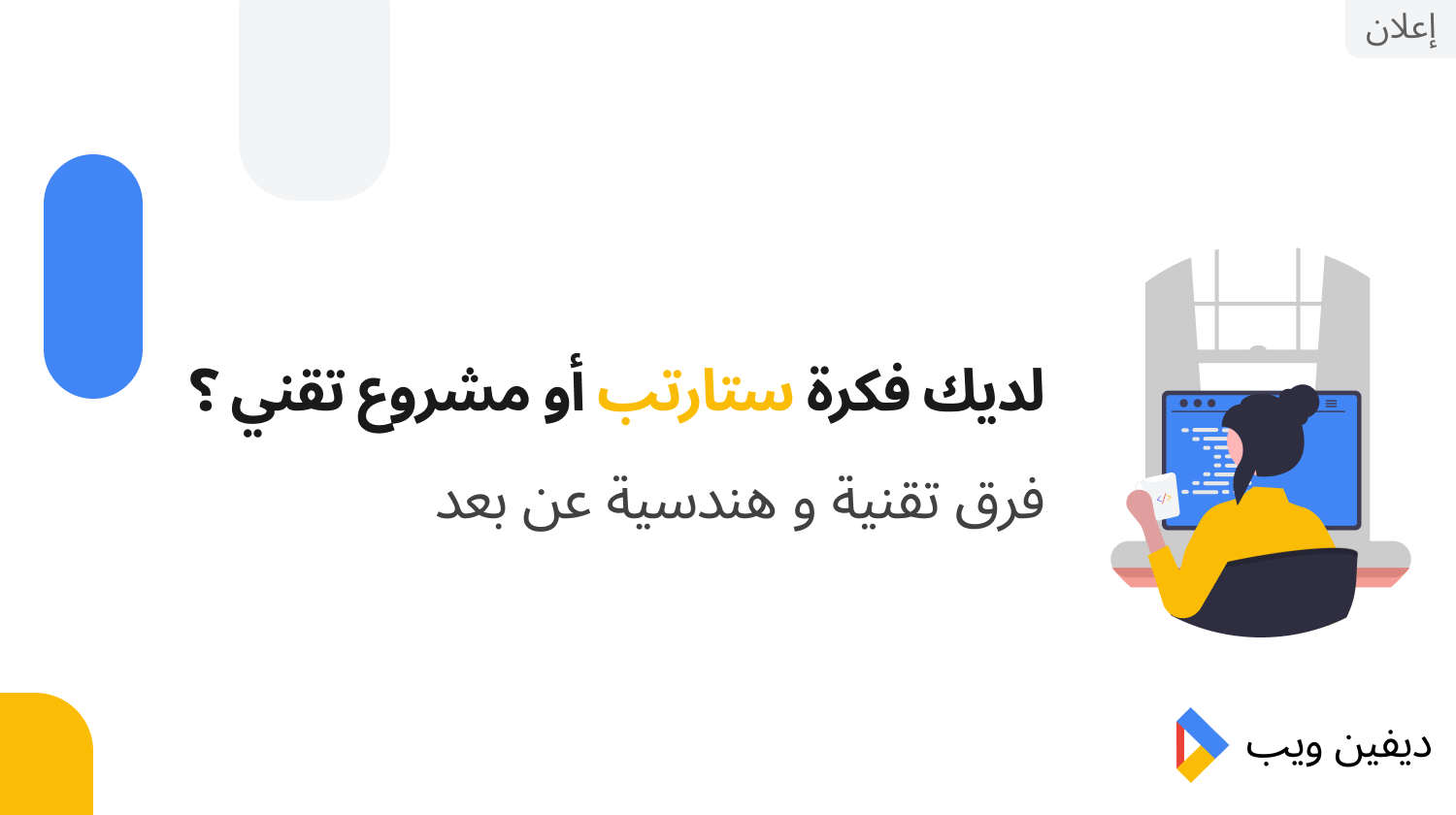حلفاء، ولكن..! أُصول النزعة الفرنسيَّة المُعادية للهيمنة الأمريكيَّة
نشر في 09 أكتوبر 2021 وآخر تعديل بتاريخ 08 ديسمبر 2022 .
لا يكاد يمر عقد أو بضع سنوات حتى تلوح في الأفق بوادر خلاف أو أزمة دبلوماسية، لتتصدر المشهد وتُلقي بظلالها على مجرى العلاقات القائمة بين حليفين، تعود جذور تحالفهما إلى عهد قديم؛ هما فرنسا والولايات المُتحدة الأمريكيَّة، تاركةً وراءها جملة من التساؤلات حول طبيعة هذه العلاقة، وإلى أي مدى يُمكن لحكومتي هذين البلدين الغربيين التظاهر بأنهما تُجدفان في سياستهما الخارجية في اتجاه واحد وليس في اتجاهين مُتعارضين؟ وما إذا كان مُمكنًا توصيف العلاقة بينهما، في ضوء هذه التوترات، بأنها الأكثر تقلبًا والأقل استقرارًا وانسجامًا في منظومة العلاقات المُتبادلة بين دول التحالف الغربي، الذي يجمع الولايات المُتحدة بأوروبا الغربية مُنذ الحرب العالميَّة الأخيرة؟
إن منشأ هذه الخلافات التي تتفجر بين الفينة والأخرى، وتتحول في بعض الأحيان إلى ما يُشبه الحرب الباردة في خطابات الساسة الأمريكيين والفرنسيين على حد سواء، لا يعود بالأساس إلى تقاطع المصالح أو تعارض وجهات النظر بين الجانبين حول قضايا النزاع بينهما، بقدر ما يتعلق من ناحيةٍ أخرى، وبدرجةٍ أكبر، بما يُمكن أن نُسميه "التصور الفرنسي" للاعتبارات أو المُحددات الحاكمة لعلاقة أوروبا بالولايات المُتحدةالأمريكيَّة.فالشخصية الفرنسيَّة تميل وتدعو الأوروبيين بدورها إلى تأكيد الاستقلالية، وتشعر بالانزعاج من فكرة قبول التبعية، أو التسليم بمبدأ الهيمنة الأمريكيَّة المُطلقة. واتساقًا مع ذلك، ترى باريس أن العلاقة بين واشنطن وأوروبا ينبغي لها أن تكون علاقة تشاركية تقوم على الندية والاحترام المُتبادل، كونها علاقة قائمة بين حليفين متساويين في السيادة دون الالتفات إلى اعتبارات القوة، وأن المصلحة الأمريكيَّة ليس بالضرورة أن تكون مصلحة للأوروبيين أيضًا، ومن هُنا يجدُر عدم الانسياق دائمًا خلف السياسة الخارجية للولايات المُتحدة، لأن ذلك من شأنه أن يُقلل فرص الأوروبيين في تبني سياسة مُستقلة، ويزيد من تورطهم في المتاعب الناجمة عن السياسات الأمريكيَّة في العالم. في مُقابل ذلك، تبنت الإدارات الأمريكيَّة، على اختلاف توجهاتها وانتماءاتها الحزبيَّة، في سياستها تجاه أوروبا تصورًا يتقاطع بصورةٍ واضحةٍ مع الرؤية الفرنسيَّة، فأضحت القارة العجوز، تبعًا لذلك، غارقًة في مُستنقع التبعية الأمريكيَّة حتى أخمص قدميها.
شكل الموقف الأمريكي الذي ينطوي على توجه مُناهض للاستعمار الأوروبي في العالم الثالث، بعد نهاية الحرب العالميَّة الثانية، ومُحاولة الولايات المتحدة فرض نوع من الوصاية على حلفائها الأوروبيين بداية الخلاف الفرنسي/ الأمريكي، وحمل في طياته بذور النزعة الفرنسيَّة المُعادية للتسلط والهيمنة الأمريكيَّة، إذ كانت واشطن ترمي إلى وضع حدٍ للوجود الفرنسي والبريطاني، لا سيَّما في منطقة الشرق الأوسط، تمهيدًا لإفساح المجال أمام التغلغل والتدخل الأمريكي، من أجل إحكام السيطرة عليها والحيلولة دون تسلل المد الشيوعي إليها، وبخاصةٍ بعد تزايد الأهمية الاستراتيجيَّة والاقتصاديَّة للمنطقة في ظل تنامي الاعتماد العالمي على النفط وتصاعد وتيرة الحرب الباردة. كانت فرنسا وغيرها من الدول الأوروبيَّة، في هذه الفترة، تُعاني من وقع الدمار والانهيار الاقتصادي الذي خلَّفته الحرب العالميَّة الثانية، ومن ثم زاد اعتمادها على المعونات والقروض الأمريكيَّة المُقدمة تحت مظلة "مشروع مارشال" كي تتعافى من كبوتها، ولهذا كان القرار السياسي لأوروبا الغربية برُمته مرهونًا بالموقف الأمريكي.
دفعت هذه الظروف الجديدة التي أفرزتها الحرب، الحكومة الفرنسيَّة، إلى تنسيق المواقف وقيادة الجهود الأوروبيَّة الرامية إلى انشاء تكتل أوروبي، هذا التكتل الذي تحول لاحقًا إلى الاتحاد الأوروبي، والذي أُريد له موازنة النفوذ الاقتصادي للولايات المُتحدة، خشية أن تغرق أوروبا أكثر في مأزق التبعية الاقتصاديَّة لواشنطن، وتتحول إلى مُجرد سوق أمريكيَّة.
تعافي فرنسا اقتصاديًا وانتزاعها لأحد المقاعد الخمس الدائمة في مجلس الأمن الدولي، الذي تفتق عن انشاء الأمم المُتحدة، خلق لدى حكومتها دافعًا آخر، تمحور في محاولة تعزيز قُدراتها العسكريَّة، والانتقال بها من مرحلة الانطباع السيء الذي تكون عنها إبان الحرب العالميَّة الثانية إلى مصاف القوى العُظمى مُجددًا، وكان يُمكن تحقيق ذلك، من منظور حكومة "شارل ديجول" التي وصلت إلى سُدة الحكم في عام ١٩٥٨م، من خلال حيازة باريس للقُنبلة النووية، ومن ثم انضمامها إلى نادي القوى النووي. إلا أن مساعي فرنسا في هذا المجال اصطدمت بتعنت الولايات المُتحدة، التي رفضت نقل تكنولوجيا السلاح النووي إلى باريس، بزعم حرصها على سياسة عدم الانتشار النووي، جاء ذلك في وقتٍ قدمت فيه واشنطن ما يلزم لحليفها البريطاني لمُساعدته على امتلاك القُنبلة النووية. وأمام هذا الرفض الأمريكي قررت باريس التعويل على قُدراتها الوطنية إذا ما أرادت اللحاق بالركب النووي، وهو ما تحقق في عام ١٩٦٠م، عندما نجحت في تفجير أولى قنابلها الذرية بالصحراء الجزائرية، في عملية سرية حملت اسم "اليربوع الأزرق".
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فلقد ازدادت الأمور تعقيدًا بين فرنسا والولايات المُتحدة الأمريكيَّة، عندما عرض الجنرال ديجول على واشنطن ضرورة وجود لجنة ثلاثية لحلف شمال الأطلسي، بقيادة كُل من الولايات المُتحدة، وبريطانيا العظمى، وفرنسا تتولى اتخاذ القرارات المُتعلقة بعملية الدفاع واستخدام القوة النوويَّة داخل الحلف، لكن الطلب الفرنسي قُوبل بالرفض، فقامت باريس على إثر ذلك بإعلان انسحابها من القيادة العسكريَّة للحلف الأطلسي عام ١٩٦٦م.
ويُمكن تفسير هذه الخطوة الفرنسيَّة بالقول: إن الجنرال ديجول أدرك أن بقاء القوات الفرنسيَّة تحت القيادة العسكريَّة للناتو التي تُهيمن عليها واشنطن، سيجعل من فرنسا مجرد دولة متوسطة القوة داخل المُعسكر الغربي، ولن يكون بمقدورها لعب دور مؤثر ما لم تحظ بالاستقلاليَّة، فكان قرار الانسحاب من القيادة العسكريَّة للناتو بمثابة ضمانة أخرى لتحقيق طموحات "ديجول" الخارجية.
وتوازيًا مع هذه الخطوة عمل شارل ديجول، في مسعاه لإعادة فرنسا الى واجهة القوى العُظمى من جديد، على تبني سياسة جديدة، ترمي في شقها الأول الى التحرر من القبضة الأمريكيَّة وفي شقها الثاني إلى تحقيق نوع من الموازنة بين نفوذ القطبين العُظميين من خلال فرض قوة ثالثة تُمثلها فرنسا «الخيار الديجولي»، فاعترف ديجول بحكومة الصين الشعبية التي رفضت الولايات المُتحدة الاعتراف بها حتى عام ١٩٧٠م، وفي عام ١٩٦٦ قام بزيارة الاتحاد السوفياتي لتعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، الأمر الذي اقلق واشنطن، خوفًا من أن تحذو بعض الدول الأوربيَّة سياسة فرنسا المُتمردة. وفيما يتعلق بملف الصراع العربي الاسرائيلي أعلن ديجول دعمه للقوى العربيَّة بعد الاعتداء الإسرائيلي عليها في يونيو/ حزيران ١٩٦٧م واصفًا تل أبيب بالطرف المُعتدي. وهذا التحول في النهج الفرنسي على صعيد السياسة الخارجية لم يكن ليكتمل بالصورة التي ظهر عليها لو بقيت فرنسا ضمن القيادة العسكريَّة الموحدة للناتو التي تنفرد واشنطن بتوجيه دفتها.
في أكتوبر/ تشرين الأول من العام ١٩٦٧م، وضعت فرنسا نظام "بريتون وودز" النقدي، الذي تأسس مع نهاية الحرب العالمية الثانيَّة وتحول بموجبه الدولار الأمريكي إلى غطاء للعملات الأجنبية بدلاً من الذهب، أمام اختبار ومحك حقيقي، كونها الدولة الأولى التي طلبت من حكومة الولايات المُتحدة الالتزام بتعهداتها، بموجب هذا النظام واعطائها ذهبًا في مُقابل فائض الدولار الذي لديها. وبهذه الخطوة فتحت فرنسا الباب أمام بقية الدول الأخرى كي تحذو حذوها، وهو ما سبب تناقصًا كبيرًا في مخزون الذهب الأمريكي، الأمر الذي عجل بالرئيس الأمريكي "ريتشارد نيكسون" إلى الإعلان عن وقف العمل تبعًا لاتفاقيات بريتون وودز، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة لم تعد مُلزمةً بعد اليوم بتوفير الذهب في مُقابل ما تكتنزه الدول من الدولار.
أزمة سياسيَّة أخرى أبانت عن وجود اختلاف في الرؤى، وليس خلافًا سياسيًا، بين القيادتين الفرنسيَّة والأمريكيَّة، والحديث هنا عن أزمة الخليج الثانية، أو ما يُعرف بالغزو العراقي للكويت في مطلع تسعينيَّات القرن الفائت. فلقد كانت فرنسا إحدى دول التحالف الدولي الذي دعت واشنطن إلى تشكيله لمواجهة التهديد العراقي، لكن باريس جاءت إلى الشرق الأوسط في خضم هذه الأزمة تحمل معها رؤية مختلفة عن التصور الأمريكي بشأن الهدف العسكري لهذا التحالف، ففي حين كان الأمريكيون، ويُشاركهم في ذلك حلفائهم من البريطانيين، يرون ضرورة تدمير القوات العراقيَّة بعد انسحابها من الكويت، كانت فرنسا، من جانبها، ترى بأن الهدف العسكري لا ينبغي أن يتجاوز، بأي حال من الأحوال، تحرير الأراضي الكويتية من القوات العراقيَّة وتأمين حدود المملكة العربيَّة السعودية من أي اعتداء عراقي قد تتعرض له، دون القيام بأي مُحاولة تستهدف تدمير القوات العراقيَّة، أو توجيه ضربات جوية ضد أهداف عسكريَّة داخل العراق.
ولعل هذا الموقف الفرنسي كان نابعًا من قناعة الحكومة الفرنسيَّة بأن الولايات المُتحدة ورطت النظام العراقي في هذه الأزمه من أجل اسقاطه، كونه يُمثل في تصورها تهديدًا لأسواق النفط وأمن حلفائها في المنطقة، وفي مقدمتهم إسرائيل. ومن ثم كان صدام حسين في نظر باريس ضحية مؤامرة أمريكية. وتفاديًا لانخراط القوات الفرنسيَّة في أي عمل عسكري ضد العراق، ارتأت الحكومة الفرنسيَّة ألا يتحرك أحد جنودها خطوةً واحدةً دون الحصول على موافقةٍ مُسبقةٍ منها. ولضمان استقلالية الموقف الفرنسي في هذه الأزمة، قرر وزير الدفاع الفرنسي نشر قواته بعيدًا عن منطقة تموضع القوات الأمريكيَّة داخل الأراضي السعودية، كما فضلت باريس انضواء قواتها تحت قيادة الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، قائد القوات المُشتركة ومسرح العمليات، عوضًا عن انضوائها تحت لواء القيادة الأمريكيَّة برئاسة الجنرال شوارتزكوف.
استمر الموقف الفرنسي، المُناهض للقيام بعمل عسكري ضد العراق يستهدف تغيير نظامه السياسي بالقوة، قائمًا خلال أزمة الخليج الثالثة في عام ٢٠٠٣م، حيث هددت باريس باللجوء إلى استخدام "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، ردًا على المساعي الأمريكيَّة الرامية إلى استصدار قرار من المجلس يُجيز لواشنطن استخدام القوة ضد العراق تحت مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المُتحدة. وقد خلف هذا الموقف الفرنسي ردود أفعال عنيفة وغاضبة من الجانب الأمريكي، وبدا أن بوادر أزمة حقيقية بين البلدين تلوح في الأفق، يُمكن أن تصل بالجانبين إلى حد القطيعة السياسيَّة!
مع وصول الرئيس "نيكولا ساركوزي" إلى قصر الإليزية في عام ٢٠٠٧م، شهدت العلاقات الفرنسيَّة الأمريكيَّة انفراجةً وتحسنًا ملحوظاً، راوحت على إثره العلاقات الثنائيَّة بين البلدين مرحلة التقلب والفتور إلى مرحلة أكثر استقرارًا ودفئًا، توجت بعودة باريس مُجددًا إلى القيادة العسكريَّة لحلف الناتو عام ٢٠٠٩م، بعد انقطاع دام لاثنتين وأربعين سنةً. إلا أن مؤشر العلاقة بين الحكومتين انخفض بحلول عام ٢٠١٨م إلى مستوى أكثر برودة، عندما دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأوروبيين إلى التفكير بجديدة في مشروع انشاء جيش أوروبي موحد، لتعزيز أمن القارة الأوروبيَّة ضد مصادر الخطر التي تتهددها وعلى رأسها الولايات المُتحدة نفسها، وبما يساعد الأوروبيين على توفير الحماية لأنفسهم بعيدًا عن مظلة الحماية الأمريكيَّة. جاءت هذه الدعوة الفرنسيَّة في سياق انسحاب واشنطن من اتفافية عسكريَّة للحد من الأسلحة الاستراتيجيَّة، كانت قد أبرمتها مع الاتحاد السوفياتي (سابقًا) في ثمانينيَّات القرن العشرين، وهو ما اعتبرته باريس محاولةً أمريكيَّةً لوضع أوروبا في مرمى التهديد الروسي.
وقد قُوبل هذا المُقترح الفرنسي باستياء شديد من جانب البيت الأبيض، الذي دعا فرنسا ودولاً أوروبيَّةً أخرى داخل حلف الناتو، على لسان الرئيس دونالد ترامب، إلى الالتزام أولاً بتعهداتها حول زيادة نفقاتها الدفاعية في ميزانية الحلف إلى النسبة المُتفق عليها وهي (٢٪) من إجمالي الناتج المحلي لكل عضو، عوضًا عن التفكير في بناء جيش أوروبي لا قيمة له.
وأخيرًا، يُمكن القول إن الخطوة الأمريكيَّة الأخيرة التي تمثلت في اقصاء باريس وعدم دعوتها للانضمام إلى التحالف الثلاثي "أوكوس" في منطقة المُحيطين الهندي والهادئ، لاحتواء النفوذ الصيني ومُحاصرته، ليست بالخطوة المُفاجئة، وأن هُناك ما يُبررها. إذ تدرك الإدارة الأمريكيَّة جيدًا أن فرنسا، وعلى النقيض تمامًا من بريطانيا، لا تنتوي الانخراط في أي تحالفات أمنية وعسكريَّة موجهة ضد الصين، كون هذه الأخيرة لا تُشكل تهديدًا أو خطرًا حقيقيًا على أمن الاتحاد الأوروبي ومصالحه من منظور الحكومة الفرنسيَّة. بالإضافة إلى ذلك، ترى باريس أن تنامي النفوذ الاقتصادي للصين يُمكن التكيف معه، بل والاستفادة منه، عبر تفعيل الشراكة الاستراتيجيَّة في مجال التجارة الخارجية بين بكين والاتحاد الأوروبي، وأن هذه الشراكة يُمكن توظيفها أيضًا كورقة ضغط ضد الأمريكيين.
صحيح أن هامش الحركة والمُناورة يبدو ضيقًا ومحدودًا أمام الفرنسيين، لكن ينبغي على الحكومة الأمريكيَّة الأخذ بعين الاعتبار ضرورة احتواء النزعة الفرنسيَّة المُعادية لها والعمل على منع تصاعدها، والالتفات إلى حقيقة أن سجل الوقائع التاريخية لفرنسا في هذا المضمار يُعضد الفرضية القائلة بأن السُلوك الفرنسي فيما يتعلق بمساعي باريس الرامية إلى تأكيد استقلال القرار الأوروبي وتقليل اعتماد الأوروبيين على البيت الأبيض، هو سلوك يتسم بالجدية ولا يمكن التنبؤ بمساره، خاصةً بعد انسحاب المملكة المُتحدة من الاتحاد الأوروبي، واضطلاع فرنسا بدور قيادي فيه.
التعليقات
لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... ! تابعنا على الفيسبوك
مقالات شيقة ننصح بقراءتها !
مقالات مرتبطة بنفس القسم



من المستفيد من النّزاع القائم بين المغرب والجزائر؟
رشيد مصباح(فوزي)كاتب جزائرئإذا أردت معرفة المجرم الحقيقى فابحث عن المستفيد من الجريمة.يبدو أن هذه المقولة هي المعيار الحقيقي لمعرفة من المستفيد من النّزاع القائم بين بلدين مثل المغرب والجزائر.إنهاء الاحتلال الصّليبي ثمنه لم يكن مجرّد أرواح تم تقديمها على الأكف

انتهى عصرُ المُعجزاتِ وأقبلَ عصرُ السعيِّ والعملِ
انتهى عصرُ المُعجزاتِ وأقبلَ عصرُ السعيِّ والعملِنعم، لقد انتهى عصرُ المُعجزاتِ وأقبلَ عصرُ السعيِّ والعملِ ولنحصُدَ نِتاجَ أيّ عملٍ في هذا العصرِ لابدَّ من وجودِ سعيٍّ وعملٍ يَسبقُ حصدَ النتاجِ، ومن ادعى عدمَ حصدِ النتاجِ بعدَ سعيٍّ وعملٍ طويلٍ فلابدَّ



إيران والقضية الفلسطينية: ما بين الأيديولوجيا والمصلحة الوطنية
Name: Aisha Salah MohammedSupervisor: Dr. Muhammad Fawzi AliFaculty of Arts ASUبسم الله الرحمن الرحيم المقدمةما بين ثوابت الثورة الأيديولوجية والمصلحة الوطنية الإيرانيتين، تقوم هذه الدراسة على فرضيتين أساسيتين: الأولى أن الدعم الإيراني للقضية الفلسطينية يأتي بما يتفق مع مصالحها القومية، وحينحرب روسيا على أوكرانيا إلى متى ومن الخاسر الأكبر؟
حرب روسيا على أوكرانيا إلى متى ومن الخاسر الأكبر؟ يبدو أن لا الروس ولا الغرب يريدون لهذه الحرب أن تنتهي، ولكل طرف أهدافه ومسوغاته لإبقاء هذه الحرب دائرة، فقد صرح وزير الخارجية الروسي بأن روسيا لم تضع سقفاً زمنياُ