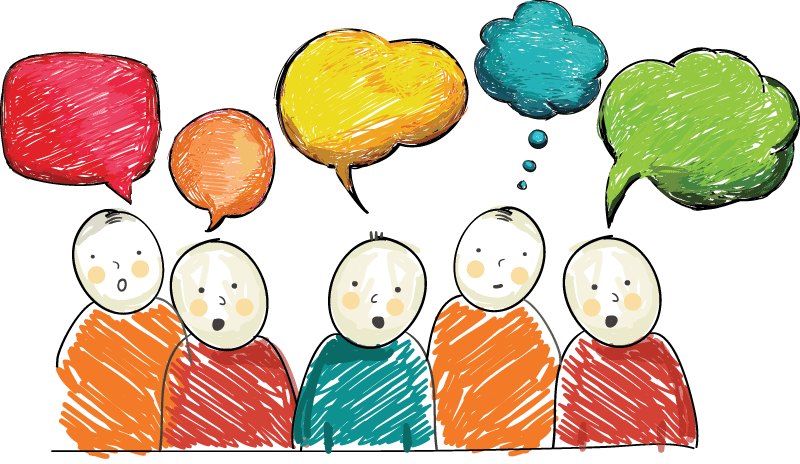من ضمن عشرات الحكم والأقوال المأثورة، التي زينت فصولنا الدراسية، وأثارت دهشتنا الطفولية لحسن سبكها وجودة صياغتها، تلك التي تعد السكوت من ذهب والصمت حكمة.
ورغم أنها لم تَحُد من ثرثرتنا وفضولنا المبكر، إلا أنها ظلت ترِنّ في المسامع بين الفينة و الأخرى، لتمتدح الكف عن إطلاق اللسان فيما لا يعني صاحبه، وتزكي ثقافة الصمت انطلاقا من نصوص شرعية، وأخبار ووقائع أودى فيها اللسان بأقوام إلى الهلاك، حتى في عالم الحيوان. ومما اشتهر في الموروث الزجلي المغربي، قول عبد الرحمن المجذوب :
الصــمـت حكمــة ومنه تتفـرق الحكـايم
لوما نطق ولد اليمامة ما يجيه ولد الحنش هايم.
لكنه صمت ذو حدين، وفضيلة تنقلب إلى مأساة حين يتعطل واجب الأمر بالمعروف، والتناصح، وتغيير المنكر باللسان؛ فليس من الصمت في شيء أن يسكت المسلم عن الحق، ويكتم الشهادة، ويعجز في حضرة الباطل أن يصرخ : اتق الله !
حدد القرآن الكريم ثلاث دوائر يُحمَدُ الصمت خارجها. يقول تعالى: ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾ - النساء.114- وهنا يحصر منطوق الآية وظيفة اللسان في حركة المسلم داخل المجتمع إيجابا لا سلبا، حيث يصبح "الكلام" ضرورة لتحقيق المعروف والإصلاح والإحسان إلى الغير.
نفس المنحى اعتمده الحديث النبوي بالتأكيد على مراعاة ما وُصف ب"آداب اللسان"، والتنبيه إلى مخاطر "كثرة" الكلام فيما لا يحقق فائدة للفرد والجماعة، أو يعود بالضرر عليهما. ولو تتبعنا هذه الآداب لتبين أن للصمت وظيفة وقائية، تحصن المسلم من مغبة إلحاق الضرر بشبكة العلاقات الإنسانية، وبالتماسك الحيوي الذي ألمح إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن البنيان المرصوص.
إلا أن تلك الوقائية محددة ومقيدة، ولا ينبغي اعتبارها سمة لازمة للمسلم، تدفعه لأن ينكفئ على نفسه، فلا يبالي بما حوله ومَن حوله. وللأسف فإن حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه تم توجيهه خدمة لرهبنة لا تليق بمجتمع التناصح والتآزر!
في الحديث الذي أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما أن عقبة بن عامر قال: "قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال : أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك". ويرد الحديث بصيغة أخرى، على لسان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا:" طوبى لمن ملك لسانه، ووسعه بيته، وبكى على خطيئته"[أخرجه الطبراني في الصغير.78/1] وليس المقصود بطبيعة الحال أن ينشأ المسلمون في مجتمع أخرس ومنكفئ على نفسه، لا ينشغل المرء فيه سوى بخلاصه الفردي، لأن في ذلك تعطيلا للرسالة المحمدية، وللوظيفة الدعوية التي تنهض عليها خيرية الأمة؛ وإنما يُراد ل"اللسان" المسلم أن تكون له أدوار بناءة، وجهد في توحيد الصف، ولم الشتات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
نصت أحاديث آداب اللسان على جملة من الآفات التي تنزع الخيرية عن القول، وتحيد به عن مهام البناء الاجتماعي و تخليق منظومة التواصل. ففي كتاب "الصمت وآداب اللسان" للحافظ ابن أبي الدنيا [ت281هـ] يظهر ترجيح الصمت على "فضول" الكلام. ثم يعرض المؤلف لتجليات هذا الفضول من خلال جرد الأحاديث التي تذم المراء، والتقعر في الكلام، والخصومات، والغيبة، والنميمة، والفحش، والمزاح وغيرها.
وحتى فيما أُثرَ عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوال وأخبار، نجد السعي إلى تقييد حركة اللسان، والتأكيد على خطورة وظائفه، دون أن يعني ذلك تزكية الصمت المطلق. اطلع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما على أبي بكر رضي الله عنه وهو يمد لسانه فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ فقال: إن هذا أوردني الموارد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسانَ على حِدّته. وهذا التنبيه إلى مسؤولية اللسان ودوره في تقرير مصير صاحبه أسهم، ولاشك، في رسم الحدود الدقيقة بين الكلام" النافع" واللغو الذي لا دواء له إلا الصمت المشفوع بالسلوك الطيب، والذي لا يخلو من جهد تعبدي، كما أوضح ذلك الحديث المرسل عن صفوان بن سُليم: ألا أخبركم بأيسر العبادة، وأهونها على البدن؟ الصمت وحُسن الخُلق.
لم يكن الصمت إذن في مجتمع النبوة والخلافة بديلا عن الصدع بالحق، ونقد الأوضاع المنحرفة و السلوك مشين، وإنما كان علاجا للنفوس التي تمُد ألسنتها لتقتحم المجال الخاص للآخرين، فتثير دواعي الخصومة والبغضاء. لذا صار من مقتضيات إسلام المرء أن يترك ما لا يعنيه، وأن يسلَم الناس من لسانه ويده. غير أن الانقلاب الذي أحدثه معاوية بن أبي سفيان بعد توليه الحكم، لم يَمس النظام السياسي للأمة فحسب، بل امتد أثره إلى منظومة القيم، وأسهم في انكماش المساحة المخصصة لحرية الرأي والتعبير كما ألفها المسلمون زمن النبوة والخلافة الراشدة.
أمام وضع مستجد، يتسم بالرفض الصريح لتغيير هوية نظام الحكم، كان على خلفاء بني أمية تأسيس قيم جديدة، تُفكك منظومة الحقوق والحريات السابقة لفرض الأمر الواقع. وسرعان ما وجد الأمويون مطلبهم في الموروث الفارسي، حيث تم الشروع في نقله إلى الثقافة العربية زمن هشام بن عبد الملك، وبادرت النخبة الموالية لنظام الحكم إلى إنتاج نصوص مُشبعة بالقيم والآداب الكسروية، ومنها بالطبع آداب اللسان.
أصبح الصمت في حضرة بني أمية رديفا للهدوء والطاعة والاستسلام، وكشفت مجالس الخلفاء عن سعي واضح للقطع مع حركة اللسان التي تنتقد وتعارض، أو حتى التي تُبدي حنينا للنهج السالف. يُحكى أن الأحنف حضر مجلسا لمعاوية، فتكلم الحاضرون بينما الأحنف ساكت، فقال معاوية: مالك لا تتكلم يا أبا بحر؟ قال: أخافك إن صدقت، وأخاف الله إن كذبت. وهكذا صار أدب اللسان مجالا للتوظيف السياسي لصالح هذا الحاكم أو ذاك !
كان من المتوقع إذن أن يهيمن الصمت وحفظ اللسان، كتَجَلٍّ مؤلم للتطبيع والاستسلام، على الثقافة العامة. وتبرز نخبة من الُكتاب والأدباء التي تحصر حركة اللسان داخل دائرتي الصمت واللغو المباح. فترددت في القصائد ونصوص النثر مدائح الصمت، والشذرات التي تزكي غيبوبة المسلم عن واقعه، وتُحذره من مغبة النطق الذي يُعادل البلاء. يقول أبو عبيد الله كاتب الخليفة المهدي : كن على التماس الحظ بالسكوت أحرص منك على التماس الحظ بالكلام؛ إن البلاء مُوَكّل بالمنطق. أما وُهيب بن الورد فيُقسّم الحكمة إلى عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت، والعاشرة في عزلة الناس !
تغلغل الصمت " الكسروي" في وجدان المسلم ليجد اللسان ضالّته في الآفات المنهي عنها شرعا. بل صار البعض منها من مكونات حرية التعبير التي تهز منظومة القيم، و يغذيها الإعلام بالصورة والنشر على نطاق أوسع. ورغم أن الأنبياء بُعثوا بالكلام ولم يُبعثوا بالسكوت، كما قيل، إلا أن مديح الصمت، والثناء المبالغ فيه لتجليات الهمود الإنساني لازال يتردد في ثنايا الخطاب الوعظي والمنجز الأدبي، كأن الإنسان وُلد ليصمُت !
-
 حميد بن خيبشكاتب شغوف
حميد بن خيبشكاتب شغوف
التعليقات
لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... ! تابعنا على الفيسبوك
مقالات شيقة ننصح بقراءتها !
عندما تكون الخسارة مكسبا
قصة الحمامة .... عندما تكون الخسارة مكسبٵ لا أدري ان كانت هذه القصة من تدابير القدر أم هي مجرد صدفة وهل كانت تجربة أم درسا ووقته كان الأنسب. كل ما أستطيع قوله عنها أني ما بت الا وتعلمت درسا....
مقالات مرتبطة بنفس القسم

Logiciel de facturation au Maroc
La gestion de la facturation est une tâche importante pour toute entreprise, de différentes tailles. Avec l’évolution numérique, un logiciel de facturation est devenus un outil indispensable pour automatiser et simplifier les processus metiers d'une entreprise. dans le marché





من المستفيد من النّزاع القائم بين المغرب والجزائر؟
رشيد مصباح(فوزي)كاتب جزائرئإذا أردت معرفة المجرم الحقيقى فابحث عن المستفيد من الجريمة.يبدو أن هذه المقولة هي المعيار الحقيقي لمعرفة من المستفيد من النّزاع القائم بين بلدين مثل المغرب والجزائر.إنهاء الاحتلال الصّليبي ثمنه لم يكن مجرّد أرواح تم تقديمها على الأكف