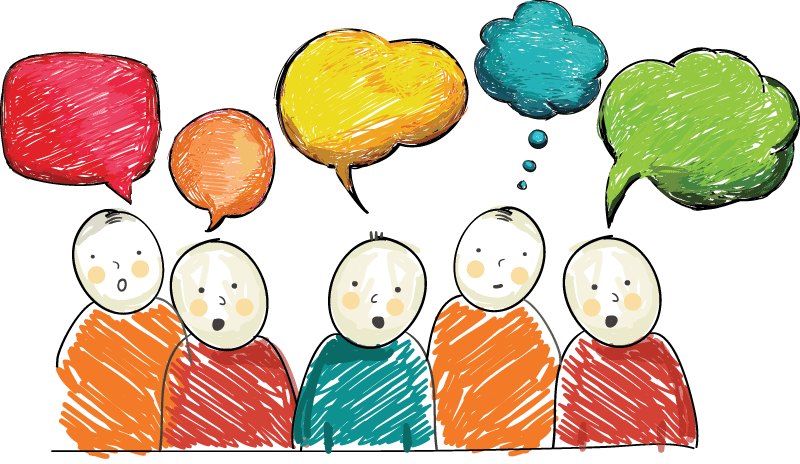(1)
يعشق الناس في بلادي الإجازات والعطلات الرسمية – بل وغير الرسمية – ينتظرونها بفارغ الصبر ويَعُدُّون الأيام يومًا يومًا قبل بلوغها، مثلهم مثل الطفل الذي ينتظر هديةً مِن أبيه نظير نجاحه في المدرسة .. يذهب الناس في بلادي إلى أعمالهم مطلع كل يومِ أحدٍ – أو كل يومِ سَبْتٍ إن كانوا من القليلين أصحاب الحظ العاثر ممن يذهبون مثلي إلى أعمالهم أيام السُبُوت – تكسو وجوهَهم كآبةٌ وتعلو جباهَهم تكشيرةٌ لا ينفكان إلا باقتراب يوم الخميس الذي يَعُدُّون العُدَّة له قبلها بيومين على الأقل وربما من الخميس الذي قبله.
يتكرر الأمر ذاته مع الإجازات الرسمية والعيدين، فترى الناس بمجرد انتهاء إجازة عيد الفطر يبدأون في حساب الحسابات لعيد الأضحى، يُقَلِّبُون في رُزْناماتهم لمعرفة ميعاد يوم وقفة عرفة، فيفرحون إذا ما صادف ميعاده يوم الأحد مثلاً لأنهم سيتمكنون في هذه الحالة من ضم يومٍ أو يومين إضافيين إلى إجازة العيد فتمتد بذلك إلى تسعة أيامٍ كاملةٍ، بينما يحزنون إذا ما صادف ميعاده يوم الثلاثاء أو الأربعاء مثلاً لأنهم لن يتمكنوا بذلك من إطالة عُمْر إجازتهم.
(2)
قبل العيد بأسبوعٍ تبدأ الشوارع بالازدحام بالبائعين والمُتَبَضِّعين، وتمتلئ الشواطىء بالمُصْطَافين، وتكتظ الحدائق وأماكن الخروج بالزائرين، وتضيق الطرقات بالأطفال اللاهين، وتبلغ هذه المظاهر ذروتها القصوى خلال أيام العيد للدرجة التي تُشْعِرُكَ بأن الناس جميعًا قد خرجوا من بيوتهم عن بكرة أبيهم ولم يتبقَّ أحدٌ في بيته، وهذا ما يجعلني أُفَضِّلُ دائمًا وأبدًا أن أقضي أيام الإجازة في بيتي عكس الغالبية من الناس، لا أبرح بيتي إلا لصلاة العيد ثم زيارة والديَّ وأهل زوجتي في اليوم الأول، بعدها أعود مهرولاً إلى قواعدي في بيتي كي أتمددُ مسترخيًا على الأريكة في خمولٍ لذيذٍ واستمتاعٍ، أُمْسِكُ بريموت التلفاز – إن سَمَحَتْ لي ابنتي الصغيرة بذلك طبعًا - أُقَلِّبُ بين قنواته لمشاهدة فيلمٍ أو مسرحيةٍ قديمةٍ كنت أحبها في طفولتي بينما أحتسي مشروبًا ساخنًا أو أقرأ كتابًا لا أتمكن من قراءته في أيام العمل إلا في السيارة التي تُقِلني من البيت إلى العمل ذهابًا وعودةً.
(3)
تُلِحُّ زوجتي في طلبها كل عيدٍ بأن نخرج لقضاء أيامه في أحد المصايف أو على الأقل نخرج إلى أي مكانٍ داخل حدود مدينتنا العجوز .. أرفض في إصرارٍ فتُسَلِّطَ زوجتي عليَّ ابنتنا الصغيرة كي "تَزِنَّ" في أذني كذبابةٍ لَحُوحٍ لعل قلبي يَرِقُّ لها أو أَمَلُّ من إلحاحها وأقبلُ، إلا أنني أتمسك برأيي وأُصِرُّ على عدم الخروج إلا بعد انتهاء الإجازة .. وبالرغم من إدراكي لعواقب هذا الرفض من "بوزٍ" ممتدٍ وحاجبين على شكل رقم 8، إلا أن ذلك أهون عندي كثيرًا من خروجي إلى الشارع في أيام العيد.
منذ سنواتٍ ليست ببعيدةٍ خَرَجْتُ في أحد الأعياد مع بعض أصدقائي للنزهة، فهالني أعداد البشر المنتشرين في الشوارع، أينما ذَهَبْتُ وجدتُ الازدحامَ والضوضاءَ والعَرَقَ هم أسياد الموقف، وأنا مِن النوع الذي يشعر بأنَّ هناك مَن يُجثم على أنفاسه إذا ما تواجدتُ في مكانٍ مزدحمٍ، لهذا السبب أكره الذهاب إلى أماكن مثل العتبة وشارع الأزهر ومباريات كرة القدم والمولات التجارية والأفراح.
أفزعني كذلك في ذلك اليوم سلوكات الناس في الشوارع والمتنزهات، فقدْ كانوا يُلقون بمخلفات طعامهم وشرابهم في كل مكانٍ فتتحول الشوارع في نهاية اليوم إلى مقلب قمامةٍ كبيرٍ .. وكانت هناك بعض التصرفات غير الأخلاقية بين بعض الشباب والفتيات الذين يتظاهرون بالحُبِّ .. ناهيك عمَّا يحدث أمام قاعات السينما التي تَعْرِضُ أفلام العيد التجارية، وهي أفلامٌ غير هادفةٍ لشيءٍ في الغالب سوى جذب المراهقين لصرف عيدياتهم في شراء تذكرة الفيلم .. وكذلك كان هناك الكثير من المضايقات الصبيانية والتحرشات التي يقوم بها بعض المراهقين اللزجين العابثين بلا خجلٍ تجاه أي فتاةٍ تقابلهم دون أن يجدوا مَن يردعهم أو ينهرهم عما يفعلونه، والأعجب عندما كنتُ أرى بعض الفتيات يتجاوبن مع هؤلاء ولا يُظهرن أي تأففٍ أو اعتراضٍ، بل على العكس كُنَّ يبتسمن ويضحكن ضحكاتٍ عابثةٍ ماجنةٍ دلالةٌ على رضاهن!.
كان لِمَا رأيتُه في ذلك اليوم مِن مظاهرَ سيئةٍ وسُلُوكاتٍ مُفزِعةٍ أثرًا وانطباعًا سيئًا على نَفْسِي لم ولن يمحوه الزمان، مما جعلني أتخذُ قرارًا لا رجعة فيه بأنَّ أفضل ما يمكن أنْ يفعله المرء خلال إجازة العيد هو الاستمتاع بتمضية الوقت مع الأسرة داخل جدران البيت على أريكةٍ أمام التلفاز في غرفة المعيشة، وأنَّ "بُوزَ" زوجتي و"زنَّ" ابنتي أهون ألف مرةٍ من المجازفة بالخروج إلى الشارع في أوقات الأعياد ولو أعطوني مقابل ذلك مليونًا من الجنيهات.
(4)
لم تَعُدِ الأعياد مصدرًا لإدخال السعادة إلى قلوبنا – نحن "الكبار" – كما كانت في طفولتنا .. كنا في أيام البراءة الأولى ننتظر العيد في شوقٍ ولهفةٍ بالغَين، نحلم بيوم العيد الذي سنرتدي فيه ملابسنا الجديدة، نرسم خططًا لما سوف نشتريه من ألعابٍ وحلوى بعد أن نحصل على "العيدية" مِن آبائنا ومِن كل الكبار الذين سيأتون لزيارتنا أو سنقوم بزيارتهم.
اليوم أصبحنا نحن "الكبارَ" .. لم نَعُدْ هؤلاء الأطفال الذين لا يحملون همًّا ولا تشغلهم أعباء الحياة ولا يشعرون بمسئولياتها .. اليوم صرنا نحن "الكبارَ" المُطَالَبين بتوفير الملابس الجديدة للأبناء ومنح العيديات للصغار وشراء اللحوم والأطعمة للبيت .. اليوم أصبحتْ متعتنا الوحيدة ومصدر سعادتنا في العيد هو رؤية الفرحة في عيون الصغار وهم يلعبون في براءةٍ وينفقون العيديات كأنهم ملوكًا دون حساباتٍ معقدةٍ لتوفير جزءٍ منها.
لقد أصبحتُ مُوقِنًا أن الأعياد لم تُخلَقُ للكبار مِن أمثالنا فقد أَخَذْنَا نصيبنا منها كاملاً في طفولتنا، وانتَقَلَتْ ملكيتها – بعدما كبرنا - لتكون حقًّا أصيلاً لكل طفلٍ، وليس لنا أي نصيبٍ منها الآن سوى الاسترخاء لبضعة أيامٍ ننسى فيهم – مؤقتًا – هموم العمل وضغوطه، والمساهمة في صنع مسببات السعادة لهؤلاء الصغار، وتهيئتهم لذلك اليوم القريب الذي سيحلمون فيه بالاسترخاء خلال العيد كي يتابعوا أطفالهم وهم يلهون في سعادةٍ فرحين بملابسهم الجديدة وعيديَّتهم التي سينفقونها على الألعاب والحلوى.
التعليقات
لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... ! تابعنا على الفيسبوك
مقالات شيقة ننصح بقراءتها !
مقالات مرتبطة بنفس القسم

Logiciel de facturation au Maroc
La gestion de la facturation est une tâche importante pour toute entreprise, de différentes tailles. Avec l’évolution numérique, un logiciel de facturation est devenus un outil indispensable pour automatiser et simplifier les processus metiers d'une entreprise. dans le marché





من المستفيد من النّزاع القائم بين المغرب والجزائر؟
رشيد مصباح(فوزي)كاتب جزائرئإذا أردت معرفة المجرم الحقيقى فابحث عن المستفيد من الجريمة.يبدو أن هذه المقولة هي المعيار الحقيقي لمعرفة من المستفيد من النّزاع القائم بين بلدين مثل المغرب والجزائر.إنهاء الاحتلال الصّليبي ثمنه لم يكن مجرّد أرواح تم تقديمها على الأكف