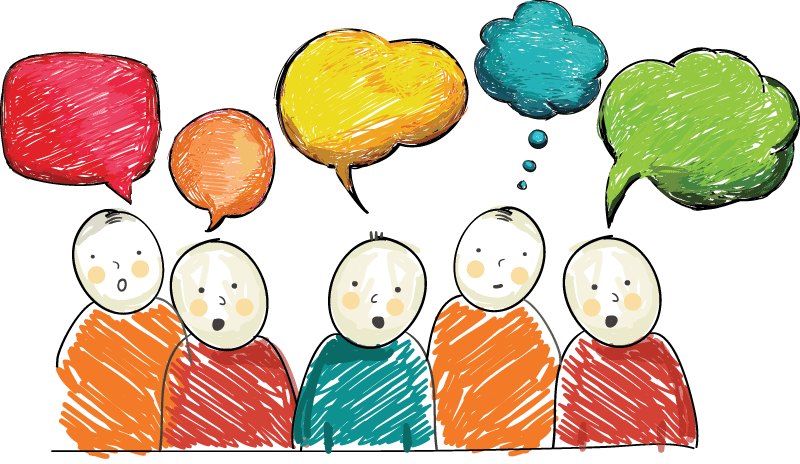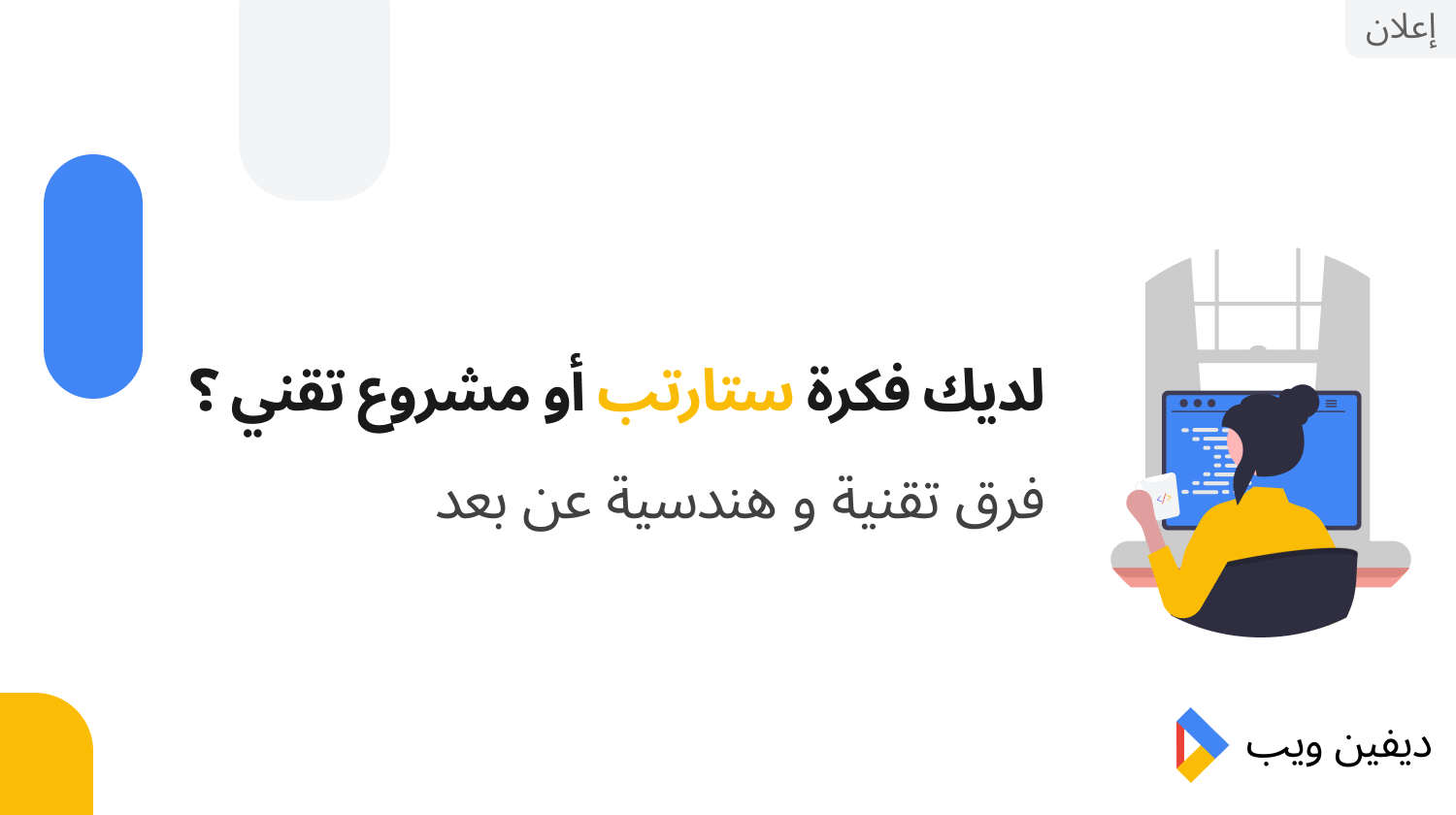سواء في مقهى على ناصية الشارع، أو في دردشة على السوشيال ميديا، تروج بعض المصطلحات دون أن يتساءل أحد عما نقصده بها. فالحرية، والتخلف، والتطور، والحقوق بمختلف أنواعها. والغرب، والدين، وغيرها كثير.. هي كلمات نُوظفها في النقاش والحوار بشكل عادي، على اعتبار أن لها مدلولا واضحا ومحددا.
لكن لو طرحنا سؤال: ماذا تقصد بالحرية؟ أو ماذا تقصد بالتخلف أو بالدين؟ لظهر لنا اختلاف كبير في التعريف، واتجاهات متباينة، وتحديدات بعضها يمكن أن نجد له موقعا في خارطة المعاجم، والبعض الآخر وليد انطباعات فردية، وفهم خاص يقترب أو يبتعد عن الدلالات الرائجة في حقولها الأكاديمية المعروفة.
عندما نقول بأن البلد الفلاني متخلف، أو فلان إنسان متخلف، ينبغي أن نطرح سؤال: متخلف بالقياس إلى ماذا؟ أو ما هو النموذج الذي نقيس عليه تخلفه أو تطوره وتقدمه؟ سيكون الرد في الغالب بالاعتماد على نموذج "الغرب" الذي استقر في أذهاننا بأنه هو المقياس. فسلوكي أو موقفي أو نمط عيشي يصبح متخلفا عندما أقيسه بسلوك الأمريكي أو الروسي أو الفرنسي، وكذلك موقفه ونمط عيشه. هذا ما نشأنا عليه من خلال التربية الموجهة في المدارس أو في وسائل الإعلام.
مشكلة المقياس أسهمت في تكريس الهزيمة النفسية لدى أجيال بأكملها، حتى صار الغرب موطن الحضارة والسلوك النبيل، والقدرة على فهم العالم وإدارته. وأذكر أن أحد دعاة الكماليين الأتراك، واسمه آغا أوغلي أحمد، كان يردد بكل جرأة ووضوح أن علينا أن نأخذ كل ما عند الغربيين، حتى الالتهابات التي في رئاتهم، والنجاسات التي في أمعائهم! وللأسف فهذا الطريق المختصر هو الذي أودى بالأمة إلى حضيض التخلف الحقيقي، لأن التقدم لا يتحقق بتحويل البلد إلى مخازن للسلع، ومجمعات للآلات والأجهزة الإلكترونية، وإنما بتنشئة الإنسان القادر على فعل ذلك بمفرده، وبوسائله الخاصة والمنسجمة مع قيمه وهويته، وثقافته.
مقياس التخلف إذن هو مقياس ثقافي. صحيح أن أمريكا والدول الأوربية، وبعدها اليابان والصين، تمكنت من تحقيق إنجازات مبهرة في الصناعة والتجارة والبحث العلمي. ونجحت في اختراق حُجب الفضاء، وغاصت في أعماق البحار. وتجاوزت العديد من صعوبات العيش المشترك، بفضل ترسانة قانونية، ومناهج تعليم رائدة؛ لكن يظل كل ذلك تقدما في جانب واحد، ولا يمكن بناء عليه أن نصدر حكم التخلف في الجهة الأخرى من الكوكب.
إن الصين على سبيل المثال، حققت قفزة تنين هائلة منذ سبيعنيات القرن الماضي، لكنها بالرغم من ذلك لا زالت تفتخر بسور الصين العظيم، وتزور قبور أباطرتها. وكذلك يفعل كل زائر للصين. وهذا يعني أنها جمعت بين المبدأ والدافع. فالمبدأ هو أن الصين حضارة عريقة لها تاريخ، والدافع هو أن عليها الحفاظ على هذا الموروث لأنه القوة الكامنة خلف مظاهر تقدمها.
مشكلتنا الأساسية، كمسلمين عربا وغير عرب، أننا حافظنا على المبدأ وضيعنا الدافع. فنحن نعتز بالإسلام كعقيدة شاملة وجامعة، وكمنظومة تعبدية وتشريعية أثبتت تجاوبها مع فطرة الإنسان منذ غار حراء حتى اليوم. لكننا فقدنا الدافع لأسباب تاريخية ونفسية، وسياسية للأسف الشديد.
كل مسلم يردد بأن النظافة من الإيمان، لكن لا يظهر أثر هذا الإيمان في الفضاءات العامة، من شوارع وأسواق وشواطئ، لأننا نحفظ المبدأ ونفتقر للدافع.
وكل مسلم يقرأ في كتاب الله العزيز أنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأننا إذا نصرنا الله سينصرنا. لكننا نبحث عن عوامل التغيير والنصرة في الإيديولوجيات المتفرقة، والمنظومات والخطط المستوردة، لأننا نحفظ المبدأ ونفتقر للدافع.
وقس على ذلك في كل المجالات التي يبرز فيها تخلفنا بسبب فك الارتباط بين المبدأ والدافع.
يُحرك ضحكي واستغرابي أن ينعت العربي عربيا مثله بأنه متخلف، حتى وإن كان الإثنان معا يعيشان تحت مظلة تخلف كبيرة، ولو اهتممنا بتحقيق المصطلحات الرائجة لتوقفنا عن كثير من الكلام، ولاستعاد الحوار العربي والإسلامي شيئا من نضرته، وبريقه، وفاعليته الحضارية.
-
 حميد بن خيبشكاتب شغوف
حميد بن خيبشكاتب شغوف
التعليقات
لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... ! تابعنا على الفيسبوك
مقالات شيقة ننصح بقراءتها !
مقالات مرتبطة بنفس القسم

Logiciel de facturation au Maroc
La gestion de la facturation est une tâche importante pour toute entreprise, de différentes tailles. Avec l’évolution numérique, un logiciel de facturation est devenus un outil indispensable pour automatiser et simplifier les processus metiers d'une entreprise. dans le marché





من المستفيد من النّزاع القائم بين المغرب والجزائر؟
رشيد مصباح(فوزي)كاتب جزائرئإذا أردت معرفة المجرم الحقيقى فابحث عن المستفيد من الجريمة.يبدو أن هذه المقولة هي المعيار الحقيقي لمعرفة من المستفيد من النّزاع القائم بين بلدين مثل المغرب والجزائر.إنهاء الاحتلال الصّليبي ثمنه لم يكن مجرّد أرواح تم تقديمها على الأكف