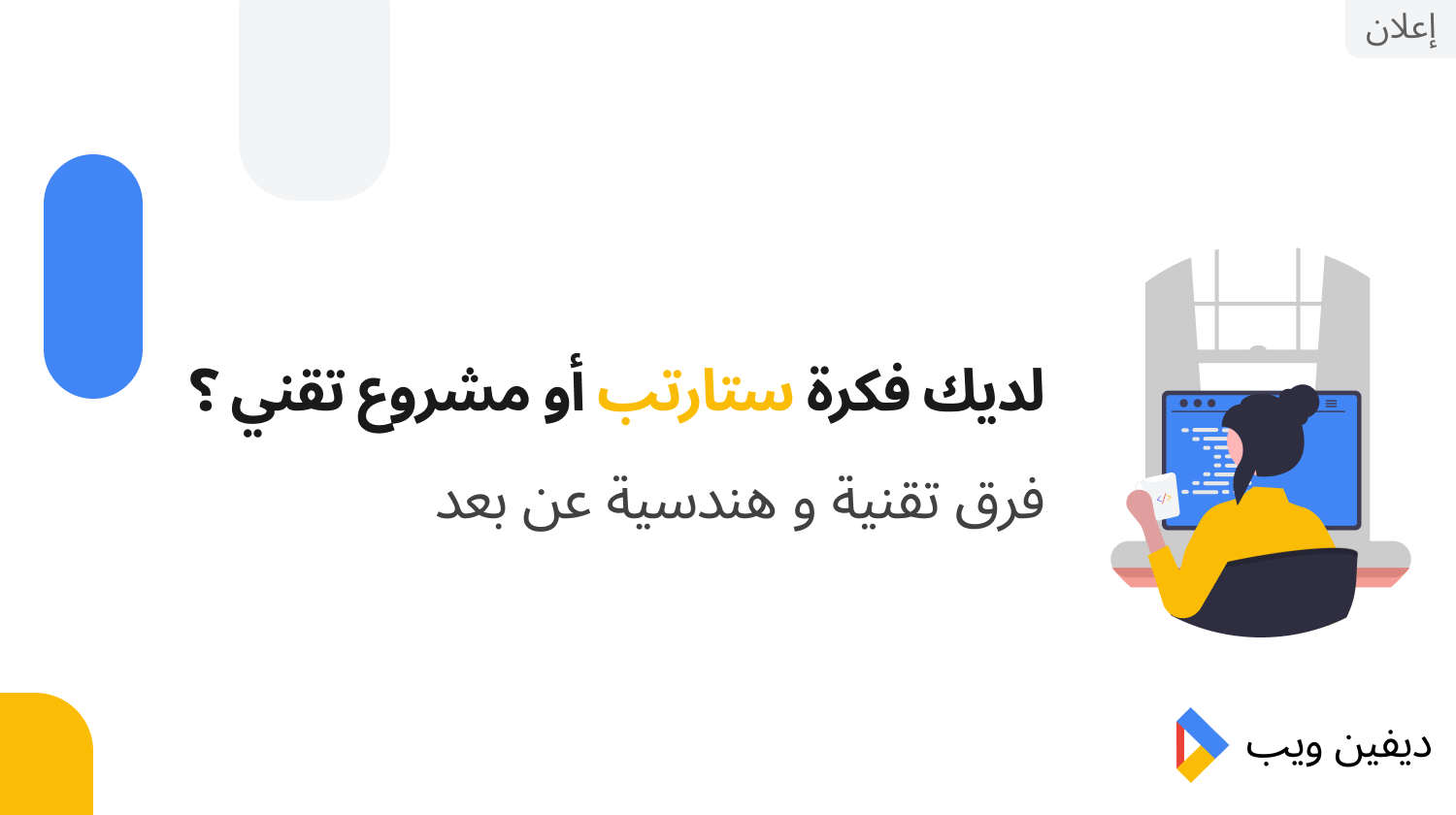عندما يؤمن الفرد بشخص آخر، فمعنى ذلك أنَّه يصدِّقه أيضا، وعلى هذا الأساس، تُبنى العلاقات ما بين البشر، فتكون سببا وتبريرا لما قد يُقدم عليه الكثير منهم، فيضحون بما لديهم في سبيل من يحبونهم.
"... كرسيك يا الله إلى دهر الدهور قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك، أحببت البر وأبغض الإثم، من أجل هذا مسحك الله الهك بدهن الابتهاج أكثر من رفاقك" .
حبُّ البر هو عمود الإيمان، والثقة التي تدفع إلى الاعتقاد هي ما يمكنها أن تدفع الإنسان إلى العمل، الإقدام على الصنائع الخيِّرة، هذا بالذات ما جعل الفرد قادرا على تشكيل ثقة بإيمانه، فالوعي الذي يصاحب المؤمن بأنَّ طريق خلاصه في إيمانه هو ما يعطيه قدرة خاصة على تبرير هذا الإيمان عبر ما يعتقد وجوده في الحب: حب البر.
يبدو من هذا كلِّه بأنَّ الإيمان لا يخرج من دوائر الثقة، المحبة، القبول، فالمؤمِن هو محب وواثق في قبول محبوبه، إذ يمكن لكافة التقديرات أن تدفع بالمؤمِن إلى استرجاع ثقته بعد فتورها، فيسمي ذلك: توبة، وهو بذلك يفسِّر حالة كهذه بضعف الإيمان، أو كما هو عند الجرجاني: إيمان موقوف، لكنه موقوف لفترة محددة، ليتحوَّل إلى إيمان مقبول.
أهمُّ ما يبدوا عن جوانب الإيمان أيضا، هو ما يجعل العمل والروح متمازجتيْن، ليتحلى المؤمِن بروح العمل، روح تحثُّ المؤمِن على العمل في نقاط محدَّدَة من حياته دون اكتراثه بما يحفُّ عمله هذا من خطر، فهو عمل بما يمكن للمؤمن تفسيره بالحب الذي يكتنفه حياله، حبُّ العمل الذي جعل سيدنا عيسى عليه السلام نجَّارا، سيدنا داوود حدَّادًا وسيِّدنا محمد عليه الصلاة والسلام راعي غنم ثم تاجرا.
أسباب المؤمِن قد تختفي بين طيات إيمانه، وهذا بالفعل ما يحفِّز الإيمان على اجتياح أمور ليست أقل من الغرابة، إذ يصبح كل ما يعجز عنه العقل من تبرير أو تعليل، ومحاك بواسطة الغامض من أمور متصلة بما هو مصدر الإيمان، يصبح تقليدا بما يجعل العملية مبرَّرَة بشكل حاسم.
تتجدَّد صورة الإيمان بصفة عامة عندما تتمثل للأجيال في صورة معجزة إنسانية أو إمبراطورية مؤسسات، فالإيمان الذي يُرسم على المنهج الصحيح، هو بمثابة إشعاع، يبدأ داخل مجتمع معيَّن، ويستمر اشعاعه بالانتشار حتى يصل المجتمعات الأخرى، بحيث يأسر هذا المجتمع أو ذاك، فيتبعه! كما حدث في الحضارات الشرقية القديمة، حيث فاضت ثقافة الإيمان الفكري من المعابد ودور العبادة.
"... الإيمان (La foi) هو اعتقاد بدين، مثال أو شخص، المشكلة الفلسفية هي عبارة عن علاقات بين المعرفة والإيمان، هي ارتداد فلسفي، بإمكانه حلُّ كل المشاكل التي طرحها الإنسان (مثل فكرة ديكارت، سبينوزا، فيخته وهيغل)..." .
عندما نتحدث عن الإيمان من منبعه الفكري، فإنَّه يخضع بطريقة آلية لما تخضع له الفكرة، أي أنَّه يخرج من نفسية الإنسان، وهو بذلك يتأثَّر بإفرازات العقل، وتقلبات المشاعر، وعليه فإنَّ المجتمع المؤمِن أثناء تبلور إيمانه، هو يلجأ إلى طِباع أفراده، لمزجها مع محددات عصره، ومتطلبات خططه المستقبلية، جاعلا من التقاليد، الأعراف والمبادئ، وتحولات العصر مصادر إلهام، من أجل الدفع برؤيا المجتمع المشتركة إلى مشاركة مجتمعات أخرى بها عبر الدعوة (الإسلامية) أو التبشير (المسيحي).
وهنا تظهر لنا بوضوح أهمية فكرة الإيمان الفكري، وهي التي في أصلها نوع من الابتكار، لأنَّ مزج التقاليد بأفكار ظروف العصر، ينتج عنها إيمان جديد، يأخذ شكلا جذَّابا، لأنَّه غير مسبوق، على الرغم من أنَّه كثيرا ما يكون في الأصل عبارة عن إعادة إحياء مشاهد إيمانية قديمة المبدأ، إلاَّ أنَّها جديدة الوسيلة، فيطرأ عليها التغيير، والذي يعطيها شرعية الإحساس.
ومع هذا فإنّ مسيرة الإيمان، لبلوغه المستوى المطلوب، لابد لها من المرور بثلاث محطات:
1. الارتقاء بمستوى المجتمع إلى مستوى الحضارة.
2. الارتقاء بمستوى الحضارة إلى مستوى الإنسانية.
3. ادخال البصمة الشخصية الخاصة في المسألة الرئيسية لإدارة أيِّ تفكير أو ثقافة.
حيث تمثِّل هذه الخطوات ضرورة من أجل استيعاب الإيمان لكل ثقافة، وإعطائه بُعدًا فكريا بمقدوره الانفلات من المسائل الجغرافية، الطائفية وحتى الحدود السياسية وغيرها من الحواجز.
-
 مزوَار محمد سعيدWriter - كاتِب - écrivain
مزوَار محمد سعيدWriter - كاتِب - écrivain
التعليقات
لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... ! تابعنا على الفيسبوك
مقالات شيقة ننصح بقراءتها !
مقالات مرتبطة بنفس القسم






"نظرية بيل، ما لها وما عليها"
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________المصادر:-يوسف البناي/ ميكانيكا الكم بين الفلسفة والعلم-مقال: من مُبرهنة الإستحالة لفان نيومان إلى التشابك الكمومي/ جمال ضو-Bell's Theorem-Bell's Inequality




من اللا معنى إلى المعنى، مقدمة قصيرة جدًا
هل كانت الفلسفة تستحق منّا عناء ساعة واحدة، إن هي لم تساعدنا على أن نكون سعداء؟ لقد تفشّت كراهية، صوّرت لنا الفلسفة على أنها محض نظريّة مجرّدة وعويصة، لا صلة لها بالحياة العمليّة، في حين أنّ معظم الفلاسفة، إن

بينَ الكائنِ بالقُوَّةِ والتَّقليدِ إلى الكائنِ بالأملِ والعملِ.. آفاقٌ مستقبليَّةٌ
بينَ الكائنِ بالقُوَّةِ والتَّقليدِ إلى الكائنِ بالأملِ والعملِ.. آفاقٌ مستقبليَّةٌ:...........................................................من العبثِ أنْ نتغاضى عن رؤية تعقيد المسارات –بدلالاتها الغيريَّة ما بين الدِّينيِّ والفكريِّ والسِّياسيِّ والاجتماعيِّ والإعلاميِّ- وتداخلها، واختلافها في المنطلقات الفلسفيَّة، التي تُظْهِر بونًا شاسعًا في تكويناتها، وما زالت في سيرورة أشبه بالعمياء،