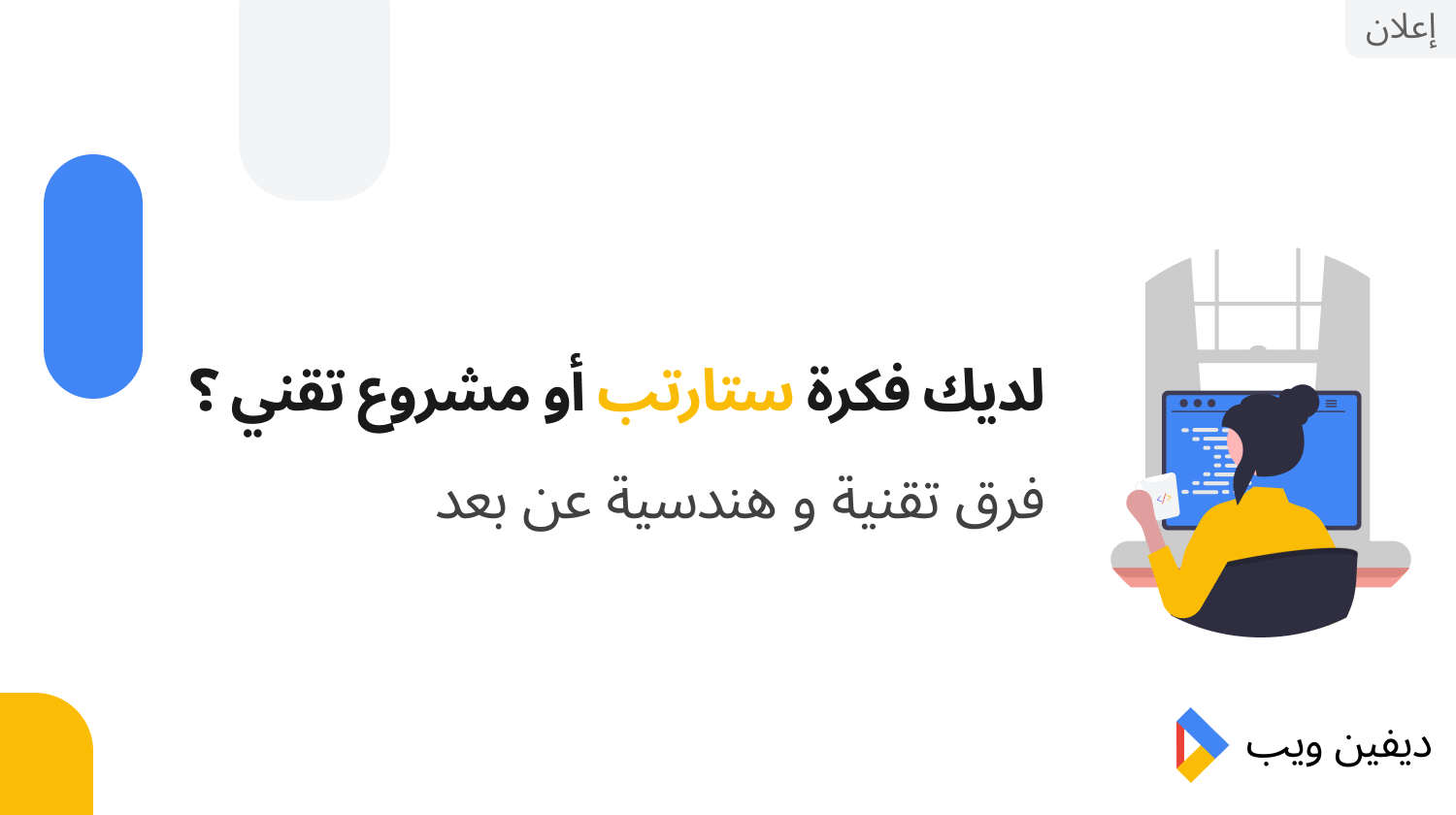دائما ما يحدث ، أن تطرح لأحدهم شيءا مستدلا عليه ببراهين و حجج و بيانات طويلة عريضة ، ثم يصد عن هذا كله و يتشبث بما يؤمن به ، مهما كان هذا الإيمان أسطوريا أو خرافاتيا ، مهما كان ضد المنطق و العقل و الواقع ، بل ضد الإنسان ، تجد المُنْكِر لما يضحده متشبثا به كما يتشبث الوليد بثدي أمه ، فلا يخفى أن المنكرين لكروية الأرض لم ينقرضوا بعد ، كما أن المنكرين لبعض الحقائق التاريخية التي تحرجهم أمام العالم يغص بهم الكوكب ، فضلا عن الكم الهائل للمنكرين لنتائج العلوم و الفلسفات المعاصرة .
كملاحظة أولية ، يظهر من إنكار الشخص لشيء ما وجود شيء آخر يقيس عليه الآراء و الأفكار و المعتقدات التي تطرح أمام ما يعتقد به ، فالمسلم الذي ينكر كروية الأرض يعود لنص القرآن الذي يعتقد أنه معصوم و الذي يقول بالإنبساط ، و المنكر لحقائق التاريخ يبحث عن كل شاردة في مدونات المؤرخين كي ينفي بها ما ينكره ، كما أن المنكر لحقائق العلم يبحث في آراء عَالِم مُخَالِفَة لآراء عَالِم آخر ، فيضرب هذا بهذا لكي يستنتج أن لا اتفاق و لا إجماع في العلم ، كي يطلع هو بينهما منتصرا بمعتقده الهش أحيانا و السخيف . هكذا فمن أخص الخصائص السيكولوجيا للإنسان المُنكر ، أنه "كائن قياسي" لابد له من أصل ثابت يقيس عليه مدى صحة المعلومات و الأفكار الجديدة ، حتى لو كان هذا النص لا ينتمي لفصيلة الأفكار المُقاسة عليه ، كما أن من سمات المُنكر "الإِجتِزَاء" و "المُخَاتلَة " ، حيث يجتزأ أدلة خارج سياقاتها و يُخَاتِلُ بها الأفكار التي ينكرها .
كما أن الشخص الذي ينكر الحقائق الثابثة غالبا ما يكون يعاني من "تأخر ذهني" ، غالبا ما يجد نفسه في أدنى سلم "Intelligence Quotient" أو IQ لقياس الذكاء ، فعندما لا يقوى المُنكر على فهم مستجدات الأفكار في حقل تملئه أحكام قيمة تنتمي لثقافته ، فإنه يضرب عنه صفحا محافظا على معتقداته دون أن تصيبها سهام الإرتياب .
كما يعتبر "التعصب" أهم السمات السيكولوجية للشخص المُنكر ، فهو لا يقف عند حد الإنكار بل يتجاوزه للإعتداء عمن يعتقد بما يضحد أفكاره ، إذ يتخد الإعتداء صور مختلفة ، كحرق الكتب و المكتبات ، ثم تضييق الأفق و هامش الحرية على من يقول بعكس ما يؤمن به المُنكر ، و أفدح أشكال الإعتداء الذي يبعث عليه تعصب المُنكر هو "القتل" ، و من ضحايا المنكرين في التاريخ "جوردانو برونو" في المسيحية ، و "الجعد ابن درهم" و "غيلان الدمشقي" و "ابن المقفع" في الإسلام ، و غيرهم كثير .
كما أن "السلفية" و "النكوصية" مؤشر سيكولوجي واضح للشخص المُنكر ، فالعلم عند المُنكر وصل إلى نهايته مع الأجداد ، وأن المعرفة أوفت على الغاية مع السلف ، و أن أرجح الآراء ما يعود للقرون الخالية ، هكذا يُحكم على كل من يخوض فيما خاض فيه السلف بأنه لن يبلغ النُّجعَة و لن يُصِيب المَحَزّ ، بل يحكم عليه بالضلال و أحيانا بالكفر ، هكذا و بما أن من يجابه بالتكفير كمن تُرفع أمامه بطاقة حمراء ، تطرده من الحقل التداولي و السجالي في المجتمع . و من ذلك نجد أن كبار العلماء و الفلاسفة في التاريخ من كانت لهم آراء مضادة لما هو سائد من أفكار ، عاشوا غرباء أو منفيين عن الحياة الإجتماعية .
سيكولوجيا الإنكار تعرف مضاعفات إذا ما انتقلت من الفرد إلى الجماعة ، حيث تصبح ثقافة المجتمع متطبعة على الإنكار و عدم قبول إلا ما ينتمي إلى ما هو ذاتي ، و الصد عن ما يُنظر إليه على أنه آت من الخارج (من الشاذ- الكافر- الضال)، هكذا تصبح ثقافة الإنكار في طليعة العوامل التي تجعل المجتمع الذي يؤمن بهذ الثقافة "مجتمعا متخلفا" ، يقول مصطفى حجازي: "ثقافة الإنكار و الإنكفاء على الذات ، هي الوجه الآخر لوضعية الفشل الإجتماعي" (سيكولوجيا الإنسان المقهور،ص 101) ، من ذلك تجد المجتمعات التي يكثر فيها المنكرين و الجاحدين ، مجتمعات مُتَخَلِّفَة على جميع المستويات ، ينموا في شعوبها الجهل كما ينموا البَقَلُ في الأرض ، تكون مجتمعات تعاني من الإرهاب و مُصدِّرة للإرهابيين . أما المجتمعات التي لا يوصد فيها باب النقاش ، و لا تُقفل فيها نوافذ المسائلة و إمكانية الوصول لأفكار جديدة ، فإنها تكون مجتمعات متقدمة ومرتقية ، تنعم شعوبها بالرفاهية و السلم ، إذ أن نقطة الإرتكاز في نوع المجتمعات الأولى هو "الأحادية" ، أما المجتمعات التالية فتقوم على "التعددية".
من جهة تحليلية ، يمكن القول بأن الشخص المُنكر يستعمل ما يساميه علماء التحليل النفسي بـ"ميكانيزمات الدفاع" ، التي تشترك جميعها في خاصيتين: 1) أنها تعمل بطريقة عاطفية لا شعورية ، 2) ثم أنها تنكر الواقع و تشوهه وتزيفه ، إذ بالخاصية الثانية يحاول المنكر عدم التحديق طويلا في الحجج التي تثبث عِوَرَ ما يؤمن به ، و بالخاصية الثانية يعزز و يطمئن لهذا السلوك ، هكذا يتضاعف تمسُّك المُنكر بمعتقداته عندما يواجه بأدلة دامغة تخالف هذه المعتقدات ، يتعلق السبب في ذلك بنظرته الحدية (المقدسة) إلى العالم ، و التي يرى أنها تتعرض للخطر بسبب البيانات المتضاربة بشأن هذه المعتقدات ، و بالحجج النافية لها قطعا .
من الدراسات التي وقفت على هذه المفارقة (كلما اتضح لبعض الأشخاص هشاشة أفكارهم ازدادوا بها تشبثا) ، هي تلك التي أجراها "بريندان نايهن"،و "وجيسون رايفلر" ، حدد الباحثان عاملًا وثيق الصلة بالموضوع أطلقا عليه اسم "تأثير الناتج العكسي"، "الذي يوضح أن التصحيحات تؤدي في حقيقة الأمر إلى دعم الأفكار و المعتقدات المغلوطة بين أفراد المجموعة قيد البحث" .
و لكن ما السبب في ذلك؟ "السبب أن ذلك يهدد نظرة هؤلاء الأشخاص إلى العالم أو مفهوم الذات لديهم" . على سبيل المثال، جرى إعطاء الأشخاص المشاركين في الدراسة مقالات صحفية زائفة تؤكد بعض المعتقدات المغلوطة المنتشرة على نطاق واسع ، مثل قضية وجود أسلحة دمار شامل في العراق . ثم عندما أُعطي هؤلاء الأشخاص مقالة تصحيحية تُبيِّن أن أسلحة الدمار الشامل المزعومة لم يُعثَر عليها مطلقًا ، أعلن الليبراليون الذين عارضوا الحرب عن قبولهم للمقال الجديد ورفضهم للقديم ، بينما فعل المحافظون الذين أيدوا الحرب العكس تمامًا ؛ بل الأكثر من ذلك أنهم قالوا إنهم قد أصبحوا أكثر اقتناعًا بأنه كانت هناك أسلحة دمار شامل بعد قراءتهم للتصحيح ، وكانت حجتهم أن ذلك أثبت لهم فقط أن صدام حسين إما قد أخفى تلك الأسلحة أو قام بتدميرها. في الحقيقة، ووفق ما يشير نايهن ورايفلر، ساد لفترة طويلة بين كثير من المحافظين "الاعتقاد بأن العراق كانت تمتلك أسلحة دمار شامل قبل الغزو الأمريكي ، حتى بعد أن توصلت حكومة الرئيس بوش نفسها إلى نتائج مخالفة لذلك الاعتقاد" .
هكذا إذن فالشخص المُنكر ، ليس أكثر من إنسان يعاني من عدم التوازن بين ما يؤمن به ، و بين ما يوجد عليه الواقع ، إذ يتحول الفشل في إيجاد التوازن إلى السقوط في وضع حجاب عن العين يحول دون النظر في الواقع كما هو ، و ذلك ما يتأدى بصاحبه إلى التعصب المؤدي إلى العنف أو الإعتداء ، ثم التطبع على نظرة مرتابة اتجه الآخر الذي تأتي المعلومة المضادة من جهته ، ما يتعذر بسببه العيش المشترك مع هذا الآخر ، غير أن سيكولوجيا الإنكار و الجحود تصبح خطيرة جدا ، عندما تسم بميسمها ليس الفرد فقط بل تتجاوزه إلى الثقافة و العقل الجمعي لأمة من الأمم ، و هذا للأسف هو السائد .
التعليقات
فأنا أتّفق مع أغلب ما ورد في مقالتك. وأرى معك أن العادة حجاب سميك يغشي صاحبه من رؤية الحقائق. وأنّ كلّا منا يحتاج أن ينتفض على بيئته ومورّثاته.
ولكن اسمح لي أن أختلف معك في بضع نقاط:
فأما ما ذكرت من أن القرآن يقول بانبساط الأرض، فهذا ما لم يرد فيه نصّ، بل ورد في وصف أرض الحساب. التي يصفها الباري ايضاً بقوله: (يوم تُبدّل الأرض غير الأرض). أعني أن أرض المبعث جزء من عالم آخر يقوانين وحقائق فيزيائية مختلفة عنّا كلّياً.
وأما مما ورد في القرآن في وصف أرضنا الحالية قوله تعالى: (والأرض بعد ذلك دحاها) أي بسطها على هيئة بيضة كما يدحو الخباز العجينة. وممّا ورد فيه قوله: (يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل). وفي ذلك إشارة إعجازية على شكل الأرض وحركتها. فهمها المتقدّمون بطريقتهم الساذجة فأساؤوا فهمها. لكنهم غير معصومين من جهة، ولسنا ملزمين باتباع سوء فهمهم.
شخصياً لم أجد الكثير مما يتضارب فيه النصّ القرآني مع الكشوف الحديثة، فتجد مثلاً ما يؤيد حقيقة توسع الكون ونظرية الإنفجار الكبير في الفيزياء (والسّماء بنيناها بأيّدٍ وإنّا لموسعون) و (يوم نطوي السماء كطيّ السجلّ للكتب). ونظرية النشوء والارتقاء في الأحياء (أتجعل فيها في يفسد فيها ويسفك الدماء) و (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق). وهذا غيض من فيض، مما خفي عن المتقدّمين فصاروا للمتأخرين حجةً في إنكارها - وياللأسف.
وأما من كان مصيرهم الموت بطرائق بشعة (الجعد ابن درهم وغيلان الدمشقي وابن المقفع)، فقد رماهم الحكام بالزندقة، كما رمى العوام فيما بعد الجاحظ وابن حيان وابن رشد وابن سينا وابن عربي والخورازمي، وغيرهم كثيرين من الأعلام. لا لشيء إلا لأنهم خالفوا مذهب العوام وطريقتهم التي ورثوها. ولم تكن مشكلة هؤلاء المفكرين مع الإسلام أو مع القرآن. وإنما كان جلّهم عقلانيين إلى الاعتزال أقرب منهم إلى طريقة أهل السنّة والجماعة السائدة.
عدا عن هاتين الملاحظتين فأنا أشد على يديك يقوّة وأدعوك إلى مزيد من المساهمات في تصحيح منظور العوام التقديسي للعادات والتدنيسي للحقائق. أدام الله قلمك وأنار دربك.
لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... ! تابعنا على الفيسبوك
مقالات شيقة ننصح بقراءتها !
مقالات مرتبطة بنفس القسم





نيكولا تيسلا وشغف الفيزياء
نيكولا تيسلا ، العالم الصربي ، الملقب بالمجنون ، المجنون في شغفه وفكره ونظرته للحياة..فيزيائي ومهندس كهربائي ، ولد سنة 1857 في كرواتيا.. ~ كانت بدايات شغفه بالفيزياء مع ظاهرة " الصاعقة " التي رآها في صغره وحاول جاهدا فهمها ،

جبروت متكبر
لكل متكبر حكاية وحكايتنا اليوم عن زعيم المتكبرين النرجسي العظيم الذي لطالما تفاخر وتباهى أمامنا بسرعته الهائلة ، حير العلماء سنوات وسنوات ولكن نسي مع رفعه رأسه تفاخرا وتعاليا أن مصيره الإرتطام بجبل عالي والسقوط من العلالي دون أن
علكة ممضوغة حملت الحمض النووي للبشر لمدة عشرة آلاف عام
يقولون أنها شجرة لا يمكن نسيانها أبدًا ، وكذلك بقاياها. على مدار أكثر من عشرة آلاف عام ، كان مضغ علكة قديمة ، مصنوعة من القطران الناتج عن لحاء شجرة البتولا ، تحمل في طياتها ذكرى أول مستوطنين بشريين
يعتقد علماء الأحياء أنهم وجدوا العنصر السري الذي جعل الحضارة ممكنة
المجتمعات الإنسانية مزدهرة للغاية في الغالب بسبب كم من الإيثار. على عكس الحيوانات الأخرى ، يتعاون الناس حتى مع الغرباء الكاملين . اننا نشارك المعرفة في ويكيبيديا، ونظهر للتصويت، ونعمل معاً لإدارة الموارد الطبيعية بمسؤولية . ولكن من أين