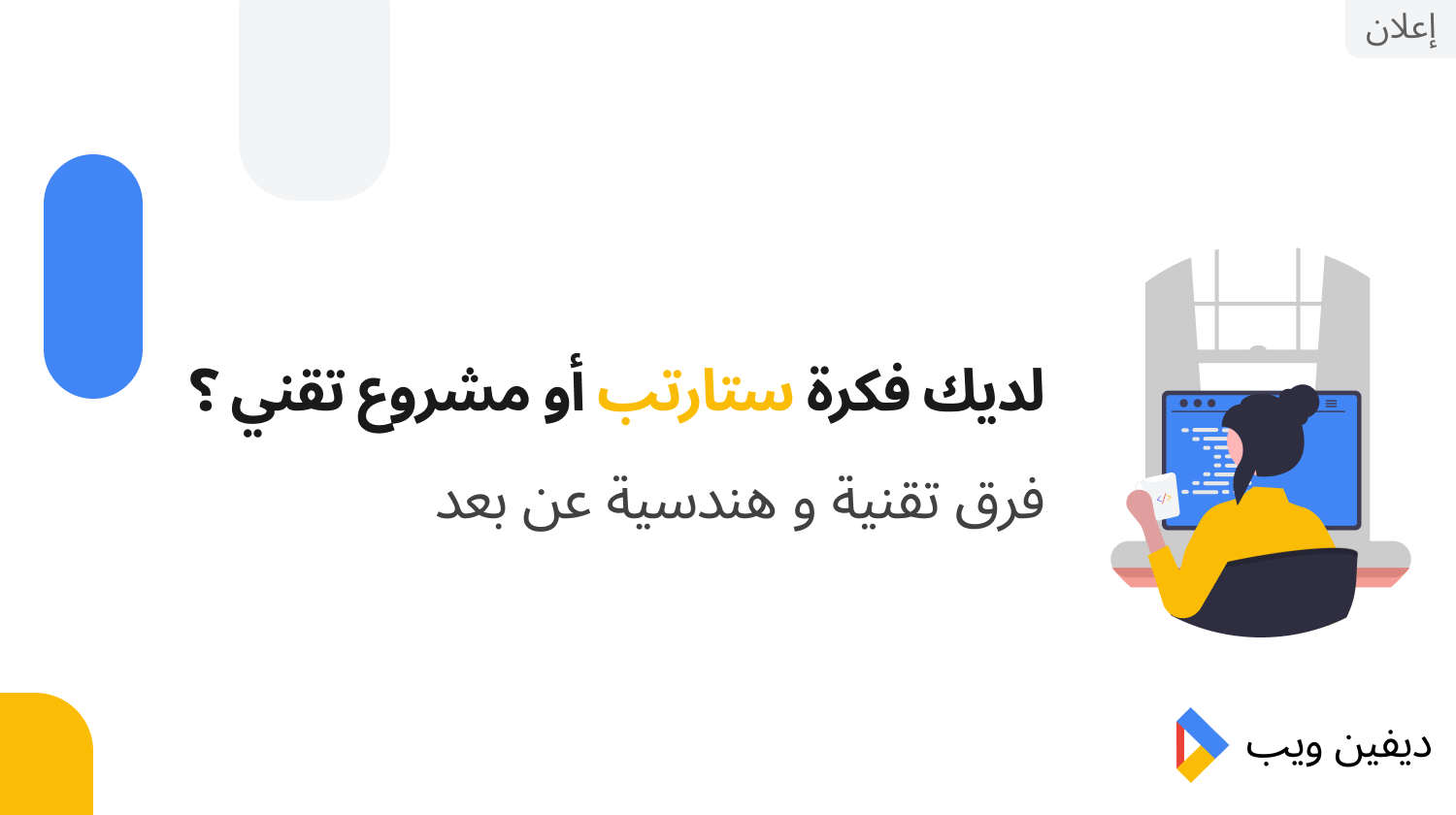تأمل معي أيها القارئ الكريم هذا الحديث العجيب وأمعن فيه النظر، وانصت لقصّة قد يعدُّها الواحد منّا من الخيال، وهي في صحيح مسلم، يقول عطاء ابن رباح قالَ لي ابنُ عَبَّاسٍ: أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِن أَهْلِ الجَنَّةِ؟ قُلتُ: بَلَى، قالَ: هذِه المَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَتَتِ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، قالَتْ: إنِّي أُصْرَعُ وإنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ لِي، قالَ: إنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وإنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ قالَتْ: أَصْبِرُ، قالَتْ: فإنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لا أَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا.
الحقيقة إني لا استطيع إخفاء ذهولي أمام هذا الأثر العجيب، وكيف استطاعت هذه المرأة المؤمنة أن تتناسى الألم والمرض والتعب أمام عرض من النبي ﷺ أن تصبر طيلة حياتها على هذا الألم ويكون عاقبتها في الآخرة الجنة، قد يبدو الأمر سهلاً في المقال، وقد يقول قائل لو كنت مكانها لفعلت مثل ما فعلت، ولكن المواقف تكشف لنا غير ذلك، وتُنبئ عن ضعف نفوسنا إذا أتت الحقيقة.
السؤال الذي يجول في الخاطر ما هو الدافع القلبي الذي دفع هذه المؤمنة أن تختار الجنَّة وتصبر على المرض دون أن تطيل التفكير في إمكانية الشفاء؟
في الحقيقة أنَّ هؤلاء رزقهم الله فهماً لمكانة الأخرة ومركزيَّتها جعل الدنيا بآلامها وأحزانها لا تستحق أن تكون مساوية للآخرة ولا أن تُذكر في محضر الآخرة، فكلَّما تزينت لهم الدنيا دمغوها بحسن المآل، وكلَّما كسرتهم جبروها بموعود الله في الآخرة.
إنَّ مركزية الآخرة في حياة المؤمن هي السبيل القويم للعيش المطمئن في هذه الدنيا، فكلُّ ما هو سبيلٌ لصلاح الآخرة كان من الأولويات، وكل ما يصرف عنها فهو في ذيل الاهتمامات، بل إنَّ صعاب الدنيا مفازة لا يقطعها بكل راحة وطمأنينة إلا من كانت الآخرة حاضرة في يومه وليلته، ولا يضبط هذه النفس الشرود ويُحكِم عِقالها إلا استحضار الآخرة، فطبيعة الإنسان أنَّه إذا رأى ما يعجبه - ولم يملكه- تألم لفقده وتقطَّعت نفسه كمداً لعدم حوزته، فيأتي ذكر الآخرة فيُنسي تلك اللذة الدنيوية أمام ما يكون عند الله من العوض، وما سيلاقيه المؤمن في الحياة السرمدية من أجر عظيم ومكانة عالية في الجنَّة، ولهذا كان الدرس النبوي في مثل هذا الموقف درس بليغ كان "إذا رأى شيئاً يعجبه من الدنيا يقول : ( لبيكَ ، إنَّ العيشَ عيشُ الآخرة ) لأن الإنسان إذا رأى ما يعجبُه مِن الدُّنيا رُبَّما يلتفت إليه فيُعرض عن الله ، فيقول : ( لبيك ) استجابةً لله عزَّ وجلَّ ، ثم يوطِّنُ نفسه فيقول : ( إنَّ العيشَ عيشُ الآخرة ) فهذا العيش الذي يعجبك عيش زائل، والعيش حقيقة هو عيش الآخرة)".
فالمؤمن أمام الابتلاءات صابر محتسب يرجو ما عند الله والدار الآخرة، وأمام النعم حامد شاكر يسخِّرها فيما يُصلح به آخرته، وكلَّما زاد في قلبه حضور الآخرة كان ذلك طريقاً يبساً للعيش الطيب المطمئن في هذه الدنيا، يقول ﷺ (عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له).
إن تصور هذا النموذج لهذه المرأة المؤمنة واقتناصها لفرصة الفوز بالآخرة مع الصبر على بلاء الدنيا يفتح أمام أعيننا درساً بليغاً -يعرفه الصادقون- وهو أنَّ تقديم الآخرة ومطالبها على الدنيا وأتراحها يبعث على الطمأنينة والعيش المطمئن في الحياة الدنيا، والفوز بالجنَّة في الآخرة، ويجعل الرضا عن قضاء الله عبادة قلبية يطمئنُّ بها قلب المؤمن، وتهوي أمامها مصائب الدنيا، وتفتح باباً من أبواب الجنَّة لصاحبها يقول ﷺ (إنَّ عِظَمَ الجزاءِ مع عِظَمِ البلاءِ؛ و إنَّ اللهَ تعالى إذا أحبَّ قومًا ابتلاهم، فمن رضيَ فله الرِّضَى، و من سخِط فله السُّخطُ).
فما الهم والغم، وشظف العيش والفقر والديون، والأمراض والأسقام البدنية والنفسية، ومعارك الشهوات والشبهات، ونقص الأنفس والثمرات، وأنواع الفتن من التشريد والقتل والحبس وغيرها ليست إلا بلاءات تعكِّر صفو هذه الحياة، ويشعر معها المؤمن بالضيق والحرج فيها، ولا يجعل هذه المنغصات برداً وسلاماً إلا استحضار طيب المآل، وتذكُّر الراحة والطمأنينة الأخروية التي تنتظره عند ربِّه، وأنَّ ذلك مما يُرضي الله عنه، فيطمئن قلبه بموعود الله، وتسكن جوارحه بما يدَّخره الله لعباده الصالحين من نعيم في الجنَّة، فالأصل في الدنيا أنَّها دار نقص وابتلاء، ولا يكتمل الأمر فيها إلا بصبر جميل، كما قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (وجدنا خير عيشنا بالصبر) فهي مطبوعة على النقص والكدر ولا تكْتمل لذتها إلا بالصبر الجميل:
طُبِعَـتْ علـى كَــدَرٍ وأنــت تريـدهـا
صـفــواً مـــن الأقـــذاءِ و الأكـــدارِ
اللهم اكتب لنا السعادة والراحة والطمأنينة في الدنيا والآخرة، واجعل الآخرة مقصدنا ومطلبنا يا كريم.
-
 علي عسيريمهتم بالبلاغة القرآنية
علي عسيريمهتم بالبلاغة القرآنية
التعليقات
لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... ! تابعنا على الفيسبوك
مقالات شيقة ننصح بقراءتها !
مقالات مرتبطة بنفس القسم




ما بين التثقيف والتصفيق فى الجمهورية الجديدة!
دائماً ما كانت «الأنظمة» تستخدم «المثقفين» للترويج لأعمالها ومشروعاتها(هذا إن افترضنا أن هذا النظام يمتلك مشروع بالفعل)، ولكن فى الماضي كانت هناك أنظمة «عاقلة» ومثقفين «موهبين» قادرين على الحفاظ على الحد الأدنى من «الاحترام» والمعقولية فى «الطرح» و فى مستوى