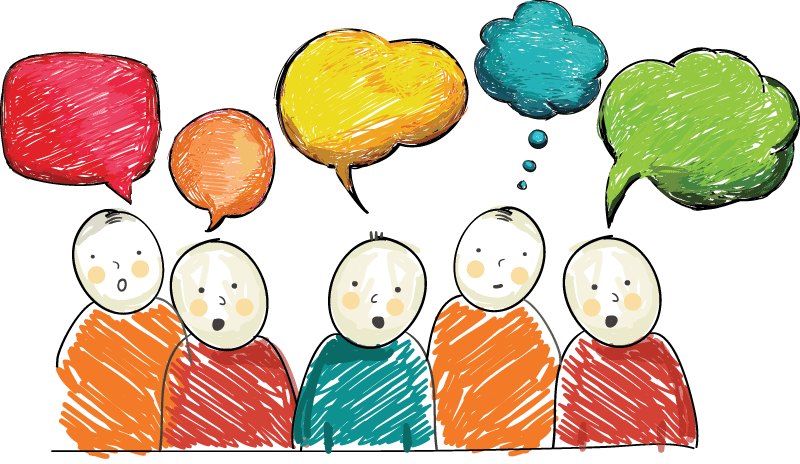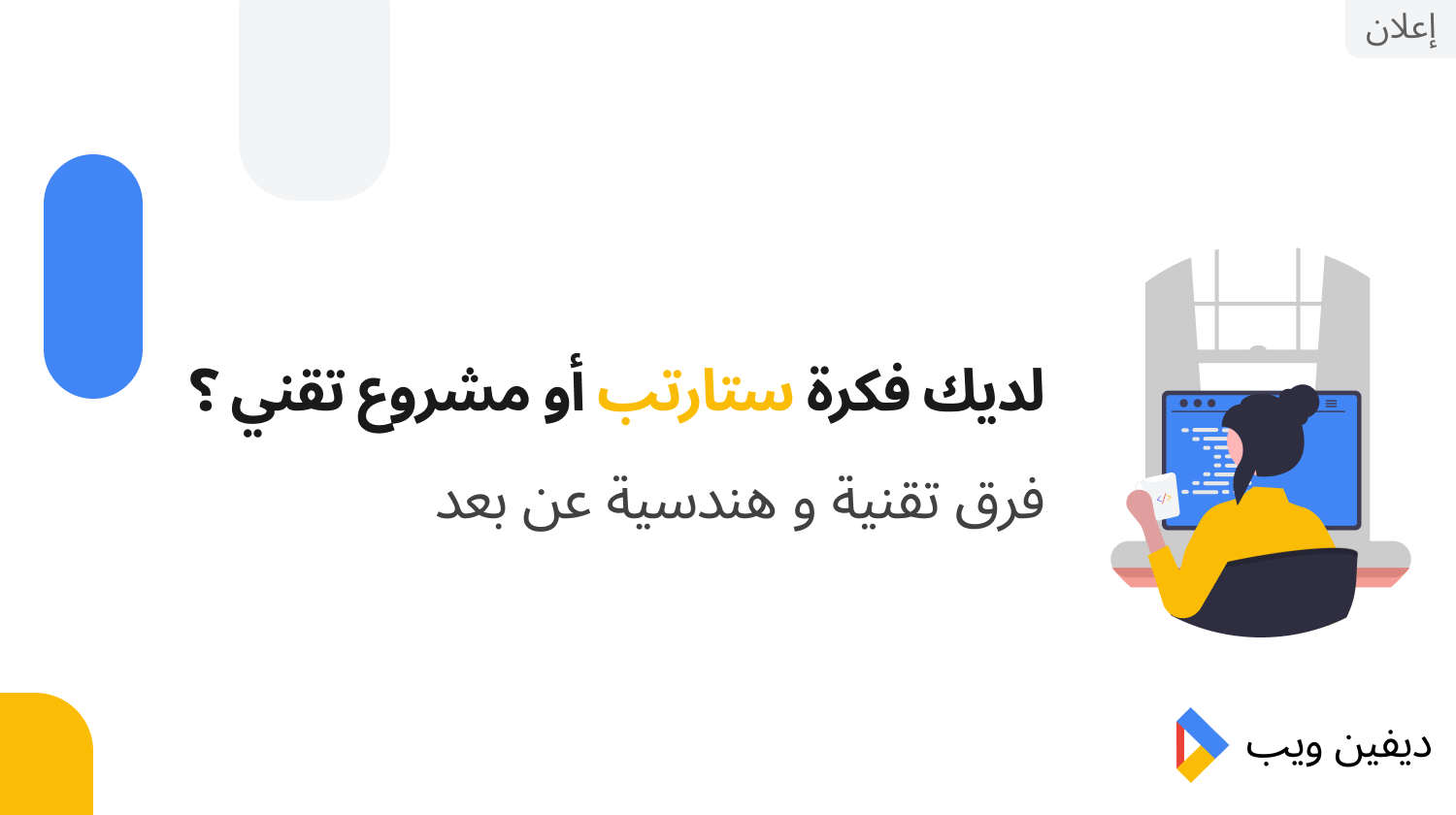كيف نصنع جيلا من المُشرملين؟
السر كما يعلم الجميع في التربية... لكن ما سر التربية؟
نشر في 23 فبراير 2016 .
التربية سيرورة معقدة، تتخلّلُها مجموعة من الأنساق الفاعلة، بهدف خلق كائن بشري بمعايير محددة، هذه الأنساق تكون مؤطّرة بمؤسسات ثانوية للتنشئة الإجتماعية (وسائل الإعلام، الشارع...) لكنها تؤثر بشكل مباشر في دور مؤسسات التنشئة الإجتماعية الرئيسية (الأسرة، المدرسة، المؤسسات الدينية...).
أكيد أصحاب القرار بيدهم كل الوسائل التي تمكّنهم من ضبط كل تلك المؤسسات الفاعلة في إنتاج الكائن البشري المستقبلي.
إن كان النظام صالحا و محبا لوطنه، فسوف يُفعِّل سلطته هاته في إتجاه خلق جيل صالح مُصلح للوطن، أما إن كان النظام فاسدا مُفسِدا فليس من مصلحته خلق جيل مستقبلي صالح لأنه سيُهدد وجوده.
و الأمر رغم تعقده وصعوبة حصر الأدوات الفاعلة في هذه السيرورة بذقة، لكنه بسيط في الشرح و سهل على الفهم.
فإن كان النظام مثلا صالحا و محبا لوطنه سيسعى إلى خلق جيل من العباقرة و المُثقفين، و المنتجين، الفاعلين إيجابا داخل المجتمع... و في سعيه هذا سيُوظف النظام الحاكم مؤسسات التنشئة الإجتماعية كلها لتحقيق هذا المسعى... و ذلك بالتشجيع على التعلّم و التعلِيم (في وسائل الإعلام مثلا، بخلق برامج ثربوية موجهة للناشئة تؤطر ميولاتهم و تحببهم في المدرسة و تجعل من الأستاذ قدوتهم، و المدرسة جنّتهم... كما سيحرص النظام على محاربة كل الأعمال التلفزية التي قد تشكل عامل إنحراف على المسعى المخطط له...).
كما ستُسَنّ قوانين تؤطر علاقة الطفل بوالديه، -لتأطير مؤسسة العائلة- و بمحيطه الأسري -مؤسسة الأسرة- (أكيذ هذه القوانين ستفرض على الآباء الحرص على تعليم أبنائهم و أن يكونوا قدوة حسنة... كما سيحرص -أي النظام- على تكوين الآباء لكي يقوموا بدورهم على أحسن وجه، و تعريفهم بأنجع الوسائل للنجاح في دورهم التربوي...).
كما سيحرص النظام على تأطير مؤسسات الشارع التي قد تقوم بدور سلبي في عملية التنشئة الإجتماعية هاته (كمنع -تطبيقا- السكر العلن، و إيواء المُشردين، و علاج المدمنين، و محاربة دور الدعارة، أو على الأقل تأطيرها و حصرها في أماكن محددة...).
إلى جانب تشجيع الموهوبين من الشباب المفكرين و العباقرة و خلق جو من التنافس في صفوف النّاشئة حول الإبداع الخلاّق في مجالات العلوم و التميُّز الأدبي أولا ثم الفن الخلاّق ثانيا، فالتفوّق الرياضي في المرتبة الثالثة...
هذا إلى جانب التوعية بالحقوق و الواجبات، و توضيح الخلفيات، و السعي إلى إستفزاز الجانب المعرفي و الإكتشافي لدى الناشئة، ودفعهم نحوى عدم الإكتفاء بالإجابات الجاهزة بل البحت عن خلفيات الأمور و توفير معرفة ذاتية، راسخة، لا معلومات جاهزة مُستَظهَرة، مُعرّضة للنسيان...
أما إن كان النظام فاسدا مُفسدا، فليس من مصلحته إنتاج مثل هذا الجيل... بل يُفضّل خلق جيل من (المُضبّعين) و الفارغين، و الجاهلين... لأنه "من السهل خداع و سرقة إنسان جاهل، مع ضمان حبه و تبجيله لك، و من المستحيل كسب حبّ إنسان واعٍ كشف سرقتَك و خِداعِك له".
قد تبدوا هذه الـــأمور التي سردت آنفا، بسيطة التطبيق، قيّاسا بالمهمة العظيمة التي ستُسديها للمجتمع، لكن سأضيف أن تكلفتها لن تتجاوز عُشر ما تبدله الأنظمة الفاسدة في طريقها ل"تضبيع" مواطنيها... كيف ذلك؟ هذا هو السر في خلق الكائن البشري الجديد، الذي أسميناه عبثا (جيل المُشرملين).
فكيف تصنع الأنظمة الإستبدادية جيلا من (المُشرملين)؟
أولا: من هم "المشرملين"؟
هم مجموعة من الشباب لا تتجاوز أعمارهم في أغلب الأوقات 17 سنة، معروفين بقَصّة شعرهم الغريبة، و ملابسهم الفاخرة -غير الأنيقة- و ساعاتهم الباهضة الثمن، يتنقّلون على متن دراجات نارية سريعة، جُلهم يمتهن السرقة بالنشل و التهديد بالأسلحة البيضاء، أغلبهم يكون مهوسا حتى المرض بأحد من الأندية الرياضية المشهورة، أو أحد الأنواع الموسيقية الصاخبة...
يسمّونهم المغاربة ب"المشرملين" و أكيد في جل الدول العربية هناك "مشرملين" لكن بأسماء مختلفة.

ثانيا: كيف نصنع جيلا من "المشرملين"؟
إنه بكل بساطة أن يقوم النظام بعكس ما عليه أن يقوم به من أجل إنتاج جيل من الواعين، و الذي وضحت مدى بساطته، لكنني قلت أن ما تبدله الأنظمة الإستبدادية من جهد (مادي و معنوي) في طريقها لإنتاج جيل فاشل "مشرمل" يتجاز عشرة أضعاف ما يمكن أن تبدله لو أرادت إنتاج جيل واعِِ، و فاعل بالإيجاب في المجتمع، ولعل الكثير من القُرّاء توقف عند إشارتي تلك و تابع القراءة قصد البحث عن توضيح لي عن فكرتي تلك!
لكي تنجح الأنظمة الفاسدة في خلق جيل من "المشرملين" ليس بالأمر السهل بتاتا، بل هو عمل مخطط له و مدروس. فعلى النظام أن بوجه كل مؤسسات التنشئة الإجتماعية في خدمة طموحه، بداية بوسائل الإعلام (التشجيع على الإنحلال الأخلاقي، و تبغيض المدرسة في نفوس الناشئة و تدمير هيبة الأستاذ "مدرسة المشاغبين" و تمرير رسائل سلبية خصوصا في البرامج الموجهة للأطفال...).
أما فيما يخص مؤسسة الأسرة، سيسعى النظام إلى إثقال كهل الوالدين بغلاء المعيشة، و إنعدام الأمن مما سيدفع بهم إلى التخلي عن دورهم التربوي، و التشجيع على العنف ضد الأطفال -أتحدث خصوصا عن العنف المعنوي لأنه هو الأخطر- إلى جانب نشر ثقافة هدّامة تُكرّس دور الأسرة في الإعالة المادية لا غير...
أما مؤسسة المدرسة، فالأمر يتجلى بوضوح تام، في المناهج التربوية المُملّة و الهادفة أساسا إلى تبغيض الطفل في المدرسة، إلى جانب الأساليب البيداغوجية الفاشلة التي تتعامل مع المُتعلِّم كمجرد وعاء فارغ وَجَب ملؤه، و تغييب حس الإكتشاف و البحث و التعلم الذاتي... إلى جانب إهمال البنية التحتية التربوية، و تهميش الأستاذ...
أما مؤسسة الشارع فحدث و لا حرج، التشجيع على إنتشار دور الدعارة في كل الأماكن حتى الشعبية منها، و فتح خمارات في كل الشوارع، و الملاهي الليلية التي تسمح للقاصرين بولوجها بتشجيع من النظام، ناهيك عن التساهل الكبير مع اللصوص و المدمنين و أصحاب السوابق....
لقيام النظام بكل هذه الأمور، يستوجب عليه بذل مجهود كبير، أولا في شراء الدمم، و توضيف الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب، و البحث دائما عن تبريرات واهية للإخفاقات المخطَّط لها، والتي هي نجاحات باهرة للنظام... و تخصيص ميزانيات مضاعفة، لمشاريع وهمية بغرض ضمان ولاء منعدمي الضمير المكلّفين بتدبير شؤون العامة، أقصد المكلفين بتنفيد مخططات النظام...
و في الأخير وجب الربط بين خصوصيات ظاهرة "التشرميل" و الأمراض الإجتماعية التي إبتكرها النظام في مختبراته الخاصة.
قلنا لديهم قصة شعر غريبة، أكيد إقتداءا بنجوم كرة القدم، و المغنّيين... أكيد! لأن الأنظمة الفاسدة أهدرت ملايير الدولارات من أجل الترويج لهم في قنواتها، و دعوتهم لحفلات ميدانية صاخبة، بمبالغ خيالية، أو تسليط الضوء على نجوم كرة القدم أو غيرها من الرياضات، حتى تُعجَب به الناشئة، ليس لإبداعات هؤلاء النجوم، أو تميُّزهم، و لكن لأنهم قُدِّموا له (أي الفنانين أو الرياضيين) على أنهم أشخاص مُقدسون و عظماء، و بالتالي فالشباب مُرغمين لا مخيَّرين على إتخاد ذلك الفنان(ة) -المنتحر(ة)- أو الرياضي -الفاشل أسريا- قدوة...، و كذلك لأن الشباب لم يتعرّفوا على عظماء التاريخ، من العلماء و المخترعين و الفلاسفة و الفنانين الحقيقيّين... كي يتخدونهم قدوة.و في ضل السياسة "التضبيعية" للأنظمة الفاسدة، يُنتَجُ لنا جيل من الفاشلين، بدون إنجازات ذاتية، فيُكوَّن لديهم حِسّ بالفشل و إنعدام الإنجازات، ما يدفعهم إلى البحث عن "وجود" عن إنجازات عن حس بالتفوق...، ليتخلى عن فكرة تكوين ذاته كي يكون إنسانا ذا إنجازات، و يستأنس بفكرة "إنجازات اللآخر هي إنجازاتي"
من هذا المنطلق يتخد إنجازات ذالك اللاعب أو تلك المغنية هي إنجازاته، فيفرح بفرحه و يحزن لحزنه و يتعصب من منتقديه و يدمّر من تطاول عليه، فيُقلّده في اللباس و طريقة حلق شعره و ألفاظه ... لكن لن يقلده في إنجازاته.
هذا النمط المعيشي الذي يتطلب الكثير من المال، يدفع بهم إلى إتخاد المهنة الأسهل "السرقة" وسيلة لتحقيق حلم "عَيْش مَعِيشَة قُدوَتِه". و في ظل تساهل السلطات مع هذا النوع من الجرائم، خصوصا إذا إلتزم السارق بسرقة الفقراء، دون إرتكاب خطأ سرقة الطبقة المُخمليّة، لأن لديهم أوراق ضغط و معارف تمكّنهم من إرغام السلطات على إعتقالهم و الزج بهم في السجن.
هكذا ينشغل "المشرمل" بتقليد الفنانين و الرياضيين... و يُلهى عن مراقبة ثروات بلاده، و عمل حكوماته، و يخلو الجو للنظام كي يسرق كما يشاء، دون إنتقاد و لا بلبلة، بل و يضمن ولاء الشعب "المُضبّع" و "المُشرمل" لأنه ينظيم حفلات لنجوم الشعب المُفضّلين، و مباريات يُشارك فيها أشهر اللاعبين.
بقلم: يوسف البركالي
التعليقات
في مجمل هذا المقال تطرقت لرأس الهرم و مسؤولية الدولة في صناعة هذا النوع من الكائنات و هو ما تقوم به الأنظمة الاستبدادية من تكريس للاوعي و تشجيع لمشاريع عبثية وهمية و شراء لذمم النخب الفكرية و السياسية..لكن هذا لا يخلي دور و مسؤولية قاع الهرم، وهو دور الأباء في التربية و مقاومة تأثير المحيط و التكوين لمحاولة عمل تغيير من القاع.
مشكلتنا بالأساس تتلخص في التربية في أساس الهرم و الاستبداد في أعلاه
الثورات العربية الأخيرة أثبت عدم نجاعة التغيير من الفوق، مالم يصاحب بقرار من النخب الفكرية في تحمل مسؤولياتها الإنسانية و التاريخية تجاه شعوبنا.
لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... ! تابعنا على الفيسبوك
مقالات شيقة ننصح بقراءتها !
مقالات مرتبطة بنفس القسم


من المستفيد من النّزاع القائم بين المغرب والجزائر؟
رشيد مصباح(فوزي)كاتب جزائرئإذا أردت معرفة المجرم الحقيقى فابحث عن المستفيد من الجريمة.يبدو أن هذه المقولة هي المعيار الحقيقي لمعرفة من المستفيد من النّزاع القائم بين بلدين مثل المغرب والجزائر.إنهاء الاحتلال الصّليبي ثمنه لم يكن مجرّد أرواح تم تقديمها على الأكف
نظام إدارة المخزون والمبيعات
يعتبر نظام إدارة المخزون والمبيعات (Inventory and Sales Management System) أحد الأنظمة و الأدوات الرئيسية التي تساهم في تحسين أداء الأعمال وتسهيل العمليات اليومية في الشركات Business Operations. يقوم هذا النظام بتنظيم و ترتيب العمليات المتعلقة بإدارة المخزون وعمليات البيع،
Logiciel de gestion de stock au en Afrique et Maroc
Le Maroc, en tant que plaque tournante économique de l'Afrique du Nord, voit de plus en plus d'entreprises adopter des stratégies avancées de numérisation, gestion d'entreprise et gestion de stock de produits de distribution pour rester compétitives sur le marché