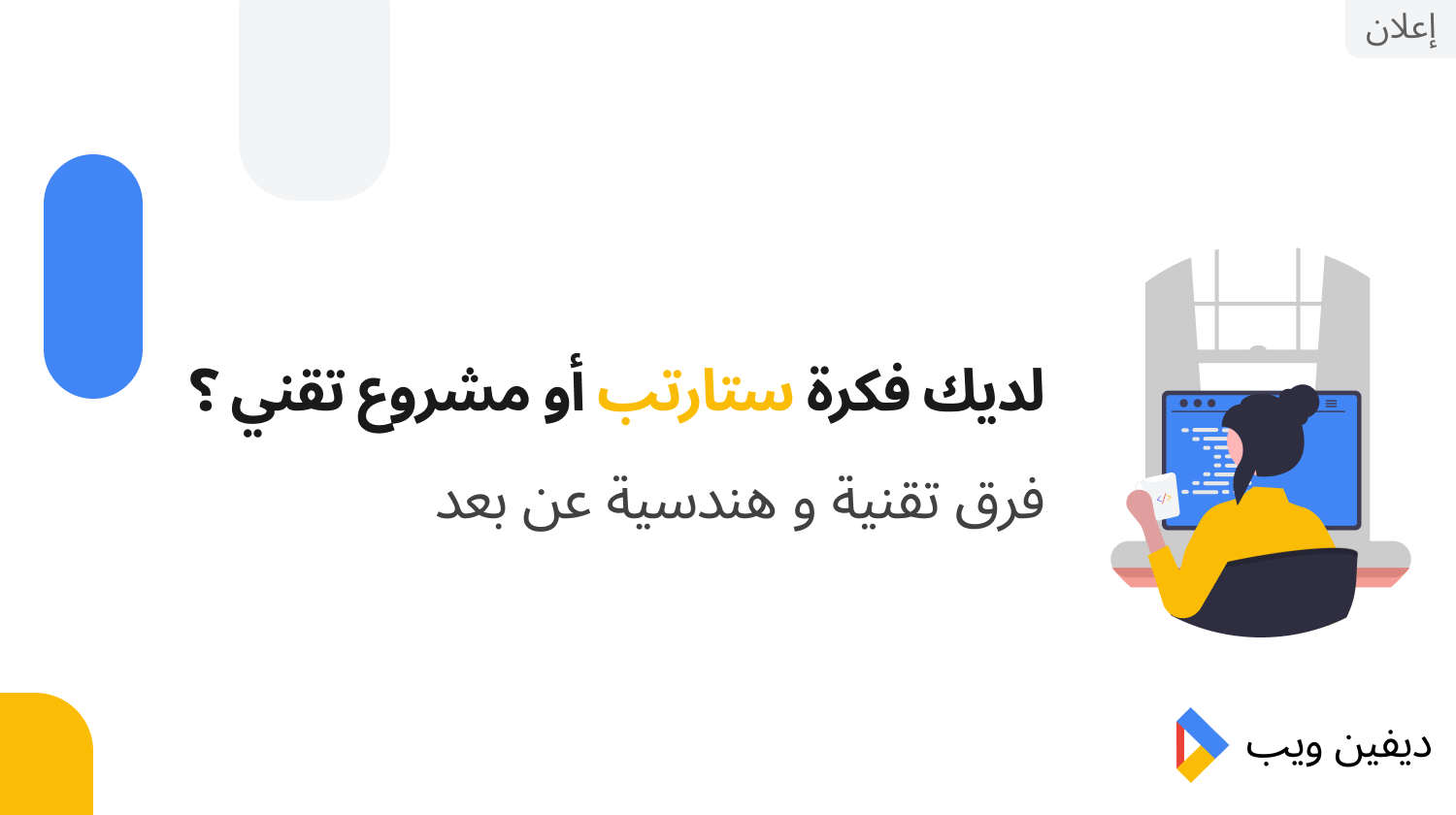فيه فار في الشقة!
بهذه العبارة الرومانسية صرخت زوجتي! فارتعدت فرائصي وجُنَّت ضربات قلبي وارتسم الرعب على وجهي.
كنا في الأشهر الأولى من عمر زواجنا، تلك الأشهر الحاسمة التي أعرف يقينًا أنها ترسم الصورة الذهنية لكل منا لدى الآخر، وتضع مسلَّمات وقواعد قد تستمر سنوات عديدة قبل أن تطالها يد التغيير. ومن ناحيتي لم أدخر جهدًا في الحقيقة في رسم صورتي كما أحب، فانطلقتُ بكل طاقتي أطلق نيران الرومانسية والفحولة والرجولة وخفة الظل بسبب وبدون سبب، وكنت أراني يومًا بعد يوم أقترب بثبات وثقة مما أريد.
المشكلة إني بقرف منها لدرجة الموت، وبقت دي الحاجة الوحيدة اللي بخاف منها.
بتلك العبارة الكاذبة رددت عليها. كانت العبارة كاذبة بفجاجة، فليست الفئران هي الشيء الوحيد الذي أخافه، بل وليست حتى أكثر تلك الأشياء، فأنا – حقيقة – أخاف من كل شيء!، غير أني لم أجد إلا تلك العبارة لحفظ ماء وجهي وإنقاذ رجولتي التي أصبحت على المحك.
"وبعدين ده بيجرى بسرعة والشقة كلها عفش، همسكه إزاى؟!"؛ هكذا أكملت محاولا الإدعاء بأن كل مشكلتى تكمن في عدم استطاعتى الإمساك بذلك الفأر تعيس الحظ الذى دخل بقدميه إلى عرين الأسد!
“فيه مصيدة تحت، إنزل هاتها ونحطها في المطبخ بالليل وأكيد هتمسكه“؛ أجابت زوجتى على تساؤلى – الكاذب – بحل عملى فعلًا، فأنا هنا لست مطالبا بمطاردته ولا مواجهته، فحمدت لها طوق النجاة هذا الذى ألقته إلي دون أن تدرى.
نزلت إلى “تحت” – حيث أمى وأبى –، سألت أمى عن المصيدة فأخرجتها لى، وسألتنى عن الفأر فقلت لها أننى لم أره، وأخذت منها المصيدة، وأنا أقاوم شعورا بالإشمئزاز من منظرها (المصيدة بالطبع وليست أمى)، وأمسكتها من قاعدتها الخشبية محاولًا عدم لمس هيكلها المعدني وأسلاكها الصدئة التى كانت صورة مجسمة للرعب والموت.
وصعدت بها إلى زوجتى التى أخذتها ووضتعها بحرص في المطبخ بعد أن علقت بداخلها ثمرة “طماطم” حمراء كبيرة لتغرى الفأر بلونها، ولم تكن تعلم - ولا أنا وقتها - أن الفأر لا يميز الألوان من الأساس!؛ وأكملنا باقي يومنا محاولين الإدعاء بأن كل شيء طبيعى، غير أن كلماتنا المتوترة وحواسنا المتشنجة المتربصة كانت تفضحنا بامتياز، حتى إذا ما جن الليل ذهبنا للنوم آملين أن تزول الغمة.
وبالفعل قبل أن تغمض أعيننا انتفضنا على صوت طرقعة قوية فقفزت زوجتى صائحة: “المصيدة! وقفزت معها ضربات قلبي فعجزت عن الكلام، خرجتُ خلفها بأرجل لا تكاد تحملنى إلى المطبخ وأشعلنا الانوار ورأيته. كان فأرًا منزليا متوسط الحجم، ويبدو أن المصيدة أغلقت عليه بمجرد دخوله إليها، فلم تكن ثمرة الطماطم قد مُسَّت بعد، وكان يحاول باستماتة دفع باب المصيدة، غير أنها كانت محكمة بالفعل ولله الحمد.
ظللت واقفًا – متجمدا في الحقيقة – أمامه لا أدرى ما أفعل، فقالت زوجتى: “إنت هتفضل واقف، يللا مَوِّتُه!”، فنظرت لها عاجزا متوسلًا وقلت: “إزاى؟!” ففكَرَت قليلا وقالت: “فيه تحت جردل كبير، إملاه ميَّه وغرَّقُه“، فقلت لها – محاولا الهروب قدر الإمكان – “زمانهم تحت ناموا دلوقتي، الصبح أبقى أغرَّقه“، وتركتها ورجعت إلى غرفة النوم آملًا أن أموت قبل الصباح، وكان هذا إيذانًا بانتهاء الحديث، ولا أدرى كيف غلبنى النوم فعلًا، ولكننى نمت!
استيقظت وأنا أحمل على كتفي همًا كبيرًا، ودخلت معها إلى المطبخ فوجدنا الفأر ساكنا في المصيدة ولكنه بدأ يتحرك حين رآنا، ولاحظنا أن ثمرة الطماطم قد اختفت تماما، فقالت زوجتى: “هو أكل الطماطم؟!” فقلت محاولًا إفراغ توترى وخوفى في دعابة مفتعلة: “ابن الكلب بينتقم مننا، قال: قبل ما أموت هخرب بيتكوا وآكل الطماطماية كلها“، وضحكنا بملئ فينا – من التوتر والانفعال – وكأن قنبلة ضحك قد انفجرت في وجوهنا، ثم بمنتهى الحرص والرعب حملت المصيدة من قاعدتها الخشبية ونزلت لأسفل حيث جردل المياه الكبير وقمت بإغراق الفأر. وليس هنا مجال ذكر تلك التفاصيل البشعة!
فى الأيام التى تلت تلك الواقعة لم يكن لنا حديث إلا عن الفأر، واستأنفت ماكينة التصنع والافتعال – بعد أن زال الخطر فعليًا – عملها على أكمل وجه، فانطلقَت منى النكات والدعابات عن الفأر “الطِفِس” الذى يأكل حتى آخر لحظة في حياته، وأحيانًا عن الفأر “المنتقم” الذى أراد “خراب بيتنا“، وهكذا تدريجيًا حتى ذهب الموضوع طي النسيان وتلته مواضيع أخرى وأخرى.
لا أدري لماذا تذكرت هذا الحادث الآن، وقد مضت عليه سنوات وسنوات، ولا أدري أيضًا لماذا صار السؤال يلح عليَّ بشدة: كيف قضى الفأر ليلته الأخيرة داخل المصيدة؟ ولماذا أكل الطماطم؟
قد يكون هذا بسبب النزعة الفلسفية التي أصبحت أميل إليها كنتيجة طبيعية للتقدم في العمر، وقد يكون بسبب تكاثر الأحداث والخطوب التى مرت عليَّ طوال تلك السنوات، ما أثقل كاهلي ودفعني دفعًا للهروب إلى ما قبلها، محاولًا التشبث بتلابيب الصبا ونضارة السنوات الأولى وبساطة الأحداث.
وبغض النظر عن السبب إلا أني أتساءل الآن حقًا، أيكون الفأر قد أكل الطماطم لإلحاق الضرر بنا بالفعل كما تمازحنا وقتها؟، أيملك تلك الشخصية المقاتلة التي تجعله حريصًا على إيلام قاتله وإلحاق الضرر به بكل ما أوتي من قوة، حتى اللحظة الأخيرة في حياته، وحتى عندما يوقن بالهلاك؟!، أيكون الفأر أفضل منا نحن المستسلمين لجلادينا اليائسين من الفعل المتخاذلين عنه؟
آلمني هذا الافتراض الذي يجعلني أقل من الفأر شكيمة وأضعف عزمًا، فنفضته عن رأسي سريعًا، وقلت: ومن قال إن الفأر أيقن بالهلاك؟، لم لا يكون قد امتلك الأمل في النجاة ولم يفارقه هذا الأمل لحظة واحدة حتى النهاية؟؛ لقد ظلَّ في المصيدة ليلة كاملة، فلم لا يكون قد حاول طوال تلك الليلة أن يفتح باب المصيدة ويتحرر؟. إن كان فكِّر هكذا ونفض اليأس عن نفسه فبالتأكيد سيحتاج إلى كل قوته وطاقته للمحاولة والعمل، وسيجد في ثمرة الطماطم وسيلة للحصول على تلك القوة.
أراحنى هذا الافتراض قليلا، غير أنى سرعان ما عدت أتساءل: أيكون الفأر قد أكل الطماطم ليتقوى على الكفاح من أجل حريته فعلا؟، أيكون مؤمنا أن عليه العمل بِجِدٍ وأنه محاسَبٌ على عمله وفقط، أما النتائج فلا يملكها ولا يملك إلا أن يسعى إليها؟ أيكون قد مات راضيًا عن نفسه؟ أيكون الفأر قد مات مؤمنًا أكثر منَّى؟
هالني ما أقوله وما يعنيه فعنفت نفسى بشدة وقلت: ومن قال أيضًا بأن الفأر هو ذاك المقاتل؟؟. بحثت في عمر الفئران فوجدت أعمارها حول العامين، وبمقارنة هذا بأعمارنا نحن البشر التى تدور حول الستين عامًا وجدت أن اليوم عندنا بثلاثين يومًا بالنسبة للفأر والليلة بثلاثين ليلة. أي أن الفأر قضى فعليًا داخل المصيدة ثلاثين ليلة بمقاييسه هو، فمن قال إنه قاتل ثلاثين ليلة؟
لم لا يكون الفأر قد قاتل ليلة أو ليلتين، تعب ليلة أو ليلتين، يئس ليلة أو ليلتين، ثم تعايش؟. لم لا يكون قد بلغ منه اليأس مداه فألِف المصيدة؟، لم لا يكون مع تتابع الليالى عليه قد نسى كيف دخل إليها ابتداءً؟، لم لا يكون قد تأقلم على أنها هى العالم، وأن حدودها هى الحقيقة؟. إن كان قد فكر هكذا فبالتأكيد سيفعل ما فعل بالضبط، وجد أمامه طعامًا فأكل، وقطعًا لو وجد أمامه شرابًا لشرب، ولو كانت معه فأرة داخل المصيدة لتناكحا وتناسلا، ولقضى باقى الليالى يعاشر فأرته، ويرعى صغاره، وينشغل بتوفير طعامهم وشرابهم!
ارتحت نسبيًا لهذا الافتراض الذى يحفظ عليَّ إيمانى ورجولتى ويلقى بالوضاعة على الفأر، غير أني سرعان ما تساءلت مرة أخرى: أنكون نحن هذا الفأر الأخير؟، أنكون قد دخلنا بأرجلنا إلى مصائدنا المختلفة جريًا وراء ثمرة الطماطم؟، أنكون قد طال علينا الأمد فنسينا أننا داخل مصيدة؟ أتتوالى علينا الليالى ونحن نفرح ونحزن، نرضى ونغضب، نتصالح ونتقاتل، نتباعد ونتقارب، دون أن ندرى أننا نعيش بالفعل ليلتنا الأخيرة في واقع سيدٍ خفىٍ خارج المصيدة، ينام الآن منتظرًا الصباح ليغرقنا، ويبدأ مع المصيدة ليلة جديدة؟
فما أفظع ما يثيره فينا التقدم في العمر، وما أعذب الصبا ببراءته وبساطته وجهله، ويا حظ من عاش صبيًا ومات صبيًا، والمجد كل المجد للبسطاء!
تم نشر هذا المقال بموقع ساسة بوست
التعليقات
لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... ! تابعنا على الفيسبوك
مقالات شيقة ننصح بقراءتها !
مقالات مرتبطة بنفس القسم




ما بين التثقيف والتصفيق فى الجمهورية الجديدة!
دائماً ما كانت «الأنظمة» تستخدم «المثقفين» للترويج لأعمالها ومشروعاتها(هذا إن افترضنا أن هذا النظام يمتلك مشروع بالفعل)، ولكن فى الماضي كانت هناك أنظمة «عاقلة» ومثقفين «موهبين» قادرين على الحفاظ على الحد الأدنى من «الاحترام» والمعقولية فى «الطرح» و فى مستوى