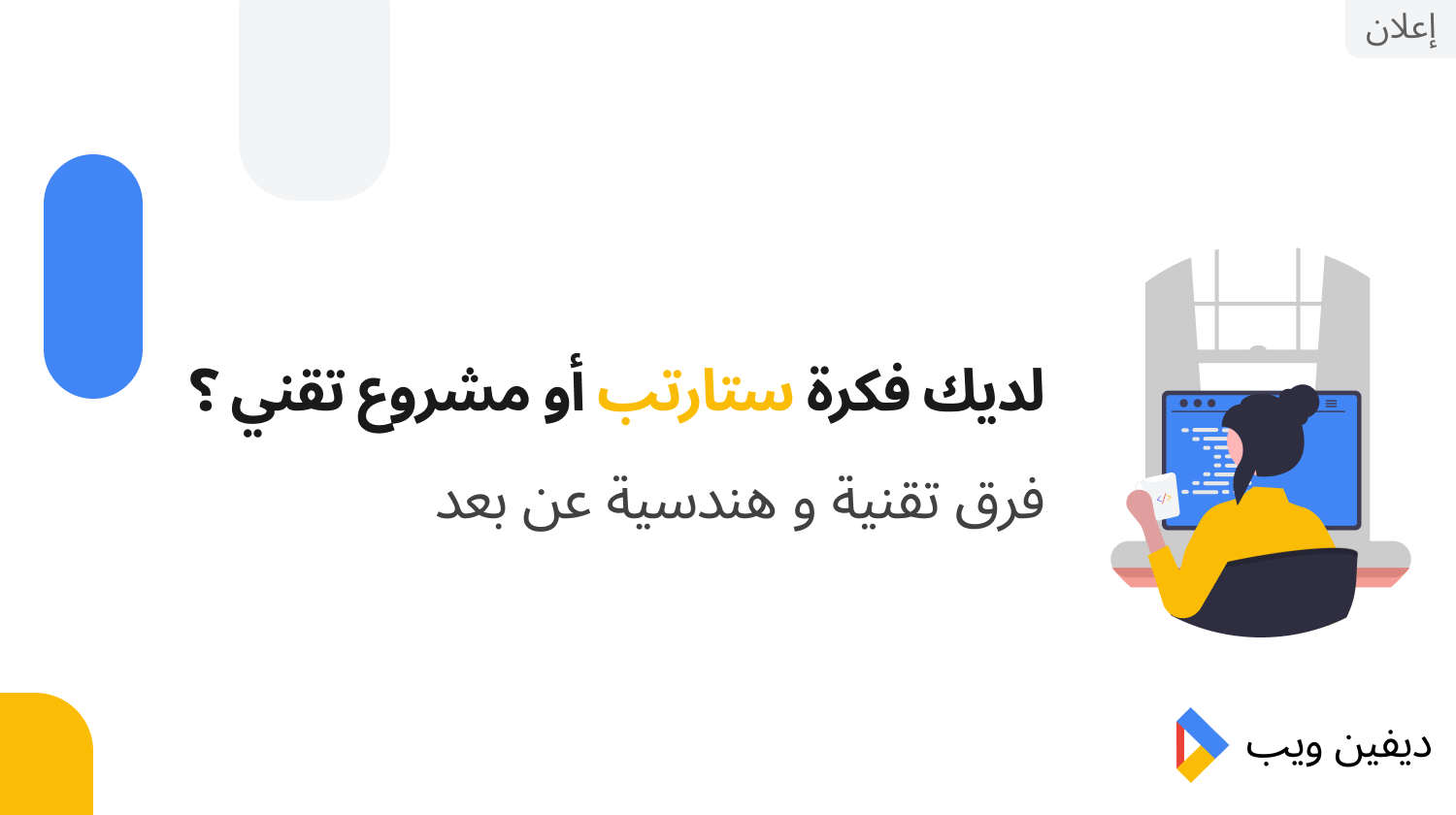داعش لم تحدث أي أثر على تفكير الإنسان العربي
نشر في 23 يناير 2018 وآخر تعديل بتاريخ 30 شتنبر 2022 .
دائما ما تجسد تغير المجتمعات و الأمم في التاريخ في أحداث دامية كانفجار العنف و الحروب الداخلية و الخارجية و النزاعات الإثنية و الثقافية ، مع ما يوازيها من دمار و خراب و أثر سلبي على الإنسان و الأخلاق و المجتمع ، و تحاشيا لعدم تكرار الكارثة يعمل من قاسوا مر مذيق و لهيب العنف على إحداث تغيير راديكالي لكل أفكارهم و عقائدهم و تصوراتهم عن أنفسهم و عن الآخر ، و ذلك ما يساعدهم على النهوض من جديد لا بالعقلية القديمة التي أنتجت الخراب بل بثقافة جديد تجعل من الأخوة و السلام أساس بناء المجتمع و الأخلاق ، و هو ما يعزز اللحمة الإنسانية بين البشر و يفتح أمام مجتمعاتهم إمكانيات التقدم و الإزدهار ، و لعل مثال بريطانيا و أمريكا وفرنسا بعد الثورة و ألمانيا و اليابان و النمسا بعد الحرب العالمية الثانية أوضح دليل على ذلك .
إن الواقع الإجتماعي لأي أمة يعد انعكاسا مباشرا للفكر الذي يحمله أفرادها ، فبما أن واقع الإنسان العربي خرب فهذا يعني أن أفكاره مُخَرِّبَة . و من ذلك سعت مختلف الأمم التي أدركت هذا المبدئ إلى إعادة مراجعة أفكارها على هدي النقد الراديكالي المؤسس على المنطق و الإنسانية و صلاحية الفكرة للواقع الذي ستتنزل فيه و الزمن الذي ستعيش فيه ، ذلك من أجل شفط الأفكار التي لا مقدرة لها على العيش في زمن غير زمن اختلاقها أو مكان غير مكان ظهورها ، من أجل دحر الأفكار الميكروبية التي تلوث ذهن الإنسان و تفخخ إرادته ، فأي فكرة أو أيديولوجيا تضم الإنسان إلى جماعة أو ثقافة معينة و توهمه بأن كل الخير يوجد في هذه الجماعة ، و بالمقابل تكفر باقي الجماعات و الثقافات و توهم أتباعها بأن كل الشر ينبع من هناك ، فهي فكرة ليست قمينة بالتبني و لا الإتباع ، بل تستحق الإدانة أولا و دفعها إلى الإنقراض ثانيا .
درس التاريخ يعلمنا بأن مثل هذا الحدث يحتاج إلى ثورة ، يحتاج إلى وعي مؤسس و ليس جهلا مقدسا ، بل الثاني هو ما يجب دحره بواسطة الأول ، يحتاج إلى زعامة فكرية و إرادة سياسية و شجاعة بطولية ، ما إن تتحقق هذه الشروط حتى تصبح أي شرارة صغيرة تنبعث من الجسم الإجتماعي تؤدي إلى انفجار بركان كبير يتجسد على شكل فعل اجتماعي عنوانه "الرفض" ، رفض المجتمع بثقافته و سياسته و قيمه البالية و معتقداته الدوغمائية و تصوراته الديماغوجية اتجاه نفسه و واقعه و الآخر المختلف عنه . إذ لا يتحصل مخيال الأفراد على هذه الإرادة إلا بعد أن يصل واقعهم الإجتماعي إلى نفق مسدود ، يصبح معه الحل كامنا في تفجير و طرح كل تاريخه و ثقافته و نظمه القيمية و السياسية ، و وضعها على طاولة المراجعة و النقاش ، ذلك ما يؤدي إلى إنتاج مجتمع جديد و ثقافة جديدة و فكر جديد ، و أهم شي "واقع جديد" ، غالبا ما ييسر سبل التقدم و الإزدهار في ايطار اجتماعي يتمتع بالسلام و هو شرط أي مبادرة للإرتقاء .
كم تمنى مجموعة من المفكرين العرب أن تتوفر هذه الشروط و يتحقق هذا الوعي كي تَقدم "كارثة عظمى" إلى الوطن العربي ، كارثة على ماضيه و حاضره و ليس على مستقبله . كي يصاب هذا العقل العروبي بصدمة كبرى تُحتم عليه إعادة مراجعة أفكاره و عقائده و دوغمائياته ، ثم يتحرر منها عبر إعادة صياغتها في قالب تنويري جديد ، هو أقرب لروح العصر الذي نعيش فيه منه إلى عصر البداوة و القرون الوسطى حيث تشكلت أهم إيمانيات و أصول ثقافة هذا العقل . فلا يخفى مدى الكوارث التي حدثت في التاريخ العربي من مذابح و ثورات و حروب ، غير أنها لم تحدث أي أثر على الفكر العربي خصوصا اللاهوتي منه ، حيث كلما ازداد مقدار العنف تراكمت زيادة فقهيات تبريره أو شرعنته ، هكذا ظهر مجرمي الأمويين و الخوارج و العباسيين و غيرهم ، دون أن يحدث ذلك أي أثر يذكر على العقل العربي يحمله على أن يدرك أن هذه الجماعات التي خربت الواقع يخلقها فكره و ثقافته و تصوراته ، ذلك ما يحتم مراجعة هذه الأفكار و هذه الثقافة المتحجرة و تعويضها بأخرى تنبذ العنف ضد الآخر و تدعه وشأنه على الأقل ، و بالمقابل تسوق لقيم السلام مع الكل دون تمييز.
يمكن أن نقول أن الربيع العربي شكل مناسبة لائقة لظهور هذا الحدث المنتظر "حدث التحرير" ، مناسبة لتغيير كل شيء ، غير أنه بقي حبيس تغيير رأس النظام السياسي فقط ، دون هدم النظام كله ومن أساسه ، فالثورة الحقيقية ليس هي من تنادي بإسقاط النظام بل بإسقاط العقلية و الثقافة و المجتمع الذي خلق النظام . أكثر من ذلك تجددت المناسبة مع ظهور تنظيم داعش الإرهابي الذي ولد شبابه في مجتمعاتنا و تربى تربية إسلامنا و صلى في مساجدنا و تعلم في مدارسنا و جامعاتنا و مشى في شوارعنا و حاراتنا ، ثم بعد ذلك تحول إلى آلة نحر مجنونة تكفر و تقتل كل مختلف عن الفهم و الثقافة و السياسة و الثراث الإسلاميين بمعناه القروسطي ، و مع ما مارسه هذا التنظيم من كوارث و مجازر باسم الدين و الشريعة الإلهية في حق المسلمين قبل غيرهم ، لم يحمل ذلك المسلمين بعد على فقط الإعتقاد بإمكانية أن يكون هذا التنظيم فعلا نتيجة طبيعية إلى ما يعتمل داخل هذه الرقعة الشاسعة المسمات العالم العربي و الإسلامي ، بكل ما يتكون منه من تاريخ و تراث و ثقافة و قيم و سياسات .
و هو الإمكان الذي قد يدفع هذه الأمة التائهة إلى فتح نقاش نقدي بينها و بين ذاتها ، بينها و بين ماضيها ، بينها و بين ثقافتها ، بينها و بين الآخر ، هو النقاش الذي قد يساهم في مراجعة أفكارها و تاريخها و عقائدها الدينية ، لكي نستوضح هل داعش تمارس الإسلام فعلا كما يدعي التنظيم أم لا ! إذ يُستبان لكل دارس للتاريخ مدى معقولية و صدق هذا الإدعاء ، الذي يصدم المدرك له و الواعي بحيثياته ، إذ أن داعش لم تسقط من السماء بل هي ثمرة فاسدة لبذرة أفسد ، هي مولود متوحش لأم أكثر توحشا ، هذه الأم و هذه البذرة هي "ثقافة المسلمين" و تاريخهم الفقهي و السياسي و الإجتماعي ، داعش لم تظهر سنة 2012 بل عمرها يتجاوز 14 قرنا و لازالت حية ، هذه هي الحقيقة التاريخية التي تصدم أي دارس للتاريخ الإسلامي المليء بالفضائع و المجازر و المذابح ، التي أحدثها المسلمون في بعضهم و في غيرهم.
لماذا نقول ذلك ؟ لأن داعش ليست جماعة إرهابية فقط ، بل هي فكر و ثقافة و نمط عيش ، لا يخطئ ملاحظته أو تلمسه من يعرف ثقافة المسلمين بشكل عام ، التي تعيش في كل الأقطار التي يعيش فيها هذا القوم ، مجال تواجد داعش ليس مقصورا على العراق و سوريا (في الماضي القريب) ، بل حيث ما وجدت الثقافة الإسلامية وجدت الداعشية .
و للتدليل على ذلك نقول: بأن القاعدة الفقهية التي تقول بأن كل العالمين كفرة إلا المسلمين ، أي أن 85% أو أكثر من البشرية كفار و سيدخلون مخلدين في جهنم، بالإضافة إلى القاعدة الفقهية التي تحصر الأخوة في من يشترك في الإيمان فقط ، أي أن المسلم الفيليبيني أخ للمسلم المصري رغم بعد المسافة الجغرافية بينهما ، غير أن القبطي في مصر ليس أخ لجاره المسلم لأنهما مختلفان في الدين و أن كليهما كافر في نظر الآخر و بالتالي يحرم ود أو مآخات بعضهما البعض . القاعدة الفقهية التي تبيح الهجوم و الإعتداء على غير المسلمين و فتح أراضيهم بالقوة ، إذ لا يزال المسلمين يؤمنون حتى اليوم بأنهم سيفتحون روما و باريس و واشنطن في آخر الزمان حتى يغلب و يسود الإسلام على باقي الأديان . هذه عينة صغيرة من الأفكار المدمرة التي يؤمن بها المسلمين و هي نفسها التي أنتجت داعش و غيرها من العصابات الإرهابية . لكن مع ذلك يلوك بسداجة هؤلاء البشر في هذا السقع المتخلف من أسقاع الأرض بأن داعش لا تمثل الإسلام رغم أن كليهما يصدران عن نفس الإيمان و العقيدة و الفكر . و هو ما يؤكد أن هناك مرض في هذه الأمة لا يسعنا كيف نشخصه .
فمع كل ممارسات داعش الموغلة في الحيوانية و التوحش التي شاهدها المسلمون و معهم العالم كله ، من تقطيع للأيدي و جز للرؤوس و جلد للظهور و حرق و رمي للجثث من الأعالي ، رغم كل هذا لا زال المسلمون يطالبون بتطبيق الشريعة و إحياء الخلافة و أسلمة الثقافة و الحياة ، أليست هذه علامة من علامات العته و الحمق الذي أصاب هذه الأمة ، إذ أن المطالبة بالشريعة تساوي تماما المطالبة بالدعشنة و الحيونة و التوحش.
معلوم لغير مرضى العقول أن مشروعية و صلاحية أي فكرة تأتي من نتيجتها العملية في الحياة ، إذا أتت بالصلاح فهي صالحة ، و إذا أتت بالطلاح فهي طالحة ،إذا أتت بالكارثة فهي كاسدة ما يستدعي تغييرها بفكرة أخرى أكثر إنسانية و صلاحا ، هذا المنطق يبدو أنه لا يشتغل في الوطن العروبي ، إذ أن فكر التكفير و الغزو و العنف دمر الوطن العربي على مدى أكثر من 14قرنا، و مع ذلك لم يفكر العرب بعد في تغييره ، و كأن بلاد العرب صحراء المتغيبين الذين لا يعقلون و لا يفكرون بل و لا يشعرون . إلى الآن لم يدركوا بعد أن هذا الفكر مدمر و يجب إصلاحه أو التخلي عنه ، إنه فكر يجعلنا في موقف ضد العالم كله ليس معنا فيه أي أحد .
بدل ذلك يدرسون هذا الفكر الأسود في مدارسهم و جامعاتهم و مساجدهم و يبسقونه على العالم بأسره عن طريق إعلامهم الديني و السياسي . و هو ما جعل باقي دول العالم تصدر لبعضها البعض السيارات مثلا أو الخضر أو وسائل التكنولوجيا ، و الوطن العربي يصدر للعالم الإرهابيين و الإنتحاريين ، يصدر من لا يُطمئن بجوارهم مخافة أن يفجروا أنفسهم و يمشي في سبيل إرهابهم الأبرياء . هكذا أصبح غيرنا يخترع وسائل الإستمرار و نحن نخترع وسائل العرقلة و الأزمة ، هكذا هم اخترعوا TOYOTA و SUMSUNG و MERCEDES ، و نحن اخترعنا "سيارة مفخخة" ، بحيث إن العالم يخترع وسائل الحياة و نحن نخترع وسائل الموت .
لا يخفى عن الباحثين و الدارسين أن الوطن العربي مقبل على أزمات أكثر مما هو غارق فيه الآن ، بسبب هذه الثقافة و هذه التربية و هذا الفكر و هذا التدين المعتوه ، الوطن العروبي أضحى كبحيرة تجف و هي مليئة بالسمك ، و هذا السمك يأكل بعضه بعضا ، لأن ماء الحياة قطع صبه في هذه المنطقة بسبب ثقافة تكفير الآخر ، الذي لن يأتي ماء الحياة إلا عن طريق التفاعل معه بشكل إنساني خلاق للتعاون و التعايش ، غير أن المسلمين لا يتعايشون مع بعضهم فما بالك مع غيرهم .
إن الإبقاء على ما يضر الإنسان و عدم التخلى عنه و تغييره ، يشي بأننا أمة في طور الإنقراض و الموات حيث لا مقدرة لنا على تغيير واقعنا رغم إتاحة غيرما فرصة لإحداث هذا التغيير ، إننا أمة تشبه ميتا هرب من قبره و لا يدرك أن غيره حي. فإذا كانت داعش بكل ممارستها المتوحشة لم تحملنا على تغيير فكرنا الديني الكارثي فأي شيء آخر عساه أن يدفعنا إلى سلك مسلك الإصلاح و التغيير ؟!
التعليقات
لطرح إستفساراتكم و إقتراحاتكم و متابعة الجديد ... ! تابعنا على الفيسبوك
مقالات شيقة ننصح بقراءتها !
مقالات مرتبطة بنفس القسم
وهن
الإسلام السياسي في القرن العشرين هو المسؤول الأول عن تذويب الإسلام في أيديولوجيات الحداثة من خلال التركيز على النقاط المشتركة مثل وعود الرخاء الاقتصادي وأحلام اليوتوبيا الاجتماعية. نتيجة لذلك، صار هناك تصوّر شائع مفاده أن عصر صدر الإسلام عصر

التجديد في الفكر الإسلامي
التجديد في الفكر الإسلاميمصطلح التجديد من المصطلحات الحديثة والتي ظهرت في الآونة الأخيرة، ويراها البعض بأنها من الضرورات



تمثال براتيسلافا
براتيسلافا مدينة بدولة سلوفاكية من زار هذه المدينة يجد هناك تمثالاً لعامل نظافة مصنوع داخل فتحة التصريف نصفه بالخارج والنصف الآخر بالداخل وله قصة عجيبة تعبر عن أسمى معاني الوفاء والمحبة هي قصة لرجل كان يعمل في النظافة وكان

نور الله ورحمته
يحل بنا شهر رمضان الكريم شهر القران والصيام والقيام والغفران والعتق من النيران.وشاء الله سبحانه الرحمن الرحيم أن يتم نعمه على عباده ويظل كتابه وكلامه ( القرآن) محفوظا بين البشر ولا يتم تحريفه أو إخفاؤه كما فعل بكتبه كالتوراة